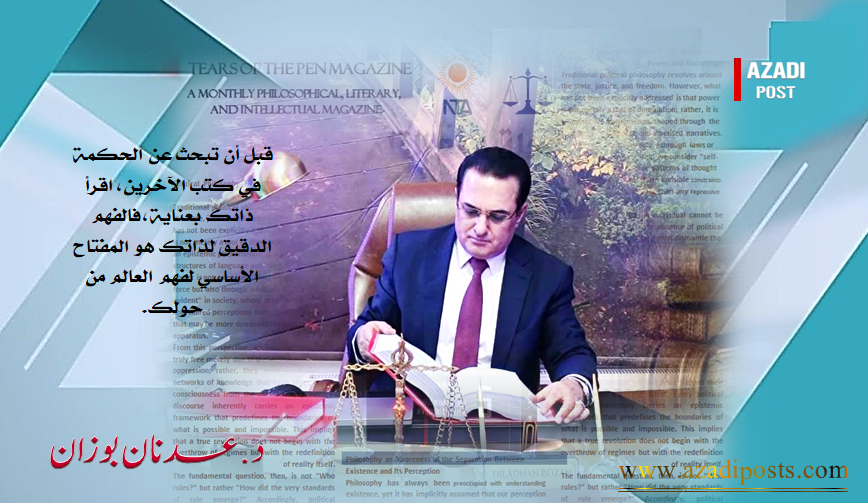 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
مقدمة:
في عالم السياسة، لا تحكم المصالح وحدها العلاقات الدولية، بل تتحكم بها كذلك الهيمنة الرمزية واحتكار "المشروعية" في تعريف العدو والصديق. ومن هنا تنشأ مفارقة صارخة: لماذا يُسمح للحكام العرب والدول الإسلامية بعقد اتفاقيات وتطبيع العلاقات مع "الدولة العبرية" (إسرائيل)، بل وتُبرَّر تلك العلاقات تحت مسمى "التكتيك السياسي" أو "الواقعية الاستراتيجية"، بينما يُتَّهم السياسي الكوردي الذي يسلك المسار ذاته بـ"الخيانة العظمى"، ويُنبذ اجتماعياً، بل يُجرَّد من وطنيته وقوميته؟
لماذا تصبح هذه العلاقة "حكمة سياسية" في القاهرة، و"خيانة قومية" في أربيل أو قامشلو؟ أليست هذه الازدواجية في التقييم مؤشراً على قصر النظر السياسي لدى بعض النخب الكوردية، وخضوعهم العاطفي لتصنيفات قومية ودينية فرضتها أنظمة الهيمنة المحيطة بهم؟
في عالمٍ تنهشهُ المصالحُ، وتُعيد تشكيلَهُ التحالفات المصلحيةُ لا المبادئ، تبدو السياسة الدولية أشبهَ بساحةِ مسرحٍ كُبرى، تتبدلُ فيها الأدوارُ حسبَ موقعِ الضوء لا حسبَ منطقِ العدالة. أمّا في الشرق الأوسط، فيتجاوز الأمرُ حدودَ البراغماتية السياسية أو تقاطع المصالح المؤقتة، ليصبح بناءً على سردياتٍ قسريةٍ تُعيد إنتاجَ الخيانةِ والبطولةِ وفقاً لهوى الأنظمة لا جوهر الأفعال.
ومن هنا تتكشفُ واحدةٌ من أكثر المفارقات فجاجةً في السياسة الإقليمية: الحكام العرب، والأنظمةُ الإسلاميةُ، ينخرطون في علاقاتٍ متعددةِ الأوجه مع "الدولة العبرية" (إسرائيل) — تفاهماتٌ أمنية، تحالفاتٌ سرية، تطبيعٌ اقتصادي، تعاونٌ استخباراتي — ومع ذلك لا يُسألُ أحدٌ عن "القضية الفلسطينية"، ولا يُتَّهمُ بالخيانة أو العمالة. بل تُسوَّقُ هذه السياسات في الإعلام الرسمي ودوائر النخبة بوصفها "قراراتٍ سياديةٍ رشيدة"، و"ضروراتٍ إقليمية"، و"واقعيةٍ استراتيجية" تُمليها موازينُ القوى.
ولكن ما إن يقدِمَ سياسيٌ كورديّ — مجردُ سياسيٍ لا نظام — على التواصل مع الطرف نفسه، حتى تقومَ الدنيا ولا تقعدُ: تتصدرُ عناوينُ التخوين صفحاتِ الصحف، تُشنُّ عليه حملاتُ الكراهية، ويُنبذُ داخلَ مجتمعه، بل قد يُهددُ وجوده السياسي وربما حياته. يُعلَّقُ على مِشنقةٍ أخلاقيةٍ باسم "القضية الفلسطينية" وباسم الدين، وباسم خيانة الوطن، في حين يبيعُ الجميعُ ذاتَ القضية في المزادِ الدولي.
فلماذا تُبرَّر خياناتُ الدول، وتُجرَّمُ محاولاتُ التواصل التي يقومُ بها الكوردي؟ لماذا تكون العلاقةُ مع إسرائيل "شراكةً استراتيجيةً" إذا أتت من العاصمة العربية، و"خيانةً تاريخيةً" إذا انطلقت من كوردستان؟
هل لأن الكوردي محرومٌ من امتلاكِ السردية؟ أم لأنه لا يملكُ إعلاماً قويّاً يُجمِّل قراراته؟ أم لأن الكوردي خُلقَ ليبقى في موقعِ الضحية، مطلوبٌ منه تقديمُ أخلاقٍ طاهرةٍ في عالمٍ قذر، وأن يثبتَ براءتَه السياسية في محكمةٍ لم يُدعَ إليها؟
ثم من قالَ إن الكوردي لا يَحقُّ له البحثُ عن أوراقِ تفاوضٍ أو علاقاتٍ دوليةٍ تضمنُ له البقاء؟ لماذا يُحَرَّمُ عليه ما يُحلَّلُ لغيره؟ أليس هذا الحظر المجتمعي والسياسي شكلاً من أشكالِ الاستعمار الرمزي، حيث لا يُسمحُ للكوردي بأن يَخطئَ أو يَصيبَ، بل فقط أن يظلّ مادةً للمساءلة وجسداً للخذلان؟
أخطرُ ما في هذه المفارقة ليس فقط الظلمُ السياسي، بل ما يكشفهُ عمقُ الهيمنة الذهنية التي تمارسها الأنظمة المحيطة، بل وحتى بعض القوى القومية، على العقل الجمعيّ الكوردي. الكوردي في لا وعيه السياسيّ ما زال أسيرَ مركزيةٍ عربيةٍ أو تركيةٍ أو إسلاميةٍ تحددُ له من هو عدوه، ومن هو حليفه، ومتى يكون نضاله مشروعاً، ومتى يتحولُ إلى خيانة. وهذا هو بيتُ الداء.
إن هذه الازدواجية لا تعكس فقط قصرَ نظرٍ سياسيٍّ لدى بعض النخب الكوردية، بل تشير إلى أخطرَ من ذلك: حالةٍ من الانتحار الاستراتيجي، حيث تُرفضُ الأدواتُ التي يمكنُ أن تفتحَ للكورد نافذةً في عالمٍ مغلق، باسمِ أخلاقياتٍ لم يلتزم بها أحدٌ. وهذا ليس نبلاً، بل سذاجةٌ قاتلة.
لقد آنَ الأوانُ لتفكيكِ هذا القيد النفسي والسياسي، وأن يُمنحَ الكوردي، كأيِّ شعبٍ آخر، حقهُ في أن يتصرّفَ كفاعلٍ لا كضحية، أن يَخطئَ ويُصحّحَ، أن يُجربَ خياراتهُ في السياسة كما في الثورة، دون أن يُطعنَ من الخلفِ بألسنةٍ لم تحارب إلا بالكلام.
أولاً: السياسة العربية والتطبيع... تكتيك أم خيانة مؤجلة؟
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، شهد النهج العربي الرسمي تجاه إسرائيل تحوّلاً تدريجياً من المواجهة إلى التفاوض، ومن التفاوض إلى التعاون العلني. تتابعت بعدها اتفاقيات أوسلو، وادي عربة، ثم جاءت "صفقة القرن"، وصولاً إلى موجة "التطبيع الإبراهيمي" في عهد إدارة ترامب، التي شملت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وأخيراً سوريا بقيادة رئيس الغفلة الإرهابي أبو محمد الجولاني.
كل ذلك جرى دون أن يُوصَف هؤلاء القادة بالخونة، بل جرت تغطية مواقفهم بخطاب المصلحة الوطنية، واعتُبرت خطواتهم محاولة لفتح نوافذ للسلام، أو لتحقيق التوازن في مواجهة التهديد الإيراني.
تُبنى المواقف الرسمية العربية على تبرير مصالح الأنظمة، حتى لو كانت هذه المصالح على حساب شعاراتها التاريخية، في حين يُحمَّل الكوردي ـ الذي لا يملك دولة ولا سيادة كاملة ـ عبء الالتزام بقيم لم تلتزم بها الأنظمة ذاتها. أي مفارقة أكثر قسوة من هذه؟
ثانياً: الكوردي بين مطرقة العاطفة وسندان الجغرافيا
على مدار التاريخ الحديث، ظلّ الكورد خارج "منصة القرار" في الشرق الأوسط، لكنهم داخل ساحة الحروب. لا يملكون دولة، ولا جيشاً مركزياً، ولا تمثيلاً سياسياً موحداً. ولهذا، فإن أي خطوة دبلوماسية أو انفتاح سياسي يقوم به الكوردي تُحاكم بمنظور مزدوج:
- من الأنظمة العربية: التي تُساءله عن "فلسطين"، رغم أنها باعتها عبر اتفاقيات وصفقات.
- من أنقرة وطهران: اللتين تعتبران أي تحرك كوردي خارج وصايتهما تهديداً لأمنهما القومي.
- ومن بعض الأوساط الكوردية ذاتها: التي تهيمن عليها العاطفة القومية أو الدينية، فترى في أي تقارب مع إسرائيل خيانة مطلقة، حتى لو كان في إطار تفاهم سياسي غير إلزامي.
النتيجة؟ يتحوّل الكوردي الذي لا يملك حتى منفذاً بحرياً إلى "خائن أممي" إذا ما اجتمع بمسؤول إسرائيلي، في الوقت الذي يقيم فيه الجميع علاقات دبلوماسية وتجارية وعسكرية مفتوحة مع تل أبيب!
أي منطق هذا؟ وأي عدالة في محاكمة الضحية على نواياها، بينما يُسامَح الجلاد على جرائمه الفعلية؟
ثالثاً: الكورد وإسرائيل... نحو فهم لا تبرير
العلاقة بين بعض القوى الكوردية وإسرائيل ليست طارئة، بل تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حين دعمت تل أبيب ثورة الملا مصطفى البارزاني في العراق، بدافع ضرب بغداد وليس بدافع الإيمان بحقوق الكورد.
لكن اليوم، هل من المرفوض مبدئياً أن يفتح الكوردي قناة حوار مع إسرائيل؟ أليست إسرائيل دولة فاعلة في النظام الدولي، بغض النظر عن موقفنا الأخلاقي والسياسي منها؟ ولماذا يُمنع الكوردي من الانفتاح على من ينفتح عليهم غيره؟ بل لماذا نُجرّمه على مجرد التفكير بأوراق ضغط وتحالفات خارجية، بينما نُشر عِن لغيره حق المناورة مع الجميع؟
السياسة فن إدارة المصالح، والكوردي المحاصر بأربع دول معادية لا يمكنه تجاهل الواقع الدولي، بل يحتاج إلى كل منفذ، ولو رمزيّاً، ليحفظ بقاءه ويدافع عن قضيته.
رابعاً: أسطورة "العميل الكوردي"... خطاب إسقاطي لأنظمة مأزومة
حين يُوصَم الكوردي بأنه "عميل لإسرائيل"، فإن ذلك غالباً ما يكون انعكاساً لأزمة داخلية لدى مَن يطلق هذا الاتهام. الأنظمة العربية والإسلامية ذاتها، كثيراً ما تعاملت مع الموساد، واحتضنت قواعد أجنبية، وسكتت عن الاحتلالات، لكنها تُحاول تغليف خياناتها الوطنية بإسقاط التهم على الحلقة الأضعف: الكوردي.
أما المفارقة المؤلمة، فهي أن الفلسطيني نفسه ـ الذي كثيراً ما يُدين الكورد على أي تواصل مع إسرائيل ـ يعلم جيداً أن غالبية الأنظمة العربية تخلت عنه، وأن بعض الفلسطينيين يتفاوضون اليوم مع الإسرائيلي أكثر من الكوردي ذاته!
فلماذا تُجرَّم محاولات الكوردي للتواصل الدولي؟ وهل أصبحت القضية الفلسطينية حكراً على قومية بعينها؟ أليست قضية عدالة وإنصاف لشعب مضطهد؟ وإذا كان كذلك، ألا يستحق الكوردي هو الآخر أن تُفهم قضيته في ضوء الظلم التاريخي الذي تعرض له؟
خامساً: من المظلومية إلى الواقعية السياسية
القضية الكوردية لا تُحَلّ بالشعارات وحدها، ولا بالعداوات المقدسة. الكورد بحاجة إلى خطاب سياسي عقلاني، وشبكة علاقات دولية متوازنة، بدل الارتهان لخطاب أنظمة تقمعهم وتُشيطنهم.
السياسي الكوردي الذي ينفتح على كل الدول، بما فيها إسرائيل، لا يُعدّ خائناً لمجرد جلوسه على طاولة تفاوض. ما يُدين الإنسان هو عمالته لا تواصله، وخيانته لا انفتاحه. ولسنا نرفض الحوار، بل نرفض التبعية والارتهان.
وإذا كانت العواصم العربية تستقبل مسؤولين إسرائيليين، وتوقع اتفاقيات أمنية واقتصادية، فلماذا يُحرَم الكوردي من هذا الحق؟ أليس في ذلك ظلم فادح وتناقض صارخ؟
خاتمة: إعادة تعريف الخيانة والحكمة
إذا أردنا التحرر من خطاب الاتهام، فعلينا أن نعيد تعريف مفهومي "الخيانة" و"الحكمة". لا يجوز أن نُطالِب الكوردي بالكمال الوطني بينما نُسامح أنظمة تُمارس الخيانة على رؤوس الأشهاد. الكوردي ليس ناقصاً في الوعي أو الإرادة، بل هو محاصر بجدران من الكراهية والمزايدات.
دعم أي سياسي كوردي ينفتح على إسرائيل لا يعني تبني الصهيونية، بل يعني كسر احتكار أنظمة الهيمنة الإقليمية التي تريد للكوردي أن يبقى رهيناً للنكبات.
وإذا كانت "الواقعية السياسية" فضيلةً عند الآخرين، فلماذا تكون "خيانة" إذا مارسها الكوردي؟
لقد آن الأوان لأن نخرج من عقلية الضحية الأبدية، وننتقل إلى الفعل السياسي الواعي، القادر على استثمار الفرص، وبناء مستقبلٍ لا يخضع للمحرَّمات المصطنعة، بل ينبع من فهم عميق للواقع وتحولات العالم.