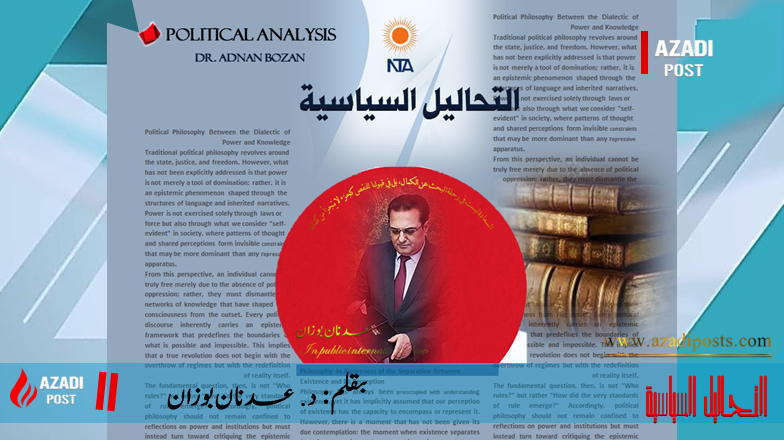 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
أولاً: السياق العام
منذ عام 2011، دخلت سوريا مرحلة انهيار بنيوي شامل لمؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الحرب التي اندلعت تحت شعار "الحرية" تحولت إلى صراع متعدد المستويات: داخلي، إقليمي، ودولي. واليوم، بعد أكثر من عقد، يمكن القول إن الدولة السورية كما عرفناها قبل 2011 قد انتهت عملياً، وإن ما تبقى هو "جغرافيا اسمية" تمزقها سلطات الأمر الواقع، وتتحكم بها قوى خارجية تتصارع على النفوذ والمصالح.
لم يعد الحديث عن تقسيم سوريا ضرباً من الخيال السياسي أو خطاباً دعائياً، بل بات خياراً مطروحاً وواقعاً يرسم على الأرض بخطوط النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي.
منذ سقوط نظام البعث في دمشق وفرار بشار الأسد إلى روسيا، دخلت سوريا مرحلة غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مرحلة تشبه – في كثيرٍ من ملامحها – “ما بعد الدولة”؛ حيث لم يعد ثمة مركز سياسي جامع أو مؤسسات قادرة على ضبط الجغرافيا أو إدارة المجتمع. كانت البلاد قد وصلت إلى أقصى درجات الإنهاك بعد أكثر من عقدٍ من الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية، فانهار كل ما تبقى من ركائز النظام القديم، ودخلت سوريا طوراً جديداً من الفوضى المقنعة بغطاءٍ سياسي هشّ.
في خضم هذا الفراغ، برز أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم “هيئة تحرير الشام”، كرئيس المؤقت للمرحلة انتقالية “مدعومة” بترتيبٍ دولي غريبٍ في توازنه ومصالحه.
فقد جاءت تسويته إلى الحكم – ولو شكلياً – نتيجة تفاهماتٍ غير معلنة بين موسكو وتل أبيب وبعض الدوائر الغربية، التي رأت فيه خياراً براغماتياً مؤقتاً يمكن من خلاله إدارة مرحلة ما بعد الأسد، وضبط إيقاع الفوضى داخل البلاد بما يخدم مصالح القوى الكبرى. وهكذا تحولت دمشق إلى مركزٍ رمزي لحكمٍ جديد، بلا سيادة حقيقية، تديره شبكات المصالح الاستخباراتية، وتتحكم به قوى المال والسلاح أكثر مما تحكمه المؤسسات والقوانين.
لكن ما بدأ كـ “مرحلة انتقالية” سرعان ما انقلب إلى حكمٍ فوضوي دموي، إذ تحولت سوريا تحت سلطة الجولاني إلى ما يشبه مزرعة مغلقة تتقاسمها الميليشيات، ويدار فيها البشر كما تدار الممتلكات.
ففي أقل من عام على توليه السلطة، بدأ انهيار أمني واسع، وتفكك الجهاز الإداري، وتحولت البلاد إلى فضاءٍ مفتوحٍ للنهب والاغتيالات والتهريب، بينما تصاعدت النزاعات الطائفية بأبشع صورها.
أخطر ما شهده هذا التحول كان الهجوم على الساحل السوري، حيث نفذت مجموعات المتطرفة التابعة للجولاني سلسلة من المجازر ضد الطائفة العلوية، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان البدايات الجهادية للحرب السورية.
جرى ذلك تحت شعارات “الثأر من الماضي” و“العدالة الإلهية”، لكنه في جوهره كان تعبيراً عن نزعة انتقامية مغلفة بخطابٍ ديني متطرف، وجد في غياب الدولة بيئة مثالية لتصفية الحسابات التاريخية.
ولم تمضِ أشهر حتى اتجهت المعارك نحو الجنوب، لتطال محافظة السويداء، حيث ارتكبت القوات ذاتها مجازر مروعة بحق المدنيين الدروز، في محاولة لتفكيك ما تبقى من بنية اجتماعية متماسكة، وتحويل الطوائف إلى جزرٍ خائفةٍ ومتحاربة. كانت تلك المجازر بمثابة الإعلان الصريح عن تحول سوريا إلى دولة إرهاب منظم، تتغذى على الكراهية والاقتلاع، وتدار وفق منطق الجهادية السياسية لا منطق الدولة الحديثة.
لم يكتفِ النظام الجولاني بذلك، بل بدأ في توجيه أنظاره إلى الشمال الشرقي، حيث مناطق الكورد والإدارة الذاتية، في محاولةٍ لفرض هيمنته هناك تحت ذريعة “توحيد البلاد” و“محاربة الانفصالية”، بينما كان الهدف الحقيقي هو توسيع دائرة النفوذ، واستكمال مشروع السيطرة عبر العنف العاري.
وبذلك دخلت سوريا مرحلةً جديدة أكثر دموية من الحرب نفسها؛ مرحلة المجازر الممنهجة التي تجاوزت منطق الصراع العسكري إلى منطق التطهير الجماعي.
لقد تحولت سوريا في ظل هذا النظام الهجين إلى دولة إرهابية بامتياز، لا بمعناها التقليدي الذي ارتبط بالجماعات المتشددة فحسب، بل ككيانٍ سياسي يقوم على الإرهاب ذاته كأداة حكم وضبط. أصبحت المؤسسات الأمنية، وميليشيات “الشرطة الإسلامية”، والمحاكم الميدانية، أدواتٍ للترهيب الجماعي، فيما غابت العدالة تماماً عن المشهد.
تدار البلاد الآن عبر اقتصادٍ أسودٍ يقوم على التهريب والابتزاز وبيع النفوذ، وتتحكم القوى الأجنبية بمفاصل القرار عبر واجهاتٍ سوريةٍ شكلية، بينما الشعب يعيش بين الخوف والجوع والنزوح.
وإذا كانت الحرب السورية الأولى قد قامت تحت شعار “إسقاط النظام”، فإن ما بعد الجولاني يمكن تسميته بـ “الحرب ضد المجتمع”، إذ لم يعد القتال بين معسكرين سياسيين، بل بين السلطة والمجتمع نفسه.
المجازر في الساحل والجنوب والشمال ليست سوى ملامح لمرحلةٍ تتآكل فيها فكرة “الوطن” لتستبدل بفكرة “السلطة المطلقة”، حيث تختزل الدولة في شخص الحاكم وجماعته، وتختزل العدالة في الانتقام، والمواطنة في الولاء الإجباري.
النتيجة هي أن سوريا اليوم – بعد سقوط البعث وصعود الجولاني – لم تعد دولة فاشلة فقط، بل كياناً مضاداً لفكرة الدولة، تهيمن عليه قوى ما دون الوطنية وما فوق الوطنية في آنٍ واحد.
بل يمكن القول إن ما تعيشه سوريا الآن هو ذروة الانحدار التاريخي: دولة بلا سيادة، سلطة بلا شرعية، ومجتمعٌ بلا أمان.
ثانياً: ملامح التقسيم الفعلي
- الساحل السوري: نحو كيان علوي مستقل
مع انهيار السلطة المركزية في دمشق وفرار بشار الأسد إلى روسيا، برز الساحل السوري – الممتد من اللاذقية إلى طرطوس – بوصفه المنطقة الأكثر تماسكاً من حيث البنية الاجتماعية والمذهبية، والأكثر ارتباطاً بالمشروع الروسي من حيث النفوذ العسكري والاقتصادي.
منذ التدخل الروسي في عام 2015، سعت موسكو إلى جعل هذه المنطقة مركز ثقلٍ استراتيجي دائم في شرق المتوسط، من خلال تثبيت وجودها العسكري في قاعدتَي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، وتطوير شبكةٍ من العلاقات المحلية مع النخب العلوية والاقتصادية التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق.
ومع سقوط دمشق وغياب السلطة المركزية، وجدت روسيا نفسها أمام ضرورة إعادة إنتاج نفوذها ضمن كيانٍ مستقر وقابلٍ للحماية، يضمن استمرار حضورها العسكري والبحري ويشكّل لها قاعدة انطلاق نحو الشرق الأوسط.
من هنا، بدأ العمل الروسي بصمتٍ على تهيئة الأرضية السياسية والإدارية لإقامة كيانٍ ساحلي شبه مستقل، يرتبط مباشرة بموسكو من خلال اتفاقات أمنية واقتصادية طويلة الأمد، ويعمل كـ"منطقة نفوذ روسية خاصة" داخل الجغرافيا السورية.
إن هذا الكيان العلوي المحتمل – الذي تطلق عليه بعض الأوساط السياسية اسم "سوريا المفيدة" – يمثل في جوهره امتداداً لمشروع روسي أوسع يسعى لتأمين موطئ قدمٍ دائم في شرق المتوسط، وضمان خطوط الإمداد العسكري والبحري، وتحقيق توازنٍ استراتيجي مع الوجود الغربي في المنطقة.
وبالنظر إلى طبيعة التكوين المذهبي في الساحل، حيث يشكل العلويون الكتلة السكانية الأكبر، فإن موسكو تراهن على استقرارٍ اجتماعي نسبي، يتيح تحويل المنطقة إلى نموذجٍ من “الاستقرار المحروس”، على غرار النماذج التي أنشأتها روسيا في القرم وأبخازيا ودونباس، ولكن بصيغةٍ سوريةٍ محلية.
وفي ظل الفوضى العارمة التي تسود باقي الجغرافيا السورية، يتوقع أن يتحول هذا الإقليم إلى نقطة الارتكاز الوحيدة لمصالح روسيا، وإلى مركزٍ بديلٍ عن الدولة السورية القديمة التي تفككت أركانها. كما أن هذا الكيان العلوي المحتمل قد يجد في نفسه حاجةً إلى بناء علاقاتٍ براغماتية مع إسرائيل من جهةٍ، ومع بعض القوى الغربية من جهةٍ أخرى، لضمان عدم تعرضه للعزلة أو للحصار السياسي، وهو ما يمنحه بعداً إقليمياً معقّداً يتجاوز المسألة المذهبية البحتة.
إن ظهور هذا الكيان – إن تم تثبيته فعلاً – لا يعني استقلالاً معلناً بالمعنى القانوني، بل استقلالاً فعلياً بحكم الأمر الواقع، ضمن مشروع تقسيمي أوسع يكرس نهاية الدولة السورية المركزية، ويحول الجغرافيا إلى مناطق نفوذٍ متباينة الهوية والولاء.
ولعل ما يميز الساحل السوري عن باقي المناطق هو أنه المنطقة الوحيدة التي تمتلك ظهيراً خارجياً قوياً وثابتاً (روسيا)، قادر على تأمين الحماية العسكرية والسياسية، وتوفير حدٍّ أدنى من الاستقرار الاقتصادي والإداري، ما يجعله مؤهلاً لأن يكون النواة الصلبة لأي مشروع "سوري مصغّر" قادم في المشهد الإقليمي.
- الجنوب السوري: منطقة نفوذ إسرائيلية
يشكل الجنوب السوري – الممتد من محافظات درعا والقنيطرة وصولاً إلى السويداء – أحد أكثر المناطق حساسية في معادلة ما بعد سقوط النظام، نظراً لاقترابه الجغرافي من الحدود مع فلسطين، وتقاطعه المباشر مع المصالح الأمنية الإسرائيلية.
فمنذ انهيار سلطة دمشق المركزية، يعيش الجنوب حالة من الفراغ الأمني والانفلات السياسي، إذ لم تعد العاصمة قادرة على بسط نفوذها أو ضبط توازنات القوى المحلية، في ظل تصاعد النشاط المسلح للفصائل، وعودة الولاءات العشائرية والطائفية إلى الواجهة.
في هذا السياق، دخلت إسرائيل على خط الأحداث، ليس بصفةٍ عسكريةٍ مباشرة، بل من خلال هندسة واقع أمني جديد يضمن لها عدم تمدد الميليشيات التابعة للسلطة الجولانية نحو حدود الجولان المحتل.
فمنذ وصول أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) إلى الحكم بدعمٍ روسي وغربي، وبدء حملاته الدموية ضد الطوائف والمكونات السورية، تعاملت تل أبيب مع المشهد السوري بمنطق “الوقاية الميدانية”، عبر إنشاء منطقة عازلة أمنية تستند إلى تحالفاتٍ محلية داخلية، خاصة مع المكون الدرزي في محافظة السويداء.
وقد تعزز هذا التوجه عقب الهجمات الوحشية التي نفذتها ميليشيات الجولاني ضد السويداء، وما رافقها من مجازر بحق المدنيين الدروز، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تكثيف دعمها غير المعلن للمنطقة، عبر قنواتٍ إنسانية وأمنية ولوجستية، تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الدفاع الذاتي، وإلى منع تمدد “سلطة الجهادية الجديدة” جنوباً.
وتشير تقارير عديدة إلى أن تل أبيب تعمل، بتنسيقٍ غير مباشر مع واشنطن، على بناء هيكل أمني محلي مستقل في الجنوب، يقوم على إدارةٍ ذاتية مدنية، مدعومة بقدراتٍ استخباراتية إسرائيلية، ومحمية بضماناتٍ أمريكية، لضمان استقرار الحدود ومنع أي اختراقٍ معادٍ.
من المرجح، وفق المعطيات الراهنة، أن تشهد المرحلة المقبلة إعلان كيان أمني محلي في الجنوب السوري، يكون بمثابة منطقة حكمٍ ذاتي غير معلنة، تحت وصاية إسرائيلية – أمريكية مزدوجة.
لن يعلن هذا الكيان استقلاله رسمياً، لكنه سيكون منفصلاً فعلياً عن سلطة دمشق، سواء في إدارة الأمن أو في العلاقات الخارجية أو حتى في توزيع الموارد، مع إبقاء قنواتٍ رمزية مفتوحة لتجنب الاعتراف الدولي المباشر بانفصاله.
إنّ هذا الواقع الجديد يجعل من الجنوب السوري منطقة نفوذ إسرائيلية بامتياز، تتحرك ضمن معادلة دقيقة:
إسرائيل تضمن أمن حدودها الشمالية، والولايات المتحدة تراقب المشهد لضمان التوازن مع النفوذ الروسي في الساحل، بينما تتولى القوى المحلية إدارة شؤونها اليومية في ظل غيابٍ كامل لأي سلطة مركزية سورية.
وبذلك، يتحول الجنوب من “خاصرة الدولة السورية” إلى نقطة تماسٍ دائمة بين مشروع الأمن الإسرائيلي ومشروع التفكك السوري، في مشهدٍ يجسد بوضوحٍ كيف انتقلت الجغرافيا السورية من “الانقسام السياسي” إلى “التقسيم الأمني المحكوم بالمصالح الخارجية”.
- شمال شرق سوريا: نحو كيان فيدرالي كردي مستقل
تمثل المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات – الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (روجآفا) – النموذج الأكثر وضوحاً لتجسد التقسيم الفعلي في الجغرافيا السورية.
فخلافاً للمناطق الأخرى التي تعيش اضطراباً أمنياً وانهياراً مؤسساتياً، استطاعت الإدارة الذاتية، منذ تأسيسها، بناء هيكلٍ سياسي وإداري متماسك يضم مجالس مدنية، وهيئات تنفيذية، وقوات نظامية منظمة متمثلة في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما منحها طابع “الدولة الناشئة” داخل الدولة السورية المنهارة.
تحظى هذه المنطقة بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى فيها ركيزة استراتيجية لسياساتها في الشرق الأوسط، خصوصاً في ما يتعلق بموازنة النفوذ الروسي والتركي معاً.
فمن الناحية الجيوسياسية، يشكل شرق الفرات المجال الحيوي الأمريكي الأهم داخل سوريا، حيث تتمركز قواعد عسكرية، ومستودعات نفط وغاز، وشبكات تعاون استخباراتي مع القوات المحلية، مما يجعل المنطقة عملياً تحت حماية غربية تضمن استمرار مؤسساتها واستقلالية قرارها الإداري والعسكري.
وفي ظل هذا الواقع، بدأت ملامح مشروعٍ فيدرالي أوسع تتشكل تدريجياً، يتجاوز الحدود السورية ليصب في إطار ما يعرف بـ “الاتحاد الفيدرالي الكوردي”، الذي يتوقع أن تتضح معالمه في أفق عام 2030، وفقاً لتوجهات الحركات الكوردية الإقليمية.
وينظر إلى منطقة روجآفا بوصفها الركيزة الجغرافية والسياسية الأساسية لهذا الاتحاد المرتقب، إلى جانب إقليم كوردستان العراق، مع إمكانية التمدد الرمزي أو السياسي إلى المناطق الكوردية في تركيا وإيران، في حال توفرت الظروف الإقليمية الملائمة.
تشير المعطيات الميدانية والسياسية الراهنة إلى أن إعلان شكلٍ من أشكال الفيدرالية الرسمية أو الاستقلال الإداري الموسع في شمال وشرق سوريا بات مسألة وقت، ومن المرجح أن يتم خلال العامين القادمين، في إطار تسويةٍ تفاوضية تحفظ التوازن مع واشنطن من جهة، ومع بقايا السلطة في دمشق من جهة أخرى، لتجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة.
وفي المقابل، يبدو أن الإدارة الذاتية تسعى إلى إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع العاصمة، لتأمين اعترافٍ سياسي تدريجي بواقعها الجديد، ولتجنب أي عزلة دولية محتملة، مع الحرص على التأكيد بأن مشروعها فيدرالي لا انفصالي، وأنه يستند إلى مبدأ “وحدة سوريا الديمقراطية” بصيغةٍ جديدة تتجاوز مركزية الدولة القديمة.
هكذا، يتبلور في شرق الفرات كيان سياسي في طور الترسيم النهائي، يمتلك مؤسساتٍ واضحة، وسلطةً تنفيذيةً مستقرة، وتحالفاتٍ خارجيةً متينة، ما يجعله اليوم أقرب إلى نموذج الدولة الفعلية منه إلى سلطةٍ محلية مؤقتة.
ومع استمرار الدعم الأمريكي واستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، يبدو أن الفيدرالية الكوردية السورية أصبحت أحد الثوابت الجيوسياسية الجديدة في مشهد ما بعد البعث، وجزءاً لا يتجزأ من التحولات الإقليمية العميقة التي تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط على أسسٍ قوميةٍ وديمقراطيةٍ في آنٍ واحد.
- دمشق ومناطق الوسط: الدولة الأموية المنهكة
دمشق اليوم لم تعد عاصمة دولة موحدة، بل تحولت إلى مركز رمزي لسلطة متهالكة، تحكم مناطق محدودة في الوسط السوري، وسط حصار اقتصادي وسياسي خانق. النظام الجديد في دمشق يعتمد بشكل واضح على الدعم التركي والسعودي وبعض الدول الخليجية التي ترى فيه حاجزاً مؤقتاً أمام تمدد الفوضى، أكثر مما تراه سلطةً شرعية.
لكن ما يهدد هذه البنية الهشة ليس فقط الانهيار الاقتصادي أو عزلة العاصمة، بل التناقض المتصاعد داخل البيت السني نفسه، بين الفصائل الإسلامية المتناحرة — من هيئة تحرير الشام في الشمال، إلى فصائل الجنوب، وصولاً إلى بقايا ما يعرف بالجيش الوطني التابعة لتركيا. هذا التناقض، الذي تغذيه التنافسات الإقليمية والدعم الخارجي المتضارب، ينذر بحرب داخلية قادمة بين القوى الإسلامية ذاتها على من سيملأ فراغ السلطة في دمشق.
أما شخصية أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، التي صعدت إلى الواجهة كرئيس مؤقت لما يسمى "الدولة الدمشقية"، فتجسد مفارقة المرحلة: رجل جاء من رحم التنظيمات الجهادية، يحاول أن يرتدي ثوب السياسي المدني، لكنه في الواقع يمثل انتقال الصراع السوري من مرحلة الثورة ضد النظام إلى صراع بين المكونات الشعب السوري وقوى الإسلام السياسي نفسها.
إن استمرار التدهور الاقتصادي وتآكل السلطة المركزية سيقود في النهاية إلى تفكك البنية السنية السياسية، ودخول دمشق في صراعات مفتوحة بين التيارات المتشددة والمعتدلة، إلى أن تفرض موازين القوى واقعاً جديداً، ربما يكون نواة لسلطة أمرٍ واقعٍ لا تشبه لا الدولة القديمة ولا الثورة التي أسقطتها.
ثالثاً: الترابط الإقليمي – تركيا والعراق
- تركيا: من الأزمة الاقتصادية إلى الانقسام السياسي
تواجه تركيا اليوم واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ تأسيس جمهوريتها الحديثة. الأزمة الاقتصادية المتفاقمة — المتمثلة في التضخم المفرط، انهيار العملة، ارتفاع الديون الخارجية، وتآكل الثقة بالسياسات النقدية — باتت تهدد الاستقرار الداخلي وتضعف قاعدة السلطة الحاكمة.
سياسياً، يزداد التوتر بين الحكومة والمعارضة، في ظل حالة من الاستقطاب المجتمعي العميق بين التيارات القومية والإسلامية والعلمانية، مما يخلق بيئة قابلة للانفجار في أي لحظة. ومع تصاعد الاحتقان الشعبي وتراجع القدرة الشرائية، تتزايد المخاوف من اضطرابات اجتماعية واسعة قد تعصف بالتماسك الداخلي للدولة التركية.
في حال استمرار الأزمة وتعمقها، قد تشهد تركيا تحولات جذرية في بنيتها السياسية، أو حتى انقسامات فعلية بين المركز والولايات ذات الخصوصية القومية أو الدينية — وعلى رأسها مناطق الجنوب الشرقي ذات الغالبية الكوردية — حيث تنمو النزعات الفيدرالية أو الانفصالية تدريجياً تحت ضغط الأزمات المتراكمة.
أي انهيار اقتصادي أو سياسي كبير في تركيا لن يبقى محصوراً داخل حدودها، بل سينعكس مباشرة على المشهد السوري، ولا سيما في المناطق الخاضعة لنفوذها شمال البلاد: إدلب، عفرين، وجرابلس، وتل أبيض ورأس العين. ففي حال اهتزاز السلطة في أنقرة أو تبدل أولوياتها، قد ترفع الحماية التركية عن هذه المناطق، مما يفتح الباب أمام إعادة رسم الخارطة العسكرية والسياسية في شمال سوريا خلال فترة وجيزة.
- العراق: بين الانفجار الطائفي والاستقلال الكوردي
يشكل العراق اليوم الحلقة الثانية في معادلة التفكك الإقليمي التي تعصف بالمنطقة. فالدولة العراقية، رغم مظهرها المؤسسي، تعاني هشاشة بنيوية عميقة تتجلى في الانقسام الطائفي والسياسي وتضارب مراكز القرار بين بغداد والنجف وطهران. ومع تفاقم الفساد وتراجع الثقة الشعبية، يتآكل النظام السياسي الذي أُقيم بعد عام 2003، ويفقد قدرته على إدارة التوازن بين مكوناته المذهبية والقومية.
في المقابل، يبرز إقليم كوردستان العراق ككيان شبه مستقل يمتلك كل مقومات الدولة الحديثة: برلمان منتخب، حكومة تنفيذية، قوات نظامية (البيشمركة)، وسياسات خارجية مستقلة نسبياً عن بغداد. ومع استمرار الخلافات حول النفط والميزانية والحدود الإدارية، يتعزز الاتجاه داخل أربيل نحو الاستقلال الكامل كخيار سياسي واقعي، لا سيما إذا تزامن ذلك مع اضطرابات في بغداد أو انهيار أمني جديد على خلفية الصراع الشيعي – الشيعي داخل المركز.
إعلان استقلال كوردستان العراق، متى ما حدث، لن يكون حدثاً محلياً فحسب، بل نقطة تحول إقليمية كبرى. إذ سيشكل حافزاً مباشراً لولادة كيان كوردي رسمي في شمال وشرق سوريا، تمهيداً لمرحلة التكامل الكونفدرالي بين الكيانات الكوردية في كل من العراق وسوريا وربما أجزاء من تركيا وإيران، ضمن إطار مشروع "كوردستان الكبرى الفيدرالية" المتوقع تبلوره بحلول عام 2030.
الخلاصة:
تتجه سوريا اليوم نحو مرحلة إعادة رسم الخرائط، لا إعادة الإعمار. فالتقسيم لم يعد مجرد احتمال نظري أو طرحاً سياسياً عابراً، بل بات مساراً متدرجاً تكرسه الحقائق الجغرافية والعسكرية والسياسية التي تشكلت على الأرض خلال أكثر من عقد من الصراع.
القوى الدولية والإقليمية الفاعلة — من روسيا والولايات المتحدة إلى إسرائيل وتركيا — تسابق الزمن لتثبيت موطئ قدم دائم في "سوريا ما بعد الأسد"، عبر وكلاء محليين أو ترتيبات ميدانية تضمن استمرار نفوذها ضمن الجغرافيا الجديدة. لكن ما بعد التقسيم لن يعني الاستقرار، بل سيشكل مرحلة أكثر تعقيداً من الصراعات الهوياتية، حيث ستسعى كل جماعة مذهبية أو قومية إلى تأسيس كيانها السياسي الخاص، في مشهد يشبه تفكك المشرق إلى دويلات أمر واقع.
إننا نقف على أعتاب نهاية الدولة السورية الكلاسيكية التي تأسست بعد الاستقلال، وبداية شرق أوسط جديد ترسم حدوده وفق ميزان القوى والمصالح الدولية، لا وفق خرائط التاريخ أو الهويات الوطنية.
وستكون السنوات الخمس القادمة (2025–2030) حاسمة في تحديد ملامح هذا التحول الجيوسياسي العميق: شكل الكيانات الجديدة، طبيعة التحالفات، واتجاهات إعادة تعريف الدولة والهوية في المشرق العربي بأسره.