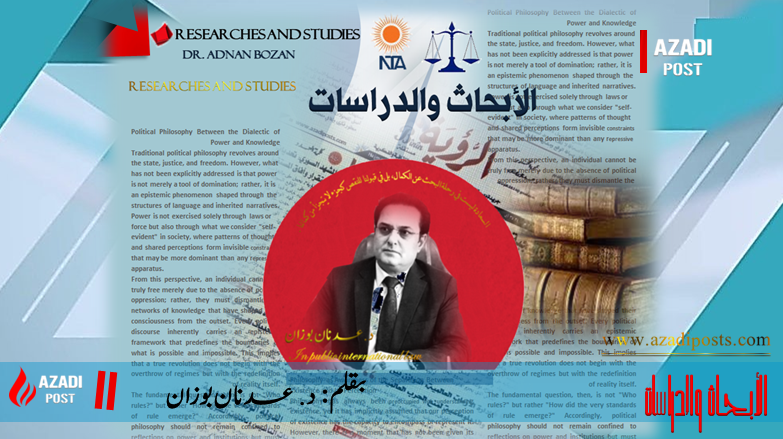 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
مقدمة:
حين نتأمل التاريخ الفكري للقرن العشرين، نرى أمامنا صراعاً ليس فقط بين أيديولوجيات سياسية، بل بين تصورين وجوديين للإنسان: تصورٌ يرى في الإنسان كائناً تاريخياً يحمل في ذاته القدرة على تغيير العالم وفق مبادئه، وتصورٌ آخر يراه كائناً تجريبياً، لا يبحث عن الحقيقة المطلقة بل عن المنفعة الواقعية. في الأول ولدت البلشفية، وفي الثاني نمت البراغماتية. وليس الصراع بينهما مجرد خلافٍ في النظر إلى المجتمع، بل نزاعٌ على معنى الحقيقة، وعلى طبيعة الإنسان نفسه: أهو ابن المبدأ أم ابن النفع؟ أهو يسعى لتأسيس العالم على العدل، أم لترويض العالم بما يضمن له الاستمرار؟
إن البلشفية، حين انبثقت من رحم الثورة الروسية، لم تكن فقط نظرية في الاقتصاد والسياسة، بل كانت نداءً فلسفياً موجهاً إلى جوهر الإنسان نفسه؛ إنها رفضٌ للواقع كما هو، وتمردٌ على التاريخ حين يكون أداةً للظلم، وإيمانٌ بأن العدالة ليست حلماً بل حقٌّ ينتزع بالدم والإرادة. البلشفي لم يكن في جوهره جندياً للحزب، بل كائناً يؤمن بأن المبدأ أسمى من المصلحة، وأن الإنسان لا يقاس بما يملك بل بما يقدم من تضحية في سبيل ما يراه عدلاً. ومن هنا كانت البلشفية صوتاً عالياً للضمير التاريخي، وصرخةً ضد النفعية التي حولت الإنسان إلى ترسٍ في آلة الإنتاج.
أما البراغماتية، فهي ابنة التجربة الأميركية الحديثة، ولدت من رحم واقعٍ متغيرٍ لا يعترف بالمطلقات، ومن عقلٍ رأى أن الفكرة لا تقاس بصحتها النظرية بل بنتائجها العملية. البراغماتي لا يسأل: "هل هذا حقٌّ في ذاته؟" بل يسأل: "هل هذا نافع؟"؛ لأنه يرى أن الحقيقة ليست جوهراً ثابتاً في السماء، بل فعلاً يتشكل في الأرض، وأن الفكرة التي لا تثمر منفعة ليست سوى لغوٍ ذهني. فالإنسان، في نظر البراغماتية، ليس كائناً مثالياً يبحث عن الكمال، بل كائن عملي يسعى إلى النجاح في عالمٍ متقلب. ومن هنا، فإن البراغماتية تمثل نزعة الإنسان إلى البقاء، ورفضه للجمود، وقدرته على التكيّف مع التحول الدائم للواقع.
لكن ما يجعل الصراع بين البلشفية والبراغماتية عميقاً ليس في اختلاف المبدأ والمنهج فقط، بل في الرؤية الوجودية للإنسان. فبينما تؤمن البلشفية أن الإنسان كائنٌ يكتمل فعله حين يثور ضد الظلم ويغيّر التاريخ بإرادته، ترى البراغماتية أن الإنسان يكتمل حين يعرف كيف يتصالح مع شروط وجوده ويحولها إلى فرص. الأولى ترى الوجود ساحة نضال، والثانية تراه مختبراً للتجربة. الأولى تنظر إلى الحقيقة كغاية تنال بالتضحية، والثانية تراها كأداة تستخدم للتقدم. وكأن البلشفية تمثل الضمير الأخلاقي للإنسان، بينما البراغماتية تمثل وعيه العملي.
ومن بين هذين الحدين المتناقضين، يقف الإنسان المعاصر حائراً: هل ينتمي إلى الحلم أم إلى الواقع؟ إلى الثورة أم إلى الإصلاح؟ إلى المبدأ أم إلى المنفعة؟ لقد أصبحت المسافة بين البلشفية والبراغماتية هي المسافة ذاتها بين الإنسان كما يجب أن يكون والإنسان كما هو الآن. بل إنّ التاريخ نفسه، بكل صراعاته وحروبه وتحولاته، يمكن قراءته على أنه مسرح لهذا الجدل الأبدي بين الحالمين بالمطلق والمكتفين بالنتيجة.
ولذلك فإن هذا البحث لا يسعى إلى إدانة أحد الطرفين، بل إلى تفكيك المعنى الفلسفي للصراع بينهما: هل المبدأ في جوهره نفيٌ للمنفعة؟ وهل المنفعة نفيٌ للمبدأ؟ أم أن الإنسان في عمق وجوده يحتاج إلى كليهما كي يكتمل؟ إن هذا البحث هو رحلة في أعماق الفكر الإنساني، بحثٌ في كيفية تشكل الوعي بين المثال والواقع، بين الثورة والبرهان، بين الإنسان الذي يحلم بعالمٍ أكثر عدلاً، والإنسان الذي يرضى بعالمٍ أكثر واقعية.
هكذا نبدأ من السؤال الذي يبدو بسيطاً لكنه يحمل ثقل التاريخ:
حين يختار الإنسان بين المبدأ والمنفعة، أيّهما ينقذ إنسانيته وأيهما يدمرها؟
إذاً الفرق بين البلشفية والبراغماتية
الفرق بين البلشفية والبراغماتية ليس مجرد اختلافٍ في المناهج السياسية أو المدارس الفكرية، بل هو اختلاف أنطولوجي عميق في نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الوجود، فكلتاهما تمثلان طرفين متقابلين من روحٍ واحدة هي روح السؤال الإنساني الأبدي: ما الحقيقة؟ وما الغاية من الفكر والفعل؟ أهي الغاية في ذاتها أم النفع الذي تحققه؟ في البلشفية يولد الفكر من رحم المبدأ، وفي البراغماتية يولد المبدأ من رحم النفع، الأولى تؤمن بأن العالم لا يتبدل إلا إذا تغير جوهر العلاقات التي تحكمه، والثانية تؤمن بأن العالم لا يفهم إلا من خلال التجربة المتغيرة، وبينهما يقف الإنسان ممزقاً بين التزامه الأخلاقي بما يجب أن يكون، واستسلامه الواقعي لما هو كائن. البلشفية ابنة الثورة، تؤمن أن الإنسان كائنٌ تاريخيٌّ محكومٌ بالصراع بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وأن وعيه ليس معزولاً عن شروط وجوده المادي، فالحقيقة عندها ليست رأياً ولا احتمالاً بل انعكاسٌ موضوعيٌّ للواقع كما هو، واقعٌ يمكن فهمه وتغييره عبر العلم والعمل الثوري، ومن هنا نشأ اليقين البلشفي بأن العدالة ليست فكرةً أخلاقية فحسب، بل ضرورةٌ نابعة من حتمية التطور التاريخي، وأن التناقض بين المستغِل والمستغَل هو جوهر الوجود الاجتماعي، وأن الثورة هي لحظة الوعي الأعلى بالتاريخ، فيها ينتصر العقل الجمعي على الاستلاب، وتتحقق إنسانية الإنسان عبر تحريره من الاستغلال، فالبلشفي لا يرى في الفكر وسيلةً للمنفعة بل يرى فيه نداءً للتضحية، ولا ينظر إلى الإنسان بوصفه كائناً تجريبياً متأقلماً بل بوصفه فاعلاً تاريخياً يحمل في وعيه إمكانية تغيير مسار العالم، إنه كائن يعيش للمبدأ حتى لو جاع، ويؤمن بالحقيقة حتى لو خسر حياته، إنه لا يسعى إلى النجاح بل إلى الصواب، لأن النجاح في عالمٍ ظالم لا يعني شيئاً إذا لم يكن قائماً على العدالة، ولذلك فالفعل في البلشفية هو التزامٌ أخلاقي قبل أن يكون وسيلةً عملية، إنه تجسيدٌ للوعي الثوري الذي يرى أن التاريخ يسير وفق قانونٍ لا يمكن كسره، قانون الصراع الطبقي، ومنه تنبثق ضرورة التغيير، لا كخيارٍ بل كقدرٍ لا مفر منه. أما البراغماتية فهي النقيض الكامل لهذه الرؤية، إذ تنظر إلى الفكر بوصفه أداةً للتجربة لا سلاحاً للتغيير، فهي لا تؤمن بالمطلقات ولا بالحتميات، بل ترى أن الحقيقة ليست ما يتطابق مع الواقع المادي بل ما ينجح في الواقع العملي، إنها فلسفة التجربة والمنفعة والمرونة، فلسفة تقول إن الفكر لا قيمة له إذا لم ينتج نتيجة، وإن الإنسان لا يعرف بموقعه الطبقي ولا بتاريخه، بل بقدرته على الفعل الناجح في الحاضر، فالحقيقة في نظر البراغماتي هي عملية لا تنتهي، تتغير مع الظروف وتتبدل مع الحاجات، وما كان صحيحاً بالأمس قد يكون باطلاً اليوم إذا تغير نفعه، إنها فلسفة الإنسان التجريبي الذي لا يبحث عن الخلاص في الثورة بل في التكيّف، والذي لا يسأل: ما الذي يجب أن يكون؟ بل يسأل: ما الذي ينفع الآن؟ إنها فلسفة الفرد لا الجماعة، والنجاح لا العدالة، والتجربة لا التاريخ، ولذلك فهي تمثل الوجه العقلي للعالم الرأسمالي الحديث، حيث المقياس هو النتيجة، وحيث القيم تقاس بما تحققه من فائدة لا بما تمثله من حقّ. البلشفية تنتمي إلى روح المبدأ، بينما البراغماتية تنتمي إلى روح المنفعة، الأولى ترى أن الفعل ينبغي أن يكون انعكاساً لوعيٍ تاريخيٍّ متجاوز، والثانية ترى أن الفعل لا معنى له إلا في حدود أثره الآني، الأولى ترى أن الإنسان يصنع التاريخ، والثانية ترى أن الإنسان يصنع تجربته، الأولى تؤمن أن الحقيقة تُكتشف، والثانية تؤمن أن الحقيقة تخترع، الأولى تنشد التحرر من شروط الوجود المادي، والثانية تنشد تحسين تلك الشروط دون كسرها، الأولى تقول بالثورة كوسيلة للخلاص، والثانية تقول بالإصلاح كتجربةٍ تراكميةٍ غير نهائية، الأولى ترفع المبدأ فوق المنفعة حتى لو خسر الإنسان كل شيء، والثانية ترفع المنفعة فوق المبدأ حتى لو فقدت الحقيقة معناها. من الناحية الفلسفية العميقة، البلشفية هي موقفٌ وجوديٌّ من العالم يرى أن جوهر الإنسان يكمن في قدرته على تجاوز الضرورة التاريخية، وأن الحرية لا تتحقق بالتكيّف مع الواقع بل بخلخلته، بينما البراغماتية هي موقفٌ تجريبي يرى أن الحرية تكمن في الفعل الناجح داخل حدود الممكن، فالأولى تمجد الإنسان كفاعلٍ ثوريٍّ جماعي، والثانية تمجده كفاعلٍ فرديٍّ تجريبي، الأولى ترى في التناقض حتميةً تؤدي إلى التغيير، والثانية ترى في التناقض فرصةً للتجريب، الأولى تؤمن بأن الفكر يسبق الواقع ويقوده، والثانية ترى أن الفكر يتبع الواقع ويتشكل منه. في عمق البلشفية يقبع إيمانٌ ميتافيزيقيٌّ بالحقيقة الموضوعية رغم ماديتها، فهي تنطلق من يقينٍ بأن للعالم بنيةً عقلانية يمكن إدراكها وتغييرها، أما في عمق البراغماتية فيكمن رفضٌ صامتٌ لكل يقين، فهي تنظر إلى الوجود كنسيجٍ مفتوحٍ من التجارب لا يمكن القبض على جوهره، ومن هنا تتبدى المفارقة الكبرى: البلشفية، رغم ماديتها، تمتلك إيماناً شبه دينيٍّ بالمطلق، والبراغماتية، رغم علمانيتها، تغرق في نسبيةٍ تجعل كل شيءٍ مؤقتاً وزائلاً. ولهذا يبدو الإنسان في البلشفية كائناً يحمل رسالة التاريخ، وفي البراغماتية كائناً يحمل أدوات الحياة، في الأولى يتعالى على الضرورة ليخلق المعنى، وفي الثانية يتكيّف مع الضرورة ليحافظ على البقاء، في الأولى يعيش الإنسان من أجل المستقبل، وفي الثانية يعيش من أجل اللحظة، الأولى تعلمه كيف يموت من أجل مبدأ، والثانية تعلمه كيف يعيش من أجل نتيجة، الأولى تخلق أبطالاً، والثانية تخلق ناجحين، الأولى تبني ملحمة، والثانية تبني تجربة. غير أن الحقيقة الإنسانية أعمق من أن تختزل في أحد الطرفين، فحين يسكن البلشفي في إيمانه المطلق يتحول إلى سلطةٍ تقدّس الفكرة وتخنق الإنسان باسم الثورة، وحين يغرق البراغماتي في واقعيته المطلقة يتحول إلى كائنٍ بلا جذورٍ ولا غاية، يبدل مبادئه كما يبدل ثيابه، ويقيس ذاته بما تحققه يده لا بما يحمله ضميره، وهكذا يصبح كلا الطرفين، حين يتطرف، مرآةً لانحراف الآخر: البلشفية قد تتحول إلى استبدادٍ أيديولوجيٍّ جامد، والبراغماتية إلى عبوديةٍ ناعمةٍ للمصلحة، الأولى تميت الروح باسم المبدأ، والثانية تُميت المبدأ باسم الروح. ومع ذلك، لا يمكن للحياة أن تستغني عن أحدهما، لأن الإنسان، في عمقه، يحتاج إلى المبدأ كما يحتاج إلى المنفعة، يحتاج إلى الحلم كما يحتاج إلى الواقع، يحتاج إلى يقين البلشفية ليؤمن، وإلى شكّ البراغماتية ليتعلم، يحتاج إلى ثورةٍ تغير العالم، وإلى تجربةٍ تفهمه، لأن الفكر بلا فعلٍ يتجمد، والفعل بلا مبدأٍ يتبعثر، والإنسان لا يختزل في أحدهما، بل هو الجسر بينهما، الجسر بين الفكرة والواقع، بين العدالة والنجاح، بين أن يكون شاهداً على التاريخ أو أن يكون صانعاً له. إن البلشفية تذكر الإنسان بأن وجوده لا يقاس بما يملك، بل بما يؤمن به، وأن المبدأ يمكن أن يكون طريق الخلاص، فيما تذكره البراغماتية بأن الإيمان دون تجربةٍ يتحول إلى عبء، وأن الفكرة التي لا تثمر واقعاً ليست سوى ترفٍ ذهنيٍّ عقيم، ومن هنا تنبع الضرورة الفلسفية للتوازن بينهما، لأن المبدأ بلا واقعٍ هو خيال، والواقع بلا مبدأٍ هو عبث، والإنسان لا يحيا في الحلم وحده ولا في التجربة وحدها، بل في المسافة بينهما، في المسافة التي تتصارع فيها البلشفية والبراغماتية داخل ضميره، تلك المسافة التي منها يتكون الوعي ويولد المعنى. وهكذا، حين نعيد النظر في هذا الصراع، نكتشف أنه ليس صراعاً بين مذهبين بل بين طبيعتين إنسانيتين: طبيعةٍ تؤمن بالخلود، وأخرى تؤمن باللحظة، الأولى تنشد الحقيقة، والثانية تبحث عن الجدوى، الأولى تقول “أنا أؤمن إذن أنا موجود”، والثانية تقول “أنا أجرب إذن أنا موجود”، الأولى تؤمن أن العالم يمكن تغييره، والثانية تؤمن أن العالم لا يمكن إلا أن يفهم، وبين التغيير والفهم، بين الثورة والتجربة، بين البلشفية والبراغماتية، يمتدّ الوجود الإنساني كرحلةٍ دائمةٍ نحو المعنى، رحلةٍ لا تنتهي إلا بانتهاء السؤال.
الخاتمة:
إن البلشفية والبراغماتية، في جوهرهما الأعمق، ليستا مجرد تيارين فكريين نشآ في سياقاتٍ تاريخية متباينة، بل هما تمثيلان رمزيان لاتجاهين متقابلين في فهم الإنسان والعالم: أحدهما يرى الخلاص في الثورة على الواقع، والآخر في التكيّف معه. البلشفية تنبثق من الإيمان بأن الحقيقة ليست ما هو قائم، بل ما يجب أن يكون؛ إنها نزعة إلى تجاوز الوجود الراهن باسم العدالة والمساواة والمطلق الأخلاقي، حيث الإنسان كائن تاريخيّ يصنع ذاته من خلال الفعل الجمعي والنضال ضد بنية الاغتراب. أما البراغماتية فترى الحقيقة في النتيجة، لا في المثال، وفي المنفعة الواقعية لا في المثال الأعلى، إنها فلسفة الفعل الممكن، لا الفعل الثوري؛ فلسفة الإصلاح البطيء لا الانفجار الكوني. في عمقها، البراغماتية تؤمن بأن الفكر وسيلة لا غاية، وأن الإنسان لا يعرف بما يحلم به بل بما ينجزه في حدود الممكن.
وهكذا، يتبدى لنا أن الفرق بين البلشفية والبراغماتية هو الفرق بين المطلق والنسبي، بين الثورة والتجربة، بين الحلم والتكيف. البلشفي يعيش في صيرورة التاريخ، مؤمناً بأن الوجود لا يكتمل إلا في الجماعة، وأن الحرية لا تتحقق إلا من خلال النفي الجدلي للواقع الظالم؛ أما البراغماتي فيعيش في لحظة الزمن الحاضر، يرى أن كل حقيقة لا تقاس إلا بثمارها، وأن الكلمة التي لا تثمر فعلاً، هي صرخة في الفراغ. البلشفية ابنة الألم والإرادة والتناقض، والبراغماتية ابنة التجربة والتوازن والواقعية.
لكن الإنسان، في نهاية المطاف، لا يعيش بوجهٍ واحد؛ فكل ثوري يحمل في أعماقه براغماتياً خائفاً من السقوط، وكل براغماتي يختزن في صمته ثائراً نائماً ينتظر لحظة الصحو. إن الوجود الإنساني لا يكتمل إلا حين يتصالح المطلق مع النسبي، والحلم مع الواقع، والمبدأ مع الفعل. فحين يتعلم الإنسان كيف يحلم بواقعية، ويعمل بإيمانٍ دون أن يتأله، ويثور من أجل الإنسان لا من أجل العقيدة — حينها فقط يتجاوز البلشفية والبراغماتية معاً نحو إنسانيته العليا.