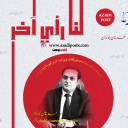بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
إن المجتمعات الجاهلة لا تعادي الكذب بقدر ما تعادي من يكشفه، لأن بنيتها القيمية والنفسية تتأسس على مبدأ الخضوع لا على مبدأ الفهم، وعلى الطاعة لا على النقد. فالحقيقة في فضاءٍ كهذا لا تستقبل كإشراقة وعيٍ، بل كتهديدٍ لانسجام الوهم الجماعي، وكجرثومةٍ تصيب المنظومة الرمزية التي يعيش بها الإنسان ويستمد منها مبرر وجوده. ومن هنا تتحول الحقيقة، في وعي الجماعة المأخوذة بعقائدها، إلى جريمةٍ فكرية، وإلى خنجرٍ يطعن في الذات الجمعية التي بنيت على الأوهام لا على المعرفة.
إن الجهل، في مستواه العميق، ليس حالةً عابرة أو عرضاً طارئاً، بل نظام قائم بذاته، ينتج أدواته ويعيد إنتاج نفسه من خلال آليات الثقافة والدين والسياسة والتعليم. ففي المجتمع الجاهل، يصبح التفكير النقدي فعلاً عدائياً يهدد "المقدس الاجتماعي" الذي تم تشييده عبر قرونٍ من التكرار والطاعة والامتثال. والمجتمع الذي لا يجرؤ على الشك لا يمكنه أن يحتمل الحقيقة، لأن الأخيرة تفكك الموروث وتضعه موضع المساءلة، وهو ما يعتبره الوعي الجمعي نوعاً من العصيان ضد الإرادة الكلية للجماعة. لذلك تقابل كل محاولةٍ للفهم بالرفض، ويدان كل وعيٍ يتجاوز حدود المسموح ككفرٍ أو تمردٍ أو خيانة.
الحقيقة، في ذاتها، لا تحمل قيمةً اجتماعية إلا بقدر ما تخدم مصلحة القطيع. وما إن تتجاوز تلك الوظيفة utilitarian (الفكر النفعي) حتى تصبح خطيرة، لأنها تجبر الأفراد على مواجهة ذواتهم، على الاعتراف بتناقضاتهم، وعلى تحمل مسؤولية وجودهم خارج الغطاء الجمعي. ولهذا تميل المجتمعات الجاهلة إلى تحويل الحقيقة إلى قنبلةٍ موقوتةٍ تخزن في الظل، أو إلى خنجرٍ مسمومٍ يشهر في وجه من ينطق بها. فالأفكار لا تقمع لأنها خاطئة، بل لأنها صحيحة بما يكفي لتقويض منظومةٍ كاملةٍ من الراحة الكاذبة التي تقوم عليها الجماعة.
وفي جوهر المسألة، فإن الصراع بين الحقيقة والجهل ليس معرفياً فحسب، بل أنطولوجي وأخلاقي في الوقت ذاته. فالحقيقة تفترض إرادةً للحياة في معناها الأعمق؛ إرادةً للتحرر، للخلق، وللتجاوز. أما الجهل فهو انكفاءٌ على الذات، وخوفٌ من المجهول، وتمسكٌ بالعادات بوصفها ضمانةً ضد القلق الوجودي. لذلك، حين يعلن الإنسان رغبته في معرفة الحقيقة، فهو لا يطلب معلومةً أو تفسيراً، بل يعلن ثورةً على نمط الوجود ذاته. إنه يخرج من منطقة الأمان إلى فضاء القلق، ومن الطمأنينة الجماعية إلى جحيم الوعي الفردي. ولهذا كانت الحقيقة دائماً فعلاً مأساوياً في مجتمعٍ لم يبلغ بعد مرحلة الوعي بالذات، لأنها تنتزع انتزاعاً من رحم الخوف، لا تمنح من موائد الطاعة.
ولعل ما يفسر مأساة المفكر أو الفيلسوف في التاريخ هو أنه يولد دائماً قبل زمنه. فهو الكائن الذي يرى ما لا يريد الآخرون أن يرى، ويفكر خارج نظام المعنى الذي يوفر لهم الطمأنينة. ولهذا يدان لا لأنه أخطأ، بل لأنه صدق. ينفى أو يسجن أو يشوه، لأن الحقيقة التي يحملها تتجاوز القدرة النفسية للمجتمع على تحملها. هنا تتجلى المفارقة النيتشوية الكبرى: أنّ الحقيقة لا تنقذ الإنسان إلا بعد أن تدمره، ولا تحرره إلا بعد أن تعريه من كل ما كان يحتمي به.
إن المجتمعات التي لا تعطي للحقيقة مكانتها، تحكم على نفسها بالبقاء في دوائر الجهل المتكرر، لأنها ترفض الشرط الأول للنهضة: الجرأة على التساؤل. فحين يجرم الفكر، تقدس الخرافة؛ وحين يسكت صوت العقل، يتكلم الظلام باسم الفضيلة. عندئذٍ تتقدس الأوهام وتشيد لها المعابد، ويصبح الكذب نظاماً أخلاقياً يبرره الجميع باسم “الاستقرار”.
الحقيقة، في النهاية، ليست ما يقال بل ما يحتمل، لأنها امتحان لقوة الإنسان في مواجهة ذاته قبل أن تكون معرفةً بالعالم. هي المرآة التي لا تعكس فقط وجه الإنسان، بل تكشف له ما يخفيه عن نفسه. لذلك فإن الطريق إلى الحقيقة لا يمر عبر الإيمان الأعمى، بل عبر الشك الصادق؛ لا عبر التلقين، بل عبر التجربة. وما من مجتمعٍ بلغ مرحلة الوعي دون أن يمر أولاً بمحنة الحقيقة، أي بمواجهة نفسه وانهيار أوهامه.
وهكذا، تبقى الحقيقة في المجتمع الجاهل جريمةً مؤجلة، وقنبلةً فكريةً مزروعة في أساسات الوعي الجمعي، لا تنفجر إلا عندما تنضج العقول وتتحمل ثمن الضوء. فالحقيقة ليست خلاصاً جماعياً، بل قدرٌ فردي، يولد مع كل من يجرؤ على أن يرى.