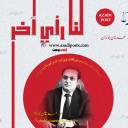ازدحام الأنا وتحولات الوعي: المصلحة الشخصية بوصفها بنية وجودية في التاريخ البشري
- Super User
- البحوث والدراسات
- الزيارات: 3686
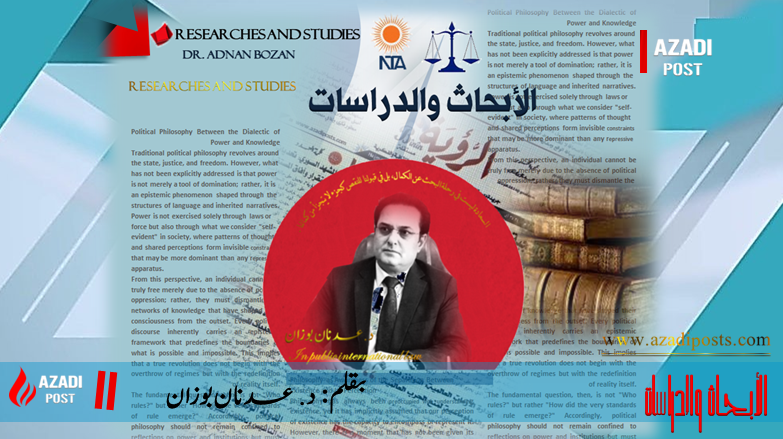 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
مقدمة:
المصلحة الشخصية بين ازدحام الأنا وتدمير عقل البشرية، منذ أن بدأ الإنسان يخط أولى خطواته على مسرح الوجود، ظل يتأرجح بين قوتين متناقضتين: رغبةٍ في الانتماء إلى الجماعة، ونزعةٍ أصيلة نحو حفظ الذات. وفي هذا التوتر الدائم بين "الأنا" و"نحن" تشكلت الفلسفة، وتحورت الأخلاق، وانبثقت كل الأسئلة الكبرى عن معنى الوجود ومنطق السلوك الإنساني.
هل الإنسان كائنٌ أخلاقيّ بطبيعته، أم هو كائنٌ نفعيٌّ بالضرورة، تتحرك دوافعه في العمق وفق حساباتٍ خفية، تحدد شكل الأخلاق التي يتبناها، والنظريات التي يدافع عنها، والسلطات التي يرضخ لها أو يثور عليها؟
تشير قراءة تاريخ الإنسان، منذ بداياته الأكثر بساطة وحتى تعقيد الحضارات الحديثة، إلى حقيقةٍ قلما جرى الاعتراف بها بصورة صريحة: أنّ المصلحة الشخصية ليست طارئة على الوجود الإنساني، وليست شذوذاً أو انحرافاً عن المسار الأخلاقي، بل هي البنية التحتية التي يقوم عليها العقل والسلوك والقرارات، وإن كانت تتخفى أحياناً وراء لغة الفضيلة أو تلبس قناع القيم العامة.
في الأزمنة الأولى، حين كان عدد البشر قليلاً والكون واسعاً بفيض موارده، لم تكن المصلحة الشخصية ظاهرة مكشوفة أو صدامية؛ لم تكن في حاجةٍ إلى قناع أو إلى شرعنة. كانت رغبة الإنسان في البقاء تجري بانسيابٍ بدائي، دون أن تخلق تناقضات حادة أو تثير صراعاً يهدد التعايش. كانت المصلحة جزءاً من الطبيعة، مثل الجوع والعطش والخوف، ولم يكن العقل البشري حينها محكوماً بطبقات التعقيد التي أنتجتها الحضارات اللاحقة.
لكن مع الزمن، ومع تزايد البشر وتقلص المساحات المشتركة، ومع انتقال الإنسان من حالة "التناثر" إلى حالة "الازدحام"، بدأت الأنا تتضخم، لا بوصفها كياناً فردياً فقط، بل كوعيٍ جديد يحكم العلاقات والسلوك. تحولت المصلحة من حاجة بسيطة إلى استراتيجية وجودية؛ ومن غريزة بقاء إلى أيديولوجيا ضمنية تحكم القوانين والاقتصاد والسياسة والأخلاق.
لقد أدى ازدحام البشر، وكثافة المدن، وتشابك المصالح، وتعدد الطبقات، وظهور الملكية الخاصة، وتكاثر مراكز السلطة، إلى خلق ما يمكن تسميته بـ "توحش الأنا". لم تعد المصلحة مجرد دافع، بل أصبحت منظومة فكرية تعاد عبرها صياغة القيم والمعايير.
ولم يعد الإنسان يبحث عن البقاء فقط، بل عن التفوّق، السيطرة، التملك، الاستحواذ، إعادة تشكيل العالم لصالح رغباته.
وبذلك، ومع كل مرحلة من مراحل التاريخ، كان "عقل البشرية" يعاد تشكيله وفق موازين جديدة من المصلحة، حتى وصلنا إلى العصر الحديث الذي يُعَدّ ذروة اكتمال هذا التحول:
عصرٌ لم تعد فيه المصلحة الشخصية خفية، بل أصبحت القانون غير المكتوب الذي يحكم الدولة والسوق والفرد والإعلام والعلاقات البشرية. وأمام هذا الواقع، لم يعد سؤال الفلسفة:
«هل المصلحة موجودة؟»
بل صار السؤال الأخطر:
«إلى أي حدّ يمكن أن تتضخم الأنا قبل أن تدمر عقل البشرية ذاته؟»
فالإنسان المعاصر يعيش انفجاراً غير مسبوق لـ الأنا الفردية: شبكات التواصل الاجتماعي تحول الذات إلى سلعة؛ الاقتصاد النيوليبرالي يعيد تعريف القيمة بوصفها "قدرة على الربح"؛ السلطة السياسية تُدجّن الأخلاق لخدمة مصالحها؛ العلاقات الإنسانية تختزل إلى تبادل منافع؛ والوعي الجمعي يتآكل أمام فردانية شرسة تستمد شرعيتها من صخب العالم.
بهذا المعنى، تبدو المصلحة الشخصية اليوم ليست مجرد سلوك، بل آلية تفكير توجه الحداثة، وتعيد تشكيل تصورات البشر عن الحرية والعدالة والذات والآخر.
ازدحام "الأنا" هذا، بتضخمها المَرَضي، لا يهدد الأخلاق فحسب، بل يهدد بنية العقل ذاته، إذ يحول العقل الإنساني من عقلٍ قادرٍ على إنتاج قيم مشتركة إلى عقلٍ أسيرٍ لدوائر ضيقة من المنفعة والأنانية.
وهكذا، ما بين بدايات الوجود التي كانت فيها المصلحة متخفية داخل بساطة العيش، ومرحلتنا الراهنة التي أصبحت فيها المصلحة الشيفرة الأساسية التي تتحكم في النظام العالمي، يتكشف لنا مسار طويل من التطور النفعي الذي يفسر الكثير من ظواهر التنازع، والانهيار الأخلاقي، وتصدع القيم، وتفكك المجتمعات، وانحسار الثقة بين الأفراد.
إنّ البحث في "المصلحة الشخصية" ليس بحثاً في انحرافٍ إنساني، بل هو بحث في جوهرٍ وجودي شكل الإنسان كما نعرفه، وهدد – ولا يزال يهدد – شكل العقل الجمعي الذي يفترض أنه يحمي بقاء النوع ويضمن استقرار الحضارة.
ومع ازدياد ازدحام العالم، قد لا يكون السؤال: «كيف نواجه المصلحة؟»
بل:
كيف نمنع المصلحة من أن تتحول إلى القوة التي تدمر الإنسان من الداخل، وتحطم توازنه، وتجر البشرية إلى صراعٍ دائم لا ينتصر فيه أحد؟
أولاً: المصلحة الشخصية في البدايات – حين كان الإنسان نادراً والموارد واسعة
حين نعود إلى المراحل الأولى من الخليقة، لا بوصفها حدثاً ميتافيزيقياً بل كشرط وجودي تكويني، نكتشف أنّ "المصلحة الشخصية" لم تكن مفهوماً واعياً أو منظومة سلوكية مصاغة، بل كانت نبضاً طبيعياً ضمن جسد الكون، تتحرك على إيقاع البقاء وبداهة الغريزة. لم تكن هناك فلسفات، ولا مؤسسات، ولا أخلاقٌ مصممة لتبرير أو إخفاء الدوافع؛ كان الإنسان أقرب إلى كائنٍ محايد يعيش في فضاءٍ رحب، تحدده الطبيعة أكثر مما يحدده الوعي.
كانت المجتمعات البشرية الأولى صغيرة الحجم، مشتتة، قليلة العدد إلى درجة أنّ مفهوم "الصراع الوجودي" لم يكن يحتل سوى مساحة محدودة جداً من التجربة اليومية. الندرة – التي ستصبح لاحقاً أصل المصلحة والصراع – لم تكن مشكلة حقيقية. الموارد كانت واسعة قياساً بالبشر، والسكن متناثر، والحدود غير موجودة. ولهذا، فإنّ المصلحة الشخصية آنذاك لم تكن محمولة على رغبة في السيطرة، بل على حاجة في الاستمرار.
كانت دوافع الإنسان الأولى بسيطة ومباشرة:
- البقاء – أن يعيش يوماً آخر.
- الطعام – أن يملأ فراغ الجسد بما يسدّ رمقه.
- المأوى – أن يحتمي من برد الليل وافتراس الطبيعة.
- التكاثر – أن ينقل وجوده إلى جيل لاحق.
هذه الحاجات الأربعة كانت كافية لتفسير السلوك، دون أي رغبة في التفوق أو السيطرة أو التعالي. ولذلك، كانت الأنا في بداياتها شديدة الشفافية، لا تختبئ خلف لغة، ولا تتزيّن بقناع، ولا تبحث عن شرعية. لم تكن مضطرة للتلاعب أو الالتفاف، لأن العالم لم يكن مكتظاً إلى حد يفرض الاحتيال أو يخلق أنظمة معقدة للهيمنة.
كانت المصلحة تمارس بوصفها امتداداً طبيعياً للحياة، مثل النمو لدى النباتات أو الهجرة لدى الطيور. لم يكن الإنسان يختبر وجوده باعتباره ساحة تنافس، بل باعتباره سلسلة من الاستجابات الغريزية، حيث تتطابق المصلحة مع الفطرة، ويتطابق السلوك مع الضرورة.
وقد ساهم غياب الضغوط السكانية في أن لا يحتاج الإنسان البدائي إلى تطوير "ذكاء اجتماعي" معقد. لم تكن هناك حاجة لبناء بنية أخلاقية أو سياسية تخفي المصلحة أو تشرعنها، لأن العالم لم يكن يفرض على الفرد أن يتقن فن المراوغة. كانت الحياة شفافة بالقدر الذي تصبح فيه "الأخلاق" مجرد وصف للتصرفات الطبيعية، لا نظاماً معيارياً يحكم السلوك.
ولهذا يبدو الماضي – في الخيال الجمعي – أكثر "براءة".
لكن هذه البراءة ليست قيمة أخلاقية، بل نتيجة لقلة البشر وبداهة العلاقات. فالإنسان القديم لم يكن أكثر خيراً مما نحن عليه اليوم، بل كان يعيش ضمن شروطٍ لا تكشف المصلحة ولا تحولها إلى صراع. لم يكن مدفوعاً بمبدأ الفضيلة، بل كان محرراً من ضغط الكثرة. لهذا تبدو تلك الأزمنة بدائية ولكن غير مأزومة، بسيطة ولكن غير معقدة، غريزية ولكن غير شرسة.
إنّ تضاؤل الكثافة البشرية منح المصلحة مساحةً لتبقى "داخلية"، لا تحتاج إلى خطاب أو تبرير. كانت مصلحة بلا خطاب، وغريزة بلا أيديولوجيا، وأنا بلا تضخم. ومن منظور فلسفي، يمكن القول إنّ المصلحة في تلك الحقبة كانت متوافقة مع الطبيعة، وليست مفارقة لها كما أصبح الحال مع تطور الحضارة.
فالماضي لم يكن "أخلاقياً" أكثر مما هو طبيعي؛ ولم يكن الإنسان فيه "نقياً"، بل كان ببساطة غير مهدَّد. وما يصفه الفلاسفة بـ«الفطرة الأولى» كان في جوهره نتاجاً لغياب المنافسة، لا لوجود فضيلة مطلقة. بهذا المعنى، كانت المصلحة الشخصية آنذاك محايدة، شفافة، تنساب في الداخل دون أن تتجسّد في أنظمة أو تترجم إلى صراع.
إنّ هذا التوازن الهش هو الذي سيبدأ بالانهيار شيئاً فشيئاً مع اتساع عدد البشر، ومع ازدياد ندرة الموارد، ومع تشكل الملكية، ومع ظهور السلطة، ومع تحول العلاقات البشرية من بساطة الضرورة إلى تعقيد المصالح. ومن تلك اللحظة، ستخرج المصلحة من خفائها وتلبس آلاف الأقنعة: من الفلسفة إلى الأخلاق إلى السياسة.
ثانياً: تحول الوعي الاجتماعي – من الحاجة إلى التعقيد
مع تزايد عدد البشر وتحول العالم من فضاءٍ مفتوح إلى ساحة مزدحمة بالتنافس والتداخل، بدأت المصلحة الشخصية تفقد براءتها الأولى. لم تعد غريزة بدائية تتبع إيقاع الطبيعة، بل تحولت إلى بنية مركبة تتشكل عبر الاقتصاد والسياسة والرموز والثقافة. هنا، بدأ الإنسان ينتقل من العيش ضمن قوانين الطبيعة إلى العيش ضمن قوانين يصنعها هو، قوانين لا تعبر عن الكون بقدر ما تعبر عن احتياجات الأنا ورغبتها في الديمومة والهيمنة.
ومع توسع المجتمعات الأولى، حدث التحول الأخطر: لم تعد المصلحة الشخصية مقتصرة على "البقاء"، بل أصبحت مرتبطة بـ الامتلاك، النفوذ، التنظيم، الهيكلة، وتبرير السلوك. لقد دخل الإنسان مرحلةً جديدة من التاريخ: مرحلة التعقيد، وهو التعقيد الذي لم يأتِ من فراغ، بل من ضغط الكثرة ومن تضارب المصالح، الأمر الذي فرض على العقل البشري أن يبتكر أدوات جديدة لحماية نفسه.
- ظهور الملكية – ولادة الخوف بوصفه أصلاً للمصلحة
حين اكتشف الإنسان مفهوم "الامتلاك"، لم يكن ذلك مجرد انتقال مادي، بل كان تحولاً أنثروبولوجياً غيّر طبيعة العلاقة بين الإنسان والعالم.
فالامتلاك يعني:
- تخصيص ما كان مشاعاً
- احتكار ما كان مشتركاً
- تحويل الطبيعة إلى "شيء"
- ومن ثمّ ظهور "الآخر" بوصفه تهديداً محتملاً
من هنا نشأ الخوف؛ والخوف هو الأب الشرعي للمصلحة المحسوبة. بعد أن كان الإنسان يخشى الطبيعة، بدأ يخشى الإنسان نفسه. وبدلاً من أن تكون المصلحة رغبة في البقاء، أصبحت هواجس دفاعية: حماية ما أملك، ضمان ما أحوز، منع الآخرين من الاقتراب.
ومع نمو مفهوم الملكية، ظهرت الحاجة إلى أنظمة تحميها، وتسبب ذلك في انتقال الإنسان من البساطة إلى الهندسة الاجتماعية: قوانين، حدود، نظم، عقوبات، تقاليد، أعراف… كلها بنيت لأجل شيء واحد:
إبقاء المصلحة في يد صاحبها ومنع الآخرين من تهديدها.
- تشكل السلطة – المصلحة حين ترتدي لبوساً جماعياً
لكن الملكية وحدها لم تكن كافية لحماية المصلحة، فالمجتمعات المتزايدة احتاجت إلى قوة مركزية تنظم العلاقات. هكذا ظهرت السلطة، ليس بوصفها تكليفاً، بل بوصفها تجسيداً للأنا حين تتضخم وتصبح جماعية.
ومع السلطة، تعددت أشكال المصالح:
- مصلحة القبيلة: حماية الدم والنسب
- مصلحة الحاكم: تثبيت السيطرة
- مصلحة التاجر: تأمين السوق
- مصلحة رجل الدين: احتكار الحقيقة
- مصلحة الجماعة: تبرير العداء تجاه الآخر
وعلى الرغم من اختلاف هذه الأشكال، فإنها تشترك في شيء واحد: إنها امتدادات للأنا، لكنها أنا متكاثرة، تتخفى وراء شعارات كبرى: الشعب، الأمة، الدين، القيم، العدل، النظام…
وهكذا أصبح “الآخر” لا يهدد الفرد فقط، بل يهدد “الهوية” و“الوجود” و“الثقافة” و“العقيدة”. وبذلك، تم تضخيم المصلحة، وتقديسها، وتغليفها بمفاهيم عليا.
- بناء الأخلاق كأقنعة – حين يصبح السلوك خطاباً منظماً
مع تعقد الحياة وارتفاع مستويات التنافس، نشأت الحاجة إلى لغة تضبط السلوك. لم تعد القوة وحدها كافية؛ فالعالم بدأ يحتاج إلى منظومة رمزية تنظم العلاقات وتمنح السلوك طابعاً شرعياً.
وهكذا ولدت الأخلاق، لا بوصفها قيماً مطلقة، بل بوصفها:
- آليات للضبط
- قوانين لحماية المصالح
- أقنعة ناعمة للهيمنة
الأخلاق في جانب كبير منها لم تخلق لتقييد الذات، بل لتقييد الآخرين. فهي تقول للشخص:
لا تقترب من ملكيتي، لا تعتدِ على ما أملك، لا تفكر بما يهدد سلطتي…
وتقول للمجتمع:
احترم الحاكم، صُن المراتب، أطع السلطة، قِف عند حدودك…
بذلك، تحولت الأخلاق من كونها انعكاساً للفضيلة، إلى كونها أداة سياسية–اجتماعية، وظيفتها ليست القضاء على المصلحة، بل إعادة ترتيبها وترويضها بحيث تخدم النظام العام، وأحياناً السلطة نفسها.
لقد صنعت الأخلاق قناعاً جميلاً، لكنه قناع يخفي تحت سطحه شبكة كثيفة من المصالح المتداخلة. فما يبدو "خيراً" في المجتمع، غالباً ما يكون بنية مصلحة تتوارى خلف خطاب الفضيلة. وما يبدو "قيمة" قد يكون في العمق أداة للسيطرة.
بهذا التحول، انتقل الإنسان من مرحلة الغريزة إلى مرحلة البنية الاجتماعية، ومن المصلحة البسيطة إلى المصلحة المعقدة التي تحتاج إلى أنظمة، ورموز، وأخلاق، وقوانين لحمايتها. وهذا التحول هو الذي سيقود إلى المرحلة التالية:
مرحلة احتدام الأنا وتضخمها حتى تصبح المصلحة معياراً عالمياً.
ثالثاً: العصر الحديث – حين أصبحت المصلحة الشخصية مكشوفة ومؤسَّسة
إذا كانت المصلحة في الماضي تخفى خلف بساطة الوجود، وفي العصور اللاحقة تختبئ تحت أغطية الأخلاق والسلطة والملكية، فإنها في العصر الحديث خرجت إلى العلن بلا وجل.
لقد بلغت البشرية نقطةً في تاريخها لم تعد فيها المصلحة اكتشافاً نفسياً أو سلوكاً ضمنياً، بل أصبحت النظام الضمني الذي يحكم العالم، ويوجه العقل الجمعي، ويشكل الفرد من لحظة ولادته حتى لحظة موته.
يمتاز عصرنا بكثافة بشرية لم يعرفها التاريخ، وبعالم متشابك عبر الشبكات والأقمار الصناعية والإنترنت، حيث كل شيء يُرى، يُحلَّل، يُراقَب، ويُقاس. ومع هذا الانكشاف الكلي، صار الإنسان يواجه ذاته بلا وسائط، بلا أقنعة كثيرة، وبلا قدرة على إخفاء دوافعه كما في السابق.
لقد أفرز هذا عصراً جديداً من المصلحة المكشوفة، حيث تحول الفرد نفسه إلى وحدة اقتصادية، إلى مشروع ربح وخسارة، إلى «علامة» و«صورة» و«قيمة سوقية» يمكن قياسها والتعامل معها.
- الإنسان كمشروع للمصلحة – ولادة الذات الاقتصادية
العصر الحديث أعاد صياغة الذات البشرية بطريقة غير مسبوقة. لم يعد الإنسان كائناً وجودياً يبحث عن معنى، بل أصبح:
- وحدة إنتاج
- وحدة استهلاك
- وحدة بيانات
- وحدة نفوذ
- وحدة منافسة
- سلعة في سوق العمل
- وصورة في سوق التواصل الاجتماعي
بهذا التحول، أصبح الإنسان «مشروعاً»، لا يعيش عفوياً بل يتحرك وفق حسابات دقيقة: كيف يظهر؟ ماذا يملك؟ ما قيمته؟ ما أرباح حضوره أو خسائره؟
لقد صارت الذات خريطة مصالح، تعيد تنظيم كل شيء – حتى المشاعر – وفق جدوى ما تمنحه أو ما تسلبه.
- صعود المصلحة إلى السطح – منطق يحكم السياسة والإعلام والسوق
في العصر الحديث، لم تعد المصلحة شيئاً مخفياً. لقد صارت:
- لغة السياسة: حيث تختفي العدالة خلف هوامش النفوذ.
- قلب الإعلام: حيث تتحوّل الحقيقة إلى مادة قابلة للبيع.
- ركيزة السوق: حيث يقاس الإنسان بما يستهلكه ويشتريه.
- محرّك العلاقات الاجتماعية: حيث تعاد صياغة الصداقة، الحب، الزواج، الأدوار الأسرية وفق توازن القوة والمنفعة.
بهذا المعنى، أصبحت المصلحة منطقاً عاماً يحكم العالم، مثل قانون الجاذبية: غير مرئي لكنه حاكم، غير معلن لكنه حاضر، غير معلَّم لكنه يتحكم بكل حركة.
- صيغة المصلحة المعاصرة – الاستهلاك، الفردانية، التسويق، السعي للسلطة
مع تضاؤل الموارد وازدياد البشر، أخذت المصلحة أشكالاً أكثر وضوحاً:
أ) الاستهلاك
لم يعد الإنسان يشتري ليعيش، بل يعيش ليستهلك.
أصبح الاستهلاك هو اللغة التي يعبّر بها الفرد عن ذاته:
ما تملكه يعرّفك، وما تشتريه يمنحك قيمة ومكانة.
تحوّلت المصلحة إلى رغبة دائمة في الحصول على المزيد، حتى لو لم يكن ذلك مرتبطاً بأي حاجة حقيقية.
ب) التسويق
في عصر التسويق، كل شيء يعلن عن نفسه:
السلع، الأفكار، الأشخاص، الأجساد، الخطابات، وحتى الأحلام.
أصبح التسويق هو فن تحويل الرغبة إلى اقتصاد، وتحويل الإنسان إلى زبون دائم، يسعى دائماً وراء شيء ما يظنه ضرورياً.
ت) الفردانية
الفرد ليس مجرد ذات مستقلة، بل أصبح مرتكزاً أخلاقياً:
المصلحة تعاد صياغتها بوصفها حقاً.
والأنانية تعاد تعريفها بوصفها حرية.
والانعزال يعاد تأويله بوصفه بحثاً عن الذات.
هكذا تتحول الأنا من غريزة إلى أيديولوجيا كاملة.
ث) السعي للسلطة
لم تعد السلطة حكراً على الحاكم أو القائد.
أصبح كل فرد يسعى إلى شكل من أشكال السلطة:
سلطة الشهرة، سلطة الصورة، سلطة الانتباه، سلطة المال، سلطة المتابعين، سلطة التأثير…
السلطة هنا ليست غاية سياسية بل شرطاً وجودياً يمنح الإنسان وهماً بالقيمة.
ج) إعادة تعريف العلاقات الإنسانية وفق الربح والخسارة
في العالم الحديث، أصبحت العلاقات شبكةً من الحسابات:
ماذا يقدم هذا الشخص؟
هل يرفع قيمتي؟
هل يضيف إلى مشروعي الشخصي؟
تحول الإنسان من ذاتٍ تحب وتتعاطف وتتشارك، إلى ذاتٍ تحسب وتقارن وتوازن وتستثمر.
- الإنسان المعاصر – من البحث عن البقاء إلى البحث عن الفائض
لقد تغيرت نقطة الارتكاز في الحياة البشرية.
لم يعد الإنسان يسعى ليحيا، بل يسعى ليحقق فائضاً من المصلحة:
فائض في المال
فائض في الاعتراف
فائض في القيمة
فائض في الظهور
فائض في السيطرة
فائض في الرمزية
إنّ هذا الفائض هو الذي دفع الإنسان نحو صراع لا ينتهي، صراع يتجاوز الحاجة الجسدية ليصل إلى عمق الأنا:
أنا أستهلك إذن أنا موجود.
أنا أُرى، إذن لي قيمة.
أنا أجمع، إذن أتحقق.
أنا أعلو، إذن أتفوّق.
بهذا المعنى، يشهد العالم اليوم المرحلة الأكثر وضوحاً للمصلحة الشخصية، المرحلة التي لم تعد فيها المصلحة تختبئ خلف قناع، بل أصبحت هي القناع، وهي الوجه، وهي المنطق المحرِّك للعقل البشري.
رابعاً: الفلسفة بين الإدانة والتفسير
حين دخلت “المصلحة الشخصية” فضاء التفكير الفلسفي، تحولت من ظاهرة سلوكية إلى سؤال ميتافيزيقي وأخلاقي وسياسي في آنٍ واحد. فالفلاسفة، منذ بدايات التفكير المنهجي، لم يواجهوا سؤالاً أكثر استعصاءً من سؤال: ما الدافع الحقيقي وراء أفعال الإنسان؟ وهل يمكن للكائن البشري أن يفعل شيئاً "لوجه الحقيقة" خالصاً من أي منفعة، أم أن كل سلوكٍ مهما بدا نبيلاً يخفي وراءه رغبة في التحقق أو الهيمنة أو البقاء؟
لقد تشتتت المواقف الفلسفية بين من يرى في المصلحة لعنة تدمر الأخلاق، ومن يراها بنية طبيعية لا يمكن للإنسان الفكاك منها، ومن يفسر التاريخ كله من خلالها. وفيما يلي قراءة معمّقة لهذه المواقف:
- هوبز: المصلحة بوصفها "طبيعة الإنسان" ذاتها
يرى توماس هوبز أنّ الإنسان، في وضعه الطبيعي، كائن تسكنه الرغبات وتتحكم فيه المخاوف. وما يبدو لنا اليوم "أنانية" ليس أكثر من امتدادٍ لغريزة البقاء. لذلك قال جملته الشهيرة:
"الإنسان ذئبٌ للإنسان."
المصلحة عند هوبز ليست انحرافاً أخلاقياً، بل هي البنية التحتية لكل سلوك إنساني. وبما أنّ البشر متساوون في القدرة على إلحاق الأذى ببعضهم، كان لا بدّ من صناعة الدولة لضبط المصالح وضمان الحدّ الأدنى من الأمان. وهنا تصبح الأخلاق مجرد عقد اجتماعي، لا مبدأ مفارقاً.
- أرسطو: المصلحة ممكنة… لكن الفضيلة تضبطها
أرسطو لا ينكر وجود المصلحة، لكنه يرى أنّ الإنسان يمكنه، عبر التربية والعادة، أن يتحول إلى كائن قادر على تهذيب رغباته.
فالفضيلة ليست إنكاراً للمصلحة، بل صياغة عقلانية لها بحيث تتحول من رغبات فوضوية إلى حياة متزنة تقوم على الحكمة وضبط النفس.
عند أرسطو، تتعايش المصلحة مع الأخلاق، لكن بشرط أن تتسامى «الأنا» فوق غرائزها لكي تضمن انسجامها مع الحياة المشتركة.
- نيتشه: الأخلاق نفسها مصلحة للقوي
يذهب نيتشه إلى أبعد نقطة في تحليل المصلحة:
يعتبر أن الأخلاق ليست إلا ابتكاراً من ابتكارات الإنسان القوي، تستخدم لإعادة ترتيب العالم وفق إرادته.
أما الأخلاق الدينية – في رأيه – فهي مصلحة الضعيف الذي يحاول أن يحول عجزه إلى قيمة.
وهكذا، فإنّ المصلحة عند نيتشه ليست سلوكاً فردياً، بل قوة حيّة تعبّر عن إرادة التفوق. الأخلاق هنا ليست قيداً على المصلحة، بل شكلٌ من أشكالها.
- ماركس: كل وعيٍ هو انعكاس لمصلحة طبقية
في الفلسفة الماركسية، المصلحة ليست فردية فقط، بل طبقية.
فالوعي السياسي، الأخلاق، الدين، الفنون… كلها – وفق ماركس – انعكاسات للبنية الاقتصادية.
وهكذا يصبح التاريخ صراعاً بين مصالح الطبقات:
البرجوازية التي تسعى للحفاظ على رأس المال، والطبقة العاملة التي تسعى لتغيير البنية.
عند ماركس، لا توجد أفكار "محايدة" أو "خالصة":
كل فكرة، مهما بدت فلسفية أو روحية، تحمل بصمتها الاقتصادية.
- الفلسفة المعاصرة: من الإدانة إلى الفهم
الفكر الحديث، خصوصاً بعد صعود علم النفس، السوسيولوجيا، والأنثروبولوجيا، لم يعد ينظر إلى المصلحة كعيب أو خطيئة، بل كـ شرط إنساني طبيعي.
والمهمة لم تعد إدانة "الأنا"، بل فهم كيف يمكن تنظيم مصالح البشر بحيث لا تتحول إلى قوة تدمر المجتمع والعقل والبيئة.
وبذلك انتقلنا من السؤال:
هل المصلحة شرّ؟
إلى السؤال الأكثر فلسفية:
كيف يمكن هندسة المصلحة بحيث تخدم الإنسان لا أن تستعبده؟
خلاصة هذا المحور
الفلسفة لم تستطع أن تلغي المصلحة الشخصية، لكنها استطاعت أن تمنحنا أدوات لفهمها:
- هوبز أعادها إلى الطبيعة.
- أرسطو حاول تهذيبها.
- نيتشه فضح أقنعتها.
- ماركس حولها إلى محرّك للتاريخ.
- الفلسفة المعاصرة جعلت منها بنية قابلة للإدارة لا للإلغاء.
وهكذا، يتّضح أن المصلحة ليست انحرافاً، بل هي أحد أعمدة الوجود الإنساني، وما يدمر الإنسان ليس وجود المصلحة، بل تحولها إلى طغيانٍ دون وعيٍ أو ضابط.
خامساً: بين الفرد والجماعة – كيف تغير الزمن ملامح المصلحة؟
إذا كانت المصلحة الشخصية ثابتة بوصفها غريزة أولية تلازم الإنسان منذ انبثاقه إلى الوجود، فإن ما تغير عبر التاريخ ليس جوهر المصلحة، بل هندستها، وامتداداتها، والوعي الذي يحيط بها. فالزمن لا يبدل الطبيعة البشرية بقدر ما يعيد تشكيل شروطها الخارجية، وبذلك تتبدل صورة المصلحة دون أن تتغير جذورها.
- تغير الحجم: من مصلحة فردٍ إلى مصلحة مجتمع
في العصور الأولى، كانت دائرة المصلحة ضيقة، فردية، تلبي احتياجات مباشرة: الطعام، النجاة، الحماية. أما اليوم، فقد تمددت هذه الدائرة بحيث لم تعد المصلحة مسألة شخصية، بل بنية اجتماعية واسعة تشمل:
- الشركات
- الدول
- المؤسسات المالية
- الأحزاب
- الهويات الجماعية
لم تعد "مصلحتي" تخصني وحدي؛ لقد أصبحت متداخلة مع مصالح ملايين البشر الذين لا أعرفهم، ومؤثرة في نظام عالمي مترابط.
- تغير الوعي: من فعلٍ غريزي إلى حسابٍ دقيق
الإنسان القديم لم يكن يعي مصلحته بعمق، كان يعيشها تلقائياً. أما الإنسان الحديث فيمتلك قدرة على:
- التخطيط
- القياس
- توقع النتائج
- بناء استراتيجيات شخصية وجماعية
- استثمار الصور والقيم واللغة لخدمة مصلحته
أصبح الوعي نفسه أداة لحماية الأنا، وتحقيق مكاسب تمتد إلى ما يتجاوز الحاجة إلى البقاء. وهنا تحولت المصلحة من غريزة إلى هندسة نفسية واجتماعية.
- تغير التأثير: من سلوك فردي إلى قوة تعيد تشكيل المجتمع
مصلحة فرد واحد في الماضي لم تكن قادرة على تغيير شكل القبيلة أو القرية.
أما اليوم، فإنّ:
- مصلحة شركة قد تغير سوقاً بأكمله
- مصلحة سياسي واحد قد تغير خريطة دولة
- مصلحة نخبة مالية قد تغير اتجاه العالم
وبذلك أصبحت المصلحة قوة تعيد تشكيل العالم، لا مجرد سلوك صغير معزول.
- تغير البنية: من مصلحة بدائية إلى منظومات تشرعن المصلحة
في الماضي، كانت المصلحة فعلاً مباشراً. اليوم أصبحت:
- قانوناً
- مؤسسة
- نظاماً اقتصادياً
- خطاباً إعلامياً
- هوية اجتماعية
- عقيدة سياسية
لقد تطورت المصلحة حتى أصبحت تحمل شكلاً «شرعياً» أو «طبيعياً» في نظر الناس. فالفرد اليوم يطالب بمصلحته كما يطالب بحقه، وكأنهما الشيء نفسه.
- من مصلحة فرد إلى مصلحة شبكية
المصلحة في حاضر البشرية لم تعد خطاً واحداً، بل شبكة:
متشابكة، متداخلة، يصعب فصل أطرافها.
الفرد اليوم محاصر بشبكة مصالح:
- يستهلك لأنه جزء من السوق
- يعمل لأنه جزء من النظام الإنتاجي
- ينتمي لأنه جزء من هوية
- يصوت لأنه جزء من لعبة سياسية
- يتواصل لأنه جزء من خوارزميات إعلامية
وكلّ هذه الشبكات لا تنهي المصلحة؛ بل تجعلها أكثر تعقيداً وضخامة، وأكثر قدرة على تشكيل الوعي العام.
- الزيادة البشرية: من الستر إلى الانكشاف الكامل
حين كان عدد البشر قليلاً، كانت المصلحة خفية، غير مثيرة للضجيج. أما اليوم، ومع تضخم الكثافة البشرية، لم تعد المصلحة قادرة على التخفي:
- ازدحام المدن
- احتدام الموارد
- تسارع الاقتصاد
- تشابك الهويات
- صعود التقنية
- العيش في عالم مكشوف
كل هذا جعل المصلحة تكشف نفسها بلا وجل، بل وتفرض نفسها كـ قانون وجود يحكم حركة المجتمع وسلوك الأفراد.
خلاصة هذا المحور
إنّ الزمن لم يخلق المصلحة، لكنه كشف طبقاتها، ووسع نطاقها، وحولها من ظاهرة فردية بسيطة إلى قوة كونية تعيد صياغة العالم.
ولذلك أصبح من المستحيل فهم السياسة أو الاقتصاد أو العلاقات الإنسانية دون فهم طبيعة المصلحة وكيف تغيّرت صورها.
خاتمة:
إنّ القول بأن «الحياة كلها مصلحة شخصية» ليس حكماً أخلاقياً، ولا محاولة لتجريم الإنسان أو نزع إنسانيته؛ بل هو تشريحٌ فلسفي لبنية الوجود البشري كما تكشفت عبر التاريخ. فالإنسان، منذ أول لحظةٍ وضع فيها قدمه على الأرض، لم يكن كائناً خارج الحاجة ولا خارج الخوف ولا خارج السعي إلى النفوذ. إنه كائنٌ يحيا في مساحةٍ ضيقة بين ندرة الموارد وتهديد الفناء، ولذلك صاغت المصلحةُ وعيه قبل أن تصوغ الأخلاق سلوكه.
لكن الزمن – بتغير شروطه – لم يبدل جوهر المصلحة بقدر ما أعاد ترتيبها. فالبشرية انتقلت من:
- البساطة إلى التعقيد: إذ تحولت المصلحة من همٍّ يومي بالبقاء إلى هندسةٍ كبرى تحكم الاقتصاد والسياسة والثقافة.
- الغريزة إلى الحساب: حيث أصبح الإنسان يخطّط، ويعدّ، ويستثمر، ويخفي المصلحة خلف خطابٍ عقلاني مهيب.
- الحاجة إلى الاستراتيجية: لم تعد المصلحة مجرد إشباع للرغبة، بل أصبحت مشروعاً طويل الأمد، بنية وجودية تحدد موقع الإنسان داخل العالم.
وفي هذا التحول الهائل، تكشف ما كان مخفياً في العصور الأولى:
الأخلاق لم تنشِئ الإنسان، بل الإنسان هو الذي أنشأ الأخلاق لتجميل صراعه.
فالقيم، مهما بدت نقيّة، ليست سوى طبقة رقيقة – أشبه بقشرة جمالية – تخفي تحتها محركاً أعمق: المصلحة، التي عملت باستمرار على صياغة العلاقات، وبناء الجماعات، وتشريع القوانين، وصناعة الخطاب.
إن ازدحام الأنا في عالمٍ يتكاثر بسرعة الضوء جعل المصلحة أكثر وضوحاً، أكثر حضوراً، وأكثر قدرة على إعادة تشكيل العقل الجمعي. وفي الوقت نفسه، جعل هذا العقل هشّاً، عرضة للانقسام والتشتت، لأن تضخم المصالح الفردية – والشبكية والمؤسسية – يهدد البنى المشتركة التي يحتاجها الإنسان ليحيا حياةً ذات معنى.
وهكذا تبدو البشرية اليوم، في لحظتها الراهنة، أوضح من أي زمنٍ مضى:
لم تبنِها الأخلاق، بل بنتها المصلحة.
لم توحدها القيم، بل جمعتها الحاجة.
ولم تدفعها الأيديولوجيات، بل حركتها رغباتٌ قديمة تلبس أشكالاً حديثة.
ومع ذلك، فإنّ فهم هذا الواقع لا يعني القبول بمآلاته، بل الوعي بأن إدارة المصلحة – لا نفيها – هي الطريق الوحيد لإنقاذ العقل من التفكك، والإنسان من الغرق في ازدحام الأنا.
فالمصلحة ليست عدواً، لكنها قد تصبح عدواً حين تترك بلا وعي، بلا حدود، بلا مسؤوليّة.
وفي النهاية، لا يمكننا أن نلغي المصلحة من حياة الإنسان، لكنها تحتاج – كما كل قوة وجودية كبرى – إلى فلسفةٍ تضبطها ووعيٍ يوجهها حتى لا تتحول إلى سلاحٍ يدمر ما تبقى من العقل البشري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Polity Press.
- Dawkins, R. (2016). The Selfish Gene. Oxford University Press.
- De Waal, F. (2009). The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society. Harmony Books.
- Diamond, J. (1997). Guns, Germs, and Steel. W. W. Norton.
- Freud, S. (2002). Civilization and Its Discontents. Penguin Books.
- Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Stanford University Press.
- Harari, Y. N. (2015). Sapiens: A Brief History of Humankind. Harper.
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons." Science, 162(3859), 1243–1248.
- Hobbes, T. (2012). Leviathan. Oxford University Press. (Original work 1651)
- Lasch, C. (1991). The Culture of Narcissism. W. W. Norton.
- Mill, J. S. (2001). Utilitarianism. Hackett Publishing.
- Nietzsche, F. (2006). On the Genealogy of Morality. Cambridge University Press.
- Rand, A. (1964). The Virtue of Selfishness. Signet.
- Rousseau, J.-J. (1997). Discourse on the Origin and Foundations of Inequality Among Men. Cambridge University Press.
- Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.
- Smith, A. (2010). The Theory of Moral Sentiments. Penguin Classics. (Original work 1759)
- Taylor, C. (1989). Sources of the Self. Harvard University Press.