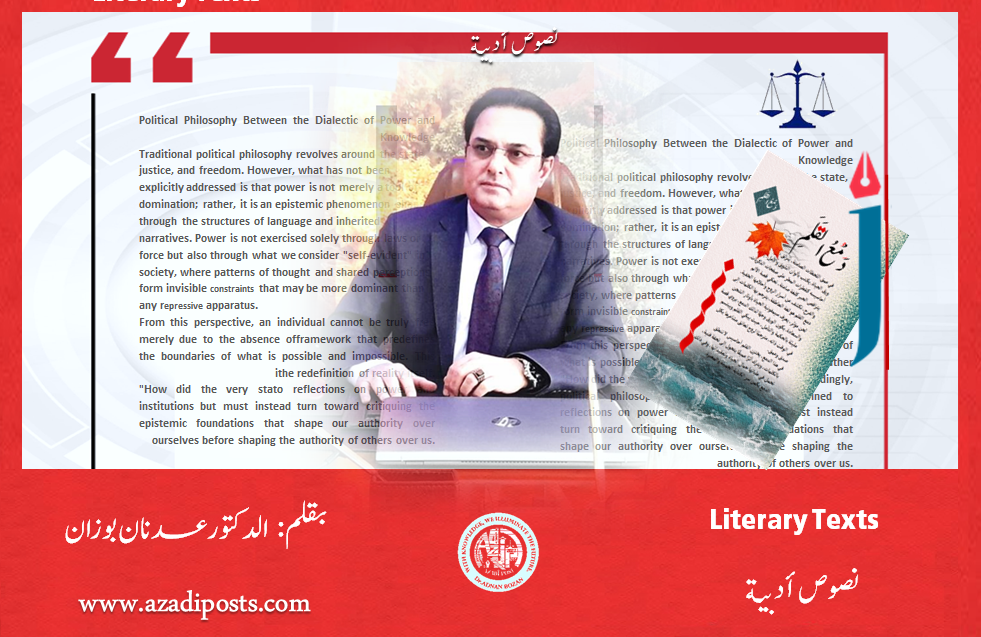 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
رحلتي إلى الوطن بعد أربعة عشر عاماً لم تكن عودةً، بل انكشافاً جارحاً للحقيقة؛ كانت لحظة اصطدامٍ قاسٍ بين ما حفظته الذاكرة حياً في قلبي، وما تركه الزمن واقفاً أمامي بملامح غريبة لا تعرفني. عدتُ وأنا أحمل وطناً كاملاً في داخلي، فإذا بالوطن الذي استقبلني يقف على الضفة الأخرى، ينظر إليّ ببرودٍ كأنني عابر سبيلٍ لا ابن هذه الأرض. أدركتُ منذ الخطوة الأولى أن بعض الأوطان لا تستعاد، بل يسمح لنا بزيارتها كما تزار المقابر: بخشوعٍ ثقيل، وبصمتٍ موجع، وبقلبٍ مكسور.
دخلتُ من المعبر، وكان المعبر جرحاً مفتوحاً في جسد الجغرافيا، نزيفاً لا يتوقف بين ما كان وما صار. ارتجفت خطواتي، كأن الأرض نفسها تشكّ في انتمائي، وكأن التراب يسائلني بمرارة: أأنت الذي هرب أم الذي صمد؟ رفعتُ بصري فرأيتُ وجوهاً متعبة، جامدة، ترتدي أقنعة مصقولة بعناية؛ أقنعة تخفي الخوف، وتدربت طويلاً على الابتسام بلا روح. لم أجد ملامح الذين عرفتهم، بل ظلالهم؛ نسخاً شاحبة أرهقها الزمن حتى أعاد تشكيلها، كما يعيد النهر نحت الحجارة: بلا ملامح، بلا صوت.
مررتُ بحلب، مدينةِ أبي فراس الحمداني، تلك التي كانت يوماً نبض صدري، فإذا بها جسدٌ بلا ذاكرة. شوارعها لم تعد تعرف وقع قدميّ، والجدران التي حفظت أسرارنا آثرت الصمت، والنوافذ التي كانت تفيض حياة تحولت إلى عيونٍ مطفأة تحدّق في العدم. حتى الحجر تغيّر؛ لم يعد حجراً دافئاً يعرف حرارة الأكفّ ولا ثِقل الذكريات، بل صار شاهداً بارداً على ما فرض على المكان أن ينساه. كنتُ أمشي فيها كمن يتجول داخل ذاكرةٍ ممزّقة، أبحث عن نفسي بين الزوايا، فلا أجد سوى الفراغ.
ثم أكملتُ رحلتي نحو مدينة الرافقة، مدينة شبابي وعشقي الأول، ومنها عبرتُ الصحارى؛ تلك المسافات العارية التي كانت يوماً معابرَ للأحلام. بدت الصحراء أطول من قدرتي على الاحتمال، كأنها تمدّ جسدها الهائل بيني وبين ما تبقى مني. الريح لم تعد تغني كما كانت، بل تعوي؛ تحمل غبار السنوات الضائعة، وتجلد وجهي بأسئلةٍ لا إجابة لها. هناك، في قلب الفراغ الممتد، فهمتُ أن الغياب لا يقاس بعدد السنين، بل بمقدار ما يتآكل في الروح بصمت.
وحين وصلتُ إلى قريتي، توقفتُ طويلاً عند عتبتها، خائفاً من لحظة اللقاء. خشيتُ أن أخونها بنظرةٍ واحدة، أو أن تخونني ببرودها. دخلتها أخيراً، فبدت لي كامرأةٍ هرمت فجأة، لم تعد تتعرّف على أبنائها. البيوت انحنت كظهورٍ متعبة، الأبواب تغيرت، الأشجار التي كبرتُ في ظلها شاخت أو غابت، وحتى زقزقة العصافير لم تعد تلك التي كانت توقظ طفولتي؛ صارت خافتة، مرتجفة، كأن الطيور نفسها تعلّمت الخوف.
كل شيء تغيّر، حتى الهواء. كنتُ أتنفس بحذر، كأن أنفاسي دخيلة على المكان. الوجوه التي التقيتها لم تكن وجوهاً، بل أقنعة متقنة؛ تضحك حين يسمح لها بالضحك، وتصمت حين يفرض الصمت. لم أعرف إن كانوا يعرفونني، أم أنهم نسوا حتى أسماءهم. شعرتُ أن الوطن لم يعد بيتاً، بل مسرحاً كبيراً يؤدي فيه الجميع أدواراً كتبت لهم، من دون أن يسمح لهم بقراءتها.
وقفتُ في قلب قريتي، ووقفتُ في قلب الحقيقة: لم أعد ذلك الذي رحل، ولم يعد الوطن ذاك الذي انتظرته. بيننا مسافةٌ خفية، صنعتها الخيبات، والخوف، وسنواتٌ مرّت من دون أن تمرّ حقاً. ومع ذلك، ظلّ في القلب شيءٌ يقاوم الانهيار؛ حبٌّ عنيد يرفض الموت، وإيمانٌ هشّ بأن الوطن، مهما تغيّر، يظل وجعاً مقدساً، وجرحاً مفتوحاً، وحنيناً لا يتعلم كيف يموت.


