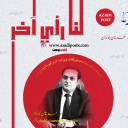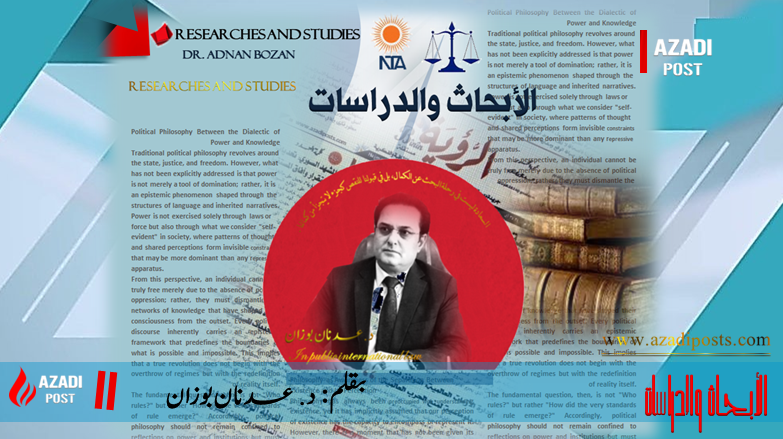 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
المقدمة:
منذ أقدم العصور، ظلّ السؤال عن وجود الكورد ودولتهم سؤالاً متجدداً في النقاشات التاريخية والسياسية، بل وأحد أكثر الأسئلة التي رافقت الجدل حول الشعوب الأصيلة في الشرق الأدنى. فكثيرون يتساءلون: هل كان للكورد في يوم من الأيام دولة تحمل اسم "كوردستان" بهذا اللفظ وهذه الصياغة؟ وهل يمكننا، في ضوء الشواهد التاريخية والآثارية والأنثروبولوجية، الحديث عن كيان سياسي كوردي قديم تشكّل في جغرافيا ميزوبوتاميا العليا والأناضول وزاغروس وإيران الكبرى؟ أم أن المسألة لا تتجاوز حدود "شعبٍ بلا دولة" كما يحلو للبعض أن يصفها؟
إن الإجابة عن هذه الإشكالية المعقدة لا تكمن في الاسم أو في الصياغة الاصطلاحية وحدها، وإنما في الجوهر التاريخي والجغرافي. فالتاريخ البشري لم يعرف أسماء ثابتة للدول والكيانات السياسية، بل إن الأسماء كانت تتغير بتغير الملوك والأسر الحاكمة وبانتقال القوة من سلالة إلى أخرى. السعودية التي نعرفها اليوم لم تكن بهذا الاسم قبل قرن من الزمن، بل كانت تعرف بالحجاز أو جزيرة العرب، والعراق لم يُعرف باسمه الحديث إلا في العصر الإسلامي، إذ كانت أرضه تُسمى سومر وأكد وبابل وآشور وميزوبوتاميا. وكذلك الحال بالنسبة للكويت وقطر وسوريا وتركيا وإيران. ومع ذلك، لا أحد ينكر الوجود التاريخي للشعوب العربية أو الفارسية أو التركية على أراضيها التاريخية. فلماذا يُراد للكورد وحدهم أن يسلبوا هذا الحق الطبيعي، بحجة أن اسم "كوردستان" لم يكن مدوّناً في خرائط الماضي كما هو اليوم؟
إن الكورد ليسوا شعباً طارئاً على الجغرافيا، بل هم من الشعوب الأصيلة التي ساهمت في صياغة تاريخ المنطقة منذ فجر الحضارة. فمنذ آلاف السنين، عرفت بلاد ما بين النهرين وشمال ميزوبوتاميا وشرق الأناضول أقواماً ارتبطت بالكورد المعاصرين، مثل السوباريين واللولبيين والكاشيين والحوريين والميتانيين والميديين. وقد أقام هؤلاء إمبراطوريات وممالك كان لها دور بارز في تشكيل المشهد السياسي والثقافي والحضاري للشرق الأدنى القديم. وفي كتابات المؤرخين الإغريق والرومان، تتردد أسماء مثل الكاردوخ والكاردوين والكاردو، وكلها تشير إلى أقوام كوردية كانت تستوطن الجبال والسهول الممتدة بين دجلة والفرات.
وإذا كان مصطلح "كوردستان" كاسم جغرافي وسياسي قد وُثق لأول مرة في عهد السلطان السلجوقي سنجر في القرن الثاني عشر الميلادي، فإن ذلك لا يعني أن الكورد لم تكن لهم قبل ذلك إمارات ودول وكيانات. فقد استمرت تسمية "كوردستان" متداولة في المصادر العثمانية والصفوية وصولاً إلى بدايات القرن العشرين، لتدل على أرض واسعة يسكنها الكورد، تتوزع اليوم بين العراق وتركيا وسوريا وإيران. بل إن الخرائط الأوروبية منذ القرن السادس عشر، مثل خرائط الرحالة والجغرافيين الإيطاليين والفرنسيين، كانت تظهر كوردستان كمنطقة قائمة بذاتها، وإن لم تكن دولة موحدة بالمعنى الحديث.
وعبر العصور الإسلامية، تمكن الكورد من إقامة عشرات الإمارات والدويلات التي تمتعت باستقلال داخلي وصلاحيات سياسية واسعة. فمن الإمارة الأردلانية إلى إمارة سوران وبوتان وبابان وهكاري وبهدينان وبدليس، وصولاً إلى إمارات أصغر مثل شوانكاره والمحمودية وغيرهما، كانت تلك الكيانات الكوردية أشبه بدول مصغرة، لها جيوشها ونظمها وقوانينها، وكانت تدار من قبل أمراء كورد يعترفون شكلياً بسلطة الدول الكبرى كالعثمانية أو الصفوية، لكنهم حافظوا على استقلال فعلي في إدارة شؤونهم الداخلية. ولعل أبرز الكيانات الكوردية على الإطلاق كانت الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي، التي امتدت من مصر إلى الشام والحجاز، وأعادت رسم الخريطة السياسية للعالم الإسلامي.
وهكذا يتضح أن القضية ليست قضية أسماء بل قضية وجود. فإذا لم يكن هناك كيان في الماضي اسمه "كوردستان" باللفظ ذاته، فإن ذلك لا ينفي وجود دول وإمارات وممالك كوردية بأسماء أخرى. وإذا لم يظهر اسم "كوردستان" إلا في القرن الثاني عشر، فهذا لا يعني أن الكورد لم يعيشوا على أرضهم قبل ذلك، تماماً كما أن اسم "العراق" لم يظهر إلا في العصور الإسلامية، ومع ذلك لا يشك أحد في عراقة هذه الأرض وحضارتها.
إن كوردستان، بجبالها الشاهقة وسهولها الخصبة وأنهارها الجارية، لم تكن مجرد جغرافيا محايدة، بل كانت بوتقة حضارية شكلت مسرحاً لتاريخ طويل ومعقد. ومنذ الألواح السومرية التي أشارت إلى كيانات سياسية في جبل سنجار، مروراً بالممالك الميدية التي أسقطت الإمبراطورية الآشورية، وصولاً إلى الإمارات الكوردية في العصور الإسلامية، ظل الكورد موجودين كشعب أصيل، يكتب تاريخه بأسماء مختلفة، لكنه يظل هو ذاته الشعب الذي حافظ على لغته وثقافته وعاداته، رغم تقلب العصور وضغوط الإمبراطوريات الكبرى.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: "هل كان للكورد دولة تحمل اسم كوردستان؟"، بل: كيف استطاع الكورد، رغم التمزق السياسي، أن يحافظوا على وجودهم عبر آلاف السنين، وأن يبقوا شعباً حياً يطالب اليوم بحقه في دولةٍ تعبر عن هويته على أرضه التاريخية؟.
إنّ كوردستان، في جوهرها، ليست مجرد تسمية جغرافية أو مطلب سياسي آني، بل هي تعبير عن تراكم تاريخي طويل لشعبٍ عاش على أرضه، وأسهم في صنع حضارة المنطقة، وتوزعت دوله وإماراته بين أسماء متعددة كما توزعت خرائطها بين سلطات كبرى. ومن هنا، فإن النظر إلى كوردستان في مرآة التاريخ يكشف لنا أن القضية الكوردية ليست بدعة من عصرنا الحديث، وإنما امتدادٌ طبيعي لمسيرة أمةٍ حافظت على وجودها، وتنتظر أن يتحقق لها ما تحقق لغيرها من شعوب المنطقة: أن تتحول جغرافيتها التاريخية إلى دولةٍ معاصرة تحمل اسمها وهويتها.
أولاً: الكورد في أقدم العصور
يعد الكورد من أقدم الشعوب التي استوطنت مناطق الهلال الخصيب، ولا سيما شمال بلاد ما بين النهرين، ومرتفعات زاغروس، وشرق الأناضول. وتشير المصادر المسمارية والآثارية منذ الألف الثالث قبل الميلاد إلى حضور شعوبٍ وجماعات يجمع الباحثون على صلتها بالكورد المعاصرين، سواء من حيث الجغرافيا أو الخصائص الثقافية أو الامتداد التاريخي.
لقد عرفت المنطقة عدداً من الكيانات والشعوب التي برزت أسماؤها في النصوص القديمة:
1- السوباريون (Subarians):
ظهر السوباريون في شمال ميزوبوتاميا منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وكانوا من الشعوب الجبلية التي امتدت مواطنها في المناطق التي تشكل اليوم شمال العراق وجنوب شرق تركيا. ذكرتهم النصوص السومرية والأكادية باعتبارهم قوة عسكرية وحضارية مؤثرة، إذ كانوا على احتكاك دائم بالسومريين والآشوريين. يرى بعض المؤرخين أن السوباريين أسّسوا اللبنات الأولى للهوية الجبلية الكوردية، حيث تميّزوا بالاستقرار في المرتفعات، والاعتماد على الزراعة والرعي، مع نزعة استقلالية واضحة تجاه الإمبراطوريات الكبرى في السهول.
2- اللولبيون (Lullubi):
برزوا في جبال زاغروس الشرقية، وخلّدوا وجودهم من خلال النقوش الملكية في العصر الأكادي. أشهر تلك النقوش هي لوحة النصر للملك الأكادي نارام سين (حوالي 2250 ق.م)، التي تظهر انتصاره على اللولبيين. ورغم تصويرهم في النصوص الأكادية كأعداء متمرّدين، إلا أن وجودهم المتجذر في الجبال جعلهم من أبرز أسلاف الكورد. كانوا محاربين أشداء، يشنون هجمات على السهول، ويدافعون بضراوة عن استقلالهم، مما يعكس البنية السياسية – القبلية التي استمرت لاحقاً في المجتمع الكوردي.
3- الكاشيون (Kassites):
في الألف الثاني قبل الميلاد، ظهر الكاشيون في جبال زاغروس، ثم نزلوا إلى وادي الرافدين ليستولوا على الحكم في بابل بعد سقوط الدولة الحثية. حكم الكاشيون بابل لأكثر من أربعة قرون (حوالي 1595 – 1155 ق.م)، وهو أطول عهد استقرار سياسي شهدته بابل. هذا الإنجاز يدل على قدرتهم على الانتقال من حياة الجبال إلى حكم المدن الكبرى، ما يعكس مرونة سياسية وتنظيمية. وقد اعتبر كثير من الباحثين الكاشيين من المكونات الأساسية التي انبثقت منها الهوية الكوردية التاريخية.
4- الحوريون (Hurrians):
لعب الحوريون دوراً محورياً في شمال ميزوبوتاميا، حيث أسسوا ممالك متقدمة امتدت من نهر الخابور في سوريا إلى بحيرة وان في تركيا. ازدهروا في الألف الثاني قبل الميلاد، وأسّسوا حضارة غنية، وشاركوا في بناء مملكة ميتاني لاحقاً. أثرهم الثقافي كان كبيراً، إذ ساهموا في نقل تقاليد موسيقية ودينية وقانونية إلى المنطقة، وربط بعض المؤرخين تراثهم بالثقافة الكوردية اللاحقة.
5- الميتانيون (Mitanni):
يعدّون من أبرز الكيانات الكوردية – الحورية التي ظهرت في شمال ميزوبوتاميا وبلاد الشام في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. أسسوا مملكة قوية اتخذت من واشوكاني (قرب رأس العين الحالية) عاصمة لها، وامتد نفوذها إلى حلب وبلاد الشام الداخلية. دخل الميتانيون في صراعات طويلة مع الحثيين والآشوريين والمصريين، ما جعلهم رقماً صعباً في معادلة الشرق الأدنى القديم. وقد اشتهروا بنظامهم العسكري المتطور، خاصة في استخدام الخيول والعربات الحربية، وهو إرث ظل ماثلاً في التقاليد الكوردية لاحقاً.
6- الميديون (Medes):
يشكّل الميديون الذروة الأولى في التاريخ الكوردي القديم، إذ أقاموا إمبراطورية كبرى في القرن السابع قبل الميلاد، امتدت من الهضبة الإيرانية إلى آشور والأناضول. تحالفوا مع البابليين وأسقطوا الإمبراطورية الآشورية عام 612 ق.م، مما عدّ نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة. يراهم المؤرخون أوضح كيان سياسي كوردي قديم، نظراً إلى قيامهم ببناء دولة مركزية لها مؤسسات ونظام ملكي، وقدرتهم على فرض سيطرة إقليمية واسعة.
- تسميات تاريخية مرتبطة بالكورد
إلى جانب هذه الشعوب، ترد في كتابات المؤرخين اليونان والرومان تسميات مثل كاردوخ وكاردو وكاردوين. فقد أشار المؤرخ الإغريقي زينوفون (401 ق.م) في كتابه الأناباسيس إلى "الكاردوخيين" الذين واجهوا جيش المرتزقة الإغريق أثناء عودته من بابل عبر جبال زاغروس. وصفهم بأنهم مقاتلون أشداء يملكون تضاريس صعبة، ويشنّون هجمات مباغتة على خصومهم. هذا الوصف ينطبق تماماً على الصورة التي رُسمت للكورد في العصور اللاحقة: شعب جبلي، محارب، صعب الإخضاع.
- دلالة هذه الشواهد
إن تتابع هذه الأسماء – السوباريون، اللولبيون، الكاشيون، الحوريون، الميتانيون، الميديون، والكاردوخ – ليس مجرد ذكر عابر في النصوص القديمة، بل هو سلسلة متصلة من الشعوب التي عاشت في نفس الرقعة الجغرافية التي تعرف اليوم باسم كوردستان. هذه الاستمرارية الجغرافية والثقافية تشير إلى أن الكورد المعاصرين هم الامتداد الطبيعي لهذه الأقوام، وأن كوردستان لم تكن يوماً أرضاً فارغة، بل موطناً لشعبٍ قديم ساهم في صنع حضارة بلاد الرافدين والشرق الأدنى.
ثانياً: الجغرافيا الكوردية – كوردستان
إنّ الحديث عن "كوردستان" لا يمكن اختزاله في كونه استحضاراً لتسمية جغرافية ظهرت في العصور الوسطى أو ترددت في الوثائق الإدارية للدول الإسلامية الكبرى، بل هو في جوهره تأكيد على امتداد تاريخي عريق ارتبط منذ فجر الحضارات بوجود الكورد كشعبٍ أصيل، متجذّر في قلب المشرق. فهذه الرقعة من الأرض التي عرفت لاحقاً باسم كوردستان، لم تكن يوماً فضاءً فارغاً ينتظر هوية تمنح له، بل كانت موطناً مستمراً لشعوبٍ حملت ملامح الكورد وسماتهم، وأسهمت في صياغة التاريخ السياسي والثقافي لبلاد ما بين النهرين والأناضول والهضبة الإيرانية.
لقد كان الاسم الذي شاع في العصور الإسلامية الوسطى، حين أطلق السلطان السلجوقي سنجر في القرن الثاني عشر على ولاية كاملة اسم "كوردستان"، تتويجاً طبيعياً لإرثٍ متواصل من الاستقرار البشري الكوردي في هذه الجبال والسهول. فالجغرافيا هنا ليست مجرد تضاريس، بل وعاء للهوية، ومسرح لتفاعل القبائل والمجتمعات الكوردية التي استطاعت عبر قرون طويلة أن تحافظ على وجودها رغم التحديات التي فرضتها الإمبراطوريات المتعاقبة. إنّ خصوصية هذه الجغرافيا تكمن في كونها حلقة الوصل بين أكبر ثلاث كتل حضارية في التاريخ القديم: بلاد الرافدين، والأناضول، وإيران الكبرى، وهو ما جعلها على الدوام موضع تنافس القوى الكبرى ومصدراً لصراعات مستمرة، لكنها في الوقت نفسه ظلت أرضاً محتفظة بفرادة ثقافية تعكس أصالة سكانها.
ولعلّ تتبّع ذكر كوردستان في كتب الجغرافيين المسلمين مثل المقدسي والإصطخري وياقوت الحموي، يوضح أن هذا الاسم لم يكن وليد لحظة سياسية عابرة، بل توصيفاً لواقع اجتماعي – جغرافي قائم. فقد أشار هؤلاء الجغرافيون بدقة إلى جبال وأقاليم الكورد، وميّزوها عن غيرها من مناطق العراق أو فارس، معتبرين أنها موطن لشعبٍ ذي خصائص متميزة. هذا الاعتراف العلمي – الجغرافي يؤكد أن الكورد كانوا ينظر إليهم في الوعي التاريخي الإسلامي كجماعة قائمة بذاتها، ذات أرض محددة وهوية راسخة.
ومن هنا، فإن كوردستان ليست مجرد رسم حدودٍ على الخريطة أو تسمية إدارية ترددت في الوثائق، بل هي امتداد طبيعي لشعبٍ ارتبط وجوده بجغرافيا محددة منذ آلاف السنين. إنّ هذه الأرض بما تحمله من جبال زاغروس وطوروس، ومن أنهار وينابيع ووديان خصبة، لم تكن مجرد خلفية طبيعية لحياة الكورد، بل كانت أحد أهم عناصر تكوين هويتهم، وركيزةً أساسية في صمودهم أمام محاولات الطمس والتذويب. ولهذا فإن الحديث عن كوردستان في بعدها التاريخي والجغرافي، هو في الحقيقة حديث عن استمرارية شعبٍ نجح في أن يجعل من أرضه مرآة لهويته، ومن جغرافيته حصناً يحمي ذاكرته، ومن اسمه عنواناً يتجاوز القرون ليبقى حاضراً حتى يومنا هذا.
- أول ظهور لمصطلح "كوردستان"
يجمع المؤرخون على أنّ أوّل ذكر رسمي لمصطلح "كوردستان" كان في عهد السلطان السلجوقي سنجر في القرن الثاني عشر الميلادي (حوالي 1150م)، حين خصّص ولاية بهذا الاسم لتكون وحدة إدارية ضمن دولته. لم يكن هذا الاصطلاح اعتباطياً، بل كان اعترافاً ضمنياً من السلطة السياسية آنذاك بأن هذه المنطقة لها خصوصية قومية وجغرافية مرتبطة بالكورد. ومنذ ذلك الحين، بات المصطلح يتكرّر في المدونات التاريخية والوثائق الرسمية، سواء لدى السلاجقة أو في العهود اللاحقة.
- استمرار المصطلح عبر العصور
خلال الحقبة العثمانية – الصفوية، ظلّ اسم "كوردستان" يستخدم لوصف المناطق الجبلية المأهولة بالكورد. ففي الوثائق العثمانية، كانت تذكر "إيالة كوردستان" باعتبارها وحدة إدارية، كما كانت سجلات الدولة الصفوية تشير إلى "بلاد الكورد" أو "ولايات الكورد". بل إنّ هذا الاسم بقي شائعاً في المخطوطات والخرائط حتى بدايات القرن العشرين، أي قبل تقسيم المنطقة بين الدول القومية الحديثة. وهذا يبيّن أنّ كوردستان ليست مصطلحاً أيديولوجياً حديثاً، بل حقيقة سياسية – جغرافية متداولة منذ قرون طويلة.
- كوردستان في الجغرافيا الإسلامية
لم تغفل مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين المسلمين عن خصوصية الجغرافيا الكوردية. فقد أشار المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم إلى الأقاليم الجبلية التي يسكنها الكورد، واعتبرها منطقة ذات خصائص عمرانية واجتماعية مستقلة. وذكر الإصطخري في المسالك والممالك تضاريس زاغروس والجبال المحيطة بديار الكورد باعتبارها موطناً متميزاً عن غيره من أقاليم العراق أو فارس. أما ياقوت الحموي في معجم البلدان، فقد خصّص إشارات متكررة إلى "بلاد الأكراد" وجبالهم، مؤكداً حضورهم كجماعة قائمة بذاتها في جغرافيا الشرق الإسلامي. هذه الشهادات تعزز الرؤية القائلة بأن كوردستان لم تكن أرضاً مجهولة أو بلا هوية، بل كانت معروفة وموصوفة بدقة في التراث الجغرافي الإسلامي.
- الامتداد الجغرافي
جغرافياً، تمتد كوردستان على مساحة واسعة تقطعها سلاسل جبال زاغروس وطوروس، وهي تشكّل ما يشبه "الهلال الجبلي" الذي يطوّق شمال بلاد الرافدين. هذا الامتداد يشمل اليوم:
- جنوب شرق تركيا: حيث جبال وان ودياربكر وأرضروم.
- شمال العراق: من كركوك وأربيل والسليمانية حتى دهوك والموصل.
- غرب إيران: من كرمنشاه وسنندج ومهاباد حتى أرومية.
- شمال شرق سوريا: في مناطق الجزيرة الفراتية كوباني وقامشلي ورأس العين وديريك وعفرين.
هذا الامتداد لم يكن يوماً حدودياً بالمعنى الحديث، بل كان فضاءً بشرياً – ثقافياً متواصلاً، تشترك مدنه وقراه بلغات ولهجات وأعراف متقاربة، مما شكّل نسيجاً واحداً يميز "أرض الكورد" عن غيرها.
- الخصائص الطبيعية ودورها في تكوين الهوية
الطبيعة الجبلية الوعرة لكوردستان لم تكن مجرد خلفية جغرافية، بل كانت عاملاً أساسياً في صياغة الشخصية الكوردية. فهذه الجبال منحت الكورد حصانة طبيعية مكّنتهم من الحفاظ على استقلاليتهم في مواجهة القوى الكبرى كالإمبراطوريات الآشورية والفارسية والعثمانية. كما أن وفرة المياه والأنهار الصغيرة – مثل الزاب الكبير والزاب الصغير ونهر سيروان – جعلت المنطقة غنية زراعياً، الأمر الذي وفّر للكورد مقومات الاستقرار منذ آلاف السنين.
- كوردستان بين الاستمرارية والانقسام
ورغم أنّ كوردستان كانت على الدوام إقليماً متماسكاً جغرافياً وسكانياً، فإنّ القوى الإقليمية الكبرى لم تسمح بقيام دولة قومية موحدة للكورد، بل قسّمت هذه الجغرافيا بين ولايات وإيالات وإمارات متعددة. ومع دخول القرن العشرين وصعود الدولة القومية الحديثة في الشرق الأوسط، قُسمت كوردستان نهائياً بين أربع دول (تركيا، إيران، العراق، سوريا) بموجب اتفاقيات دولية مثل سايكس – بيكو (1916) ومعاهدة سيفر (1920) التي نصّت نظرياً على حق تقرير المصير للكورد، قبل أن تلغى بموجب معاهدة لوزان (1923).
خلاصة:
إذن، كوردستان ليست مجرد مصطلح حديث نشأ بدافع سياسي، بل هي توصيف تاريخي – جغرافي عميق، ورد في المدونات الإسلامية والوثائق العثمانية والصفوية، واستند إلى واقع جغرافي وبشري ثابت منذ آلاف السنين. هذه الجغرافيا لم تكن يوماً بلا سكان، بل كانت الموطن الطبيعي للكورد، الذين شكّلوا عبر العصور ممالك وإمارات متعاقبة حافظت على خصوصية الأرض والإنسان، رغم التحولات السياسية التي سعت لتجزئتها أو طمس هويتها.
وبناءً على ما تقدّم، يمكن القول إنّ كوردستان لم تكن وليدة خيال سياسي حديث، ولا اختراعاً طارئاً على خرائط القرن العشرين، بل هي حصيلة تراكم تاريخي طويل يعكس علاقة الكورد العضوية بأرضهم. إنّ تبدّل الأسماء بين العصور – من سوباريين وكاشيين وميتانيين وميديين وصولاً إلى "كوردستان" – لم يُلغِ حقيقة الاستمرارية، بل أكد أن الهويات والشعوب قد تتغير تسمياتها وفقاً للظروف السياسية، لكن الجغرافيا المأهولة والذاكرة الجمعية تبقى ثابتة. ومن هنا فإن كوردستان تمثل، في جوهرها، نموذجاً لشعبٍ عرف كيف يحافظ على وجوده في قلب العواصف التاريخية، وكيف حوّل جباله إلى حصون، وأرضه إلى هوية، واسمه إلى امتداد حضاري عابر للزمن.
ثالثاً: الإمارات والدول الكوردية في العصر الإسلامي
إنّ دخول كوردستان إلى العصر الإسلامي بعد الفتح العربي لبلاد الرافدين وفارس والشام في القرن السابع الميلادي لم يكن مجرد انتقالٍ إداري أو تبعية سياسية جديدة، بل كان منعطفاً تاريخياً أعاد تشكيل موقع الكورد ودورهم في الخارطة الإقليمية. فمنذ اللحظة الأولى لانخراطهم في الأحداث الإسلامية، برز الكورد كقوة بشرية وعسكرية مهمة، إذ شارك الكثير منهم في الفتوحات الكبرى، وأسهموا في تثبيت دعائم الدولة الإسلامية الناشئة، سواء في الجيوش أو في الإدارة. غير أنّ الأهم من مشاركتهم العسكرية هو حفاظهم على خصوصيتهم الجغرافية والاجتماعية، حيث ظلّت جبالهم وديارهم حصناً طبيعياً مكّنهم من الاحتفاظ باستقلالية نسبية، حتى في أوقات سيطرة الدول المركزية الكبرى كالأمويين والعباسيين.
لقد جعل الموقع الجغرافي الفريد لكوردستان – الممتد بين بغداد ودمشق من جهة، والهضبة الإيرانية والأناضول والقوقاز من جهة أخرى – من هذه الأرض نقطة تماس وصراع بين القوى الكبرى في العالم الإسلامي. فهي تقع في قلب طرق المواصلات التجارية والعسكرية، وتشكّل حلقة الوصل بين المشرق العربي والأناضول والقوقاز، ما منح الكورد دوراً محورياً لا يمكن تجاوزه. هذا الموقع الحساس جعلهم في كثير من الأحيان عرضة لغزوات وضغوط القوى الإقليمية، لكنه في الوقت نفسه منحهم فرصة لبناء إمارات ودول محلية استطاعت أن توازن بين الولاء الاسمي للخلافة أو للدول الكبرى، وبين الحفاظ على استقلالها الداخلي وكيانها السياسي.
ومع تعاقب العصور الإسلامية الوسطى، برزت الإمارات والدول الكوردية بوصفها نماذج حقيقية لفاعلية الكورد في السياسة الإقليمية. فقد أسسوا إمارات تمتعت بصلاحيات واسعة، من إدارة الضرائب والقضاء إلى ضرب النقود وتشكيل الجيوش المحلية، وهي صلاحيات لا تقل في جوهرها عمّا نراه اليوم في بعض الأنظمة الفيدرالية الحديثة. وفي حالات أخرى، تمكن الكورد من إقامة دول كبرى تجاوزت حدود كوردستان، مثل الدولة المروانية والشدادية والحسنوية، وصولاً إلى الدولة الأيوبية التي أسسها صلاح الدين الأيوبي، والتي تحولت إلى واحدة من أعظم القوى الإسلامية في العصور الوسطى.
إنّ تتبع مسار هذه الإمارات والدول يوضح أن الكورد لم يكونوا مجرد عنصر عسكري مكمّل داخل جيوش الخلافة أو وسيلة لحماية الحدود، بل كانوا أصحاب مشروع سياسي متكرر، يسعى لتثبيت الكيان الكوردي ضمن إطار العالم الإسلامي، وفق الظروف والمتغيرات التي فرضها كل عصر. لقد شكّلت هذه الكيانات الكوردية ركيزة أساسية في التاريخ الإسلامي الوسيط، وأظهرت كيف أن الكورد نجحوا في الجمع بين الحفاظ على هويتهم الخاصة من جهة، والمشاركة الفاعلة في صناعة الأحداث الكبرى للأمة الإسلامية من جهة أخرى.
- الإمارات الكوردية المحلية
منذ القرن الثامن الميلادي، أخذت القبائل الكوردية تشكل إمارات محلية حافظت على استقلالها الذاتي، مع ولاء اسمي للخلافة العباسية أو القوى الكبرى. ومن أبرز هذه الإمارات:
- الإمارة الأردلانية: تعد من أعرق الإمارات الكوردية وأكثرها استمرارية، فقد تأسست في القرن الرابع عشر في مناطق كوردستان الشرقية (إيران الحالية)، واستمرت حتى القرن التاسع عشر. امتازت الأردلانية بقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية، وإقامة علاقات متوازنة مع كل من الصفويين والعثمانيين، وهو ما منحها مكانة مميزة في تاريخ الكورد.
- إمارة سوران: نشأت في منطقة رواندوز شمالي العراق خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وبلغت ذروة قوتها في عهد الأمير محمد كور (محمد باشا الراوندوزي) الذي حاول توحيد الإمارات الكوردية تحت رايته، وواجه القوى العثمانية والفارسية. لقد مثّلت سوران مشروعاً سياسياً كوردياً طموحاً نحو الوحدة قبل العصر الحديث.
- إمارة بوتان: التي عُرفت بدورها الريادي في النهضة الثقافية الكوردية في القرن التاسع عشر، خاصة في عهد الأمير بدرخان بك (1802–1868)، الذي قاد ثورة كوردية بارزة ضد الدولة العثمانية. امتازت بوتان بكونها مركزاً للصحافة والأدب الكوردي، إذ أصدر فيها أول صحيفة كوردية "كردستان" عام 1898 في القاهرة بدعم من بدرخان.
- إمارة بابان: التي تأسست في السليمانية، وتعد من أهم الإمارات الكوردية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. لعبت بابان دوراً محورياً في الحياة السياسية والثقافية، وأسست مدينة السليمانية كمركز حضاري وثقافي لا يزال قائماً حتى اليوم.
- إمارة بدليس وهكاري وبهدينان: وهي إمارات سيطرت على مناطق استراتيجية من كوردستان، وامتازت بقدرتها على الحفاظ على توازن القوى بين العثمانيين والصفويين. وغالباً ما كان أمراؤها يتمتعون بسلطة واسعة تضاهي ما نطلق عليه اليوم صلاحيات الفيدراليات الحديثة.
وإلى جانب هذه الإمارات، برزت عشرات الكيانات الأخرى مثل إمارة شوانكاره، إمارة الهذبانيين، إمارة المحمودي، إمارة هذبانيون، وإمارة صديقيون وغيرها، التي انتشرت على امتداد جبال زاغروس والأناضول الشرقي وشمالي العراق.
- الدول الكوردية الكبرى
لم يقتصر الوجود الكوردي على إمارات محلية، بل شهد العصر الإسلامي بروز دول كوردية كبرى كان لها دور إقليمي واسع التأثير:
- الدولة المروانية (990–1085م): قامت في ديار بكر والجزيرة الفراتية، وامتازت بقدرتها على بسط نفوذها في منطقة استراتيجية بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية. وكانت المروانية إحدى أوائل التجارب الكوردية في إقامة دولة متكاملة المؤسسات.
- الدولة الحسنوية (959–1015م): تأسست في مناطق زاغروس على يد حسنويه بن حسين الكوردي. وقد امتدت سلطتها على مساحات واسعة في غرب إيران والعراق الشرقي، ولعبت دوراً أساسياً في موازنة القوى بين العباسيين والبويهيين.
- الدولة الشدادية (951–1199م): ظهرت في القوقاز وأرمينيا، وكان أمراؤها الكورد قادرين على إدارة مناطق شاسعة تمتد من أران إلى تبريز. وتميزت الشدادية بقدرتها على الصمود أمام البيزنطيين والسلاجقة، وهو ما جعلها رقماً صعباً في تاريخ القوقاز الوسيط.
- الدولة الأيوبية (1171–1250م): التي أسسها البطل الكوردي صلاح الدين الأيوبي بعد أن أنهى حكم الفاطميين في مصر، وأقام واحدة من أعظم الدول الإسلامية في العصور الوسطى. امتدت الدولة الأيوبية من مصر إلى الشام والحجاز واليمن وشمالي العراق، وكان نصر صلاح الدين في معركة حطين عام 1187م واستعادة القدس من أبرز لحظات التاريخ الإسلامي. لقد جسدت الدولة الأيوبية أرقى أشكال الحضور الكوردي في التاريخ الإسلامي، حيث تحولت إلى قوة عظمى مؤثرة في مجريات الصراع بين المسلمين والصليبيين.
- الخصائص العامة للإمارات والدول الكوردية
أظهرت الإمارات والدول الكوردية في العصر الإسلامي مجموعة من الخصائص المميزة:
- الاستقلال السياسي والإداري: حيث تمتعت معظم الإمارات بصلاحيات داخلية واسعة، وصلت في بعض الحالات إلى ضرب السكة (سك العملات) وإدارة الضرائب والقضاء.
- الموقع الاستراتيجي: إذ مثّلت الجبال الكوردية حاجزاً طبيعياً بين القوى الكبرى، مما منح أمراء الكورد دور الوسيط أو اللاعب الإقليمي.
- الحفاظ على الهوية: على الرغم من الضغوط العثمانية والصفوية والعربية، حافظت الإمارات الكوردية على اللغة والثقافة الكوردية، بل وأسهمت في تطوير الأدب والشعر الكوردي.
- التوازن بين الولاء والتمرّد: فقد ظلّت الإمارات الكوردية في ولاء اسمي للدول الكبرى (الخلافة، العثمانيين، الصفويين)، لكنها كثيراً ما تمرّدت للحفاظ على استقلالها الذاتي.
- إنّ مجمل هذه الإمارات والدول يوضح أن الكورد في العصور الإسلامية لم يكونوا شعباً هامشياً أو مجرد مقاتلين في جيوش الآخرين، بل كانوا أصحاب مشروع سياسي متجدد، يسعى لتثبيت الكيان الكوردي وفق معطيات كل عصر. ومن هنا، فإن الحديث عن "كوردستان" كأرض وهوية ودولة ليس مجرد إسقاط حديث، بل امتداد طبيعي لتجارب تاريخية متواصلة منذ الفتح الإسلامي حتى بدايات العصر الحديث.
رابعاً: مسألة التسمية والدولة الحديثة
إنّ النقاش الدائر حول وجود أو عدم وجود "دولة كوردية" في التاريخ يرتكز غالباً على التسمية، أي: هل وجدت دولة اسمها "كوردستان" بالمعنى الحرفي والمعاصر؟ وهذا السؤال في حد ذاته يعكس قصوراً منهجياً في قراءة التاريخ، إذ يغفل حقيقة أساسية وهي أن معظم دول المنطقة – بل والعالم – لم تكن موجودة بأسمائها الحالية، وإنما حملت أسماء مختلفة على مرّ العصور، كانت تتغير تبعاً للأسر الحاكمة أو للظروف السياسية والإدارية.
فالاسم في التاريخ ليس إلا انعكاساً ظرفياً لقوةٍ سياسية أو سلالة حاكمة، في حين أن الجغرافيا والشعوب هي التي تُمثل الاستمرارية العميقة. ولهذا فإن عدم العثور على دولة في التاريخ تحمل اسم "كوردستان" لا يعني بحالٍ من الأحوال أنّ الكورد لم يقيموا دولاً أو كيانات سياسية، كما لا ينفي حقهم في إقامة دولة حديثة باسم "كوردستان" على أرضهم التاريخية.
- السعودية كنموذج:
المملكة العربية السعودية لم تكن موجودة بهذا الاسم قبل القرن العشرين. فقد عُرفت المنطقة تاريخياً بأسماء متعددة مثل بلاد الحجاز وجزيرة العرب وعربستان (كما سماها العثمانيون في بعض وثائقهم). ولم يظهر اسم "السعودية" إلا حين قامت أسرة آل سعود بتوحيد مناطق نجد والحجاز والأحساء في دولة حديثة حملت اسمها. هل هذا يعني أنّ العرب لم تكن لهم أرض أو هوية قبل ظهور اسم السعودية؟ بالطبع لا. بل إن الاسم كان نتيجة ظرف سياسي جديد، دون أن يُنكر أحد الامتداد التاريخي للعرب على تلك الأرض.
- العراق:
الوضع ذاته ينطبق على العراق. فالاسم "العراق" لم يكن مستخدماً في العصور القديمة، بل كانت المنطقة تعرف بأسماء أخرى مثل سومر وأكّد وبابل وآشور وميزوبوتاميا (بلاد ما بين النهرين). ومع مرور الزمن وتغيّر القوى الحاكمة ظهرت تسميات أخرى كـ"أرض السواد" في العهد العباسي. ومع ذلك لم ينكر أحد أن الجغرافيا هي نفسها، وأن الشعوب التي تعاقبت عليها تنتمي إلى ذات الرقعة التي أصبحت تسمى لاحقاً العراق.
- الكويت:
أما الكويت فقد عُرفت في التاريخ بأسماء مختلفة مثل الكاظمة ثم القرين قبل أن يستقر الاسم على "الكويت" في العصر الحديث. ورغم هذا التغيّر في التسمية، فإن أحداً لا يشكك في حق الكويتيين في أن تكون لهم دولتهم الحديثة باسمهم الحالي.
- قطر:
وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطر، إذ تذكر المصادر اليونانية القديمة اسمها بـ"كاتارا" أو "كتارا"، وتغيرت الأسماء مع العصور حتى استقر على "قطر". فهل غياب اسم "قطر" عن النقوش القديمة ينفي وجود الشعب الذي عاش في تلك الأرض؟ قطعاً لا.
الدرس المستفاد:
إن هذه الأمثلة – السعودية والعراق والكويت وقطر – ليست سوى شواهد حيّة على أن الأسماء تتغير، لكن الجغرافيا والشعوب تبقى. ومن هنا، فإن غياب اسم "كوردستان" في العصور القديمة لا يعني مطلقاً غياب الكورد عن التاريخ. فقد أقام الكورد بالفعل إمارات ودولاً وإمبراطوريات حملت أسماء مختلفة: الميديون، الكاشيون، الهوريون، الميتانيون، الدولة المروانية، الدولة الحسنوية، الدولة الشدادية، الدولة الأيوبية وغيرها. كل هذه الكيانات كانت كوردية الجوهر، وإن لم تحمل اسم "كوردستان" نصاً.
لقد استخدم مصطلح "كوردستان" لأول مرة بصيغة رسمية في عهد السلطان السلجوقي سنجر في القرن الثاني عشر الميلادي، حين خصّص ولاية بهذا الاسم. ثم أصبح المصطلح شائعاً في الوثائق العثمانية والصفوية، وبقي متداولاً حتى بدايات القرن العشرين. هذا يدل على أن التسمية نفسها لها تاريخ عريق، حتى وإن لم تكن مستخدمة منذ فجر التاريخ.
نحو الدولة الحديثة:
من هنا نفهم أن إشكالية التسمية لا يمكن أن تستخدم ذريعة لإنكار حق الكورد في الدولة. فالتاريخ السياسي للعالم يثبت أنّ الأمم كثيراً ما تعيد إنتاج أسمائها وهويتها السياسية في مراحل مختلفة. وإذا كان للعرب أن يؤسسوا دولة حديثة باسم السعودية، وللعراقيين دولة باسم العراق، وللكويتيين والكَطريين دول تحمل أسماء حديثة، فمن باب أولى أن يكون للكورد، الذين عاشوا على أرضهم التاريخية آلاف السنين وأقاموا عشرات الإمارات والدول، الحقّ في إقامة دولتهم المعاصرة باسم "كوردستان".
إذن، فإن مسألة التسمية ليست سوى حجابٍ واهٍ يخفي حقيقة راسخة: الكورد شعب قديم، متجذّر في جغرافيا واضحة، وأصحاب تاريخ سياسي حافل بالدول والإمارات. وإن قيام دولة حديثة باسم "كوردستان" ليس بدعة تاريخية، بل استمرارٌ طبيعي لسيرورة حضارية طويلة.
وعليه، فإن جوهر القضية لا يكمن في التسمية بقدر ما يكمن في الهوية التاريخية والجغرافيا الثابتة. فالكورد، مثلهم مثل العرب أو الفرس أو الأتراك، لم يكونوا بحاجة إلى أن يطلقوا على دولتهم اسم "كوردستان" منذ العصور القديمة ليبرهنوا على وجودهم السياسي. فالدولة الأيوبية لم تسمَّ "كوردستان" لكنها كانت كوردية، وكذلك المروانية والحسنوية وغيرها. إنّ ما يثبته التاريخ هو أنّ الكورد ظلوا حاضرين كقوة سياسية واجتماعية عبر القرون، وأنّ ظهور اسم "كوردستان" في العصور الوسطى لم يكن إلا تتويجاً لإرث ممتدّ، يؤكد حقهم الطبيعي في أن يكون لهم اليوم كيان حديث يحمل هذا الاسم ويعبّر عن استمرارية تاريخهم.
خامساً: الوجود الكوردي كشعب أصيل
إنّ النقاش حول أصالة الكورد ليس جديداً، بل ارتبط منذ قرون بالسجالات التاريخية والسياسية التي حاولت بعض القوى من خلالها طمس هوية هذا الشعب أو إنكار جذوره. غير أنّ الوثائق التاريخية والمصادر الآثارية تكشف بوضوح أن الكورد ليسوا شعباً طارئاً على المنطقة، بل هم من أقدم شعوب الشرق الأدنى الذين عاشوا على أرضهم عبر آلاف السنين.
لقد أظهرت الدراسات المسمارية التي قام بها عدد من الباحثين الغربيين – ومنهم العلّامة الفرنسي جان ماري دوران – أنّ ألواحاً تعود إلى الحقبة السومرية ذكرت اسم كوردا (Kurda) ككيانٍ سياسي قائم في مناطق سنجار وكردستان العليا، أي في قلب الجغرافيا الكوردية الحالية. هذا الاكتشاف يضع الكورد بين أقدم الشعوب التي شكّلت وجوداً سياسياً موثقاً في تاريخ ميزوبوتاميا.
كما أنّ النصوص الأشورية والبابلية القديمة أشارت إلى شعوبٍ سكنت جبال زاغروس عُرفت بأسماء مختلفة مثل اللولوبيين والسوباريين والكاشيين، وهي أقوام يجمع الباحثون المعاصرون على ارتباطها العرقي والثقافي بالكورد الحاليين. هؤلاء الأقوام لم يكونوا مجرد قبائل هامشية، بل أسسوا ممالك وإمبراطوريات امتدت سلطتها لقرون، مثل الكاشيين الذين حكموا بابل زهاء أربعة قرون، والميتانيين الذين أنشأوا واحدة من أبرز الممالك في شمال ميزوبوتاميا وبلاد الشام.
ثمّ يأتي ذكر الميديين في القرن السابع قبل الميلاد ليشكل مرحلة فاصلة في التاريخ الكوردي. فقد أسس الميديون أول إمبراطورية كبرى في الهضبة الإيرانية – انطلاقاً من جبال كوردستان – وتمكنوا من إسقاط الإمبراطورية الأشورية التي كانت القوة العظمى في زمانها. هذه اللحظة التاريخية لا يمكن إلا أن تُقرأ بوصفها دليلاً على رسوخ الكورد كقوة سياسية وإثنية بارزة منذ العصور الكلاسيكية.
وما يلفت النظر أنّ المؤرخين الإغريق والرومان، مثل زينوفون، أشاروا بوضوح إلى شعوب تسمّى الكاردوخيين (Carduchi) الذين سكنوا الجبال بين دجلة وزاغروس، ووصفوهم بأنهم مقاتلون أشداء لم تخضعهم الإمبراطوريات بسهولة. هذا الوصف يتطابق إلى حد بعيد مع ما حفظه التاريخ اللاحق عن الكورد: شعب جبلي محارب، حريص على حريته، صعب الانقياد.
إنّ هذا التراكم التاريخي يثبت أن الكورد ليسوا جماعة مهاجرة حديثة ولا أقلية مستحدثة، بل هم شعب أصيل من شعوب ميزوبوتاميا والشرق الأدنى القديم. لقد تشكلت هويتهم عبر آلاف السنين في تفاعل مع بيئتهم الجغرافية – جبالهم وسهولهم وأنهارهم – ومع جيرانهم من الشعوب السومرية والأكدية والآشورية والفارسية والعربية. ومع كل التحولات التي شهدتها المنطقة، ظل الكورد يحتفظون بخصوصيتهم اللغوية والثقافية والاجتماعية، مما يجعل وجودهم اليوم استمراراً طبيعياً لجذور ضاربة في عمق التاريخ.
وبذلك، فإنّ الحديث عن الكورد كشعب أصيل ليس مجرد ادعاء قومي حديث، بل هو حقيقة علمية وتاريخية موثقة، تؤكدها النصوص المسمارية، وشهادات المؤرخين الكلاسيكيين، والوثائق الإسلامية الوسيطة، وصولاً إلى الدراسات الحديثة في الأنثروبولوجيا والآثار. وهذا ما يمنحهم الحق الكامل في اعتبار أنفسهم من أقدم أصحاب الأرض في المنطقة، تماماً كما هو حال السومريين والآشوريين والكلدان والفرس والعرب.
الخاتمة
إنّ التاريخ، كما تجمع عليه الدراسات الأكاديمية الحديثة، لا يقاس بالأسماء وحدها، ولا تختزل قيمته في المصطلحات التي صاغتها السلطات الحاكمة عبر العصور، بل يقاس بالوجود الفعلي للشعوب وكياناتها، وبما خلّفته من أثرٍ حضاري وسياسي على مسرح الأحداث. ومن هذا المنظور، يتبيّن لنا أن الكورد ليسوا مجرد جماعة هامشية طارئة على مسرح الشرق الأدنى، بل هم شعب أصيل متجذّر في جغرافيا ميزوبوتاميا العليا وزاغروس والأناضول الشرقي، شارك في صياغة تاريخ المنطقة منذ آلاف السنين. لقد شهدت الأرض التي تعرف اليوم بـ "كوردستان" قيام دولٍ وإمارات متعاقبة، امتدت من العصور المسمارية مع السوباريين واللولبيين والكاشيين والميتانيين، مروراً بـ الميديين الذين أقاموا إمبراطورية كبرى عدّها المؤرخون أول كيان سياسي كوردي الطابع، وصولاً إلى الإمارات والدول الإسلامية الكوردية التي تنوّعت بين المروانيين والحسنويين والشداديين والأيوبية، وانتهاءً بالإمارات الكوردية التي حافظت على وجودها حتى القرن التاسع عشر.
إنّ تغيّر التسميات السياسية للدول والإمبراطوريات في المنطقة – من سومر وبابل وآشور إلى فارس وبيزنطة والدولة العباسية، وصولاً إلى العراق وإيران وتركيا وسوريا الحديثة – لم يُلغِ أبداً حضور الكورد على أرضهم. فكما أنّ العرب لم تكن لهم "دولة عربية موحدة" قبل القرن العشرين، ومع ذلك يُعَدّون شعباً أصيلاً يمتلك حق تقرير المصير، كذلك الكورد لم يكونوا بحاجة إلى أن يسمّوا دولتهم "كوردستان" في كل عصرٍ من العصور لكي يُثبتوا أصالتهم ووجودهم السياسي. فالأسماء تتبدل بتبدل العصور والحكام، لكن الجغرافيا الثابتة والهوية المستمرة هما اللتان تشكلان المعيار الحقيقي للوجود التاريخي.
واليوم، حين يرفع الكورد مطلبهم بإنشاء دولة كوردية معاصرة تحمل اسم "كوردستان"، فإنهم لا يبتدعون مشروعاً سياسياً من فراغ، ولا يطالبون بكيان لم يعرفه التاريخ، بل يستعيدون حقاً طبيعياً لهم كشعبٍ أصيل ساهم في بناء حضارة المنطقة، ودفع ثمن حريته عبر قرونٍ من الصراع والمقاومة. إنّ مطلب الدولة الكوردية هو امتداد منطقي للتاريخ، وموازٍ لما قامت به الشعوب الأخرى في المنطقة من بناء دولها الوطنية الحديثة بعد انهيار السلطنة العثمانية وصعود مفاهيم القومية وحق تقرير المصير.
لقد علّمتنا قراءة التاريخ أنّ الإنكار لا يُلغي الحقائق، وأن محاولات طمس هوية الكورد لم تمنعهم من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم ووعيهم الجمعي. إنّهم اليوم يقفون، مثل غيرهم من شعوب الشرق، أمام استحقاقٍ تاريخي يتمثل في أن تتحول جغرافيتهم الممتدة – التي ظلّت عبر القرون تعرف باسم كوردستان – إلى دولة حديثة تُترجم وجودهم التاريخي إلى سيادة سياسية معترف بها. وبهذا، فإنّ القضية الكوردية ليست مجرد نزاع سياسي معاصر، بل هي امتداد لمسار طويل لشعبٍ صمد في وجه الزمن، وما يزال يسعى إلى أن ينال مكانته الطبيعية بين أمم العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Bois, Th. (1966). The Kurds. Beirut: Khayats.
- Bruinessen, M. van (1992). Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan. London: Zed Books.
- Gunter, M. (2011). The Kurds: A Modern History. Princeton: Markus Wiener Publishers.
- Izady, M. R. (1992). The Kurds: A Concise Handbook. Washington D.C.: Taylor & Francis.
- McDowall, D. (2004). A Modern History of the Kurds (3rd ed.). London: I.B. Tauris.
- Minorsky, V. (1943). “The Kurds,” Encyclopaedia of Islam, Vol. 2. Leiden: Brill.
- O’Shea, M. T. (2004). Trapped Between the Map and Reality: Geography and Perceptions of Kurdistan. New York: Routledge.
- Olson, R. (1989). The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880–1925. Austin: University of Texas Press.
- van Bruinessen, M. (1997). Kurdish Ethno-Nationalism versus Nation-Building States. Istanbul: Isis Press.
- Yildiz, K. (2004). The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future. London: Pluto Press.
- Natali, D. (2005). The Kurds and the State: Evolving National Identity in Iraq, Turkey, and Iran. Syracuse: Syracuse University Press.
- Edmonds, C. J. (1957). Kurdish Nationalism. Journal of the Royal Central Asian Society, 44(1).
- Hassanpour, A. (1992). Nationalism and Language in Kurdistan, 1918–1985. San Francisco: Mellen Research University Press.
- Izady, M. R. (1997). Ethnic Groups of Kurdistan. Washington D.C.: Columbia University.
- Jwaideh, W. (2006). The Kurdish National Movement: Its Origins and Development. Syracuse: Syracuse University Press.