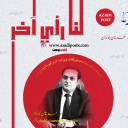بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
المقدمة:
لم تولد الصحافة الكوردية من فراغ، بل جاءت كصرخة في وجه التهميش، وكسلاح في معركة غير متكافئة من أجل الاعتراف والوجود. فمنذ أن أطلق مقداد مدحت بدرخان أول عدد من صحيفة كوردستان في القاهرة عام 1898، تحولت الكلمة الكوردية من أداة تعبير إلى وسيلة مقاومة، ومن نشاط ثقافي إلى فعل سياسي وجودي. فالصحافة الكوردية لم تكن ترفاً نخبوياً، بل ضرورةً وجودية لأمة لا تمتلك دولة، وتعيش في جغرافيا ممزقة، وتاريخٍ يتآمر على لغتها وذاكرتها.
في البدء كانت الكلمة. لم تكن الكلمة مجرد صوت أو كتابة، بل كانت فعلاً أنطولوجياً، موقفاً من الوجود، وصرخة ضد العدم. وإن كانت كل الشعوب قد عبّرت عن ذاتها بالكلمة – بالشعر، بالبيان، بالصحافة – فإنّ الكلمة الكوردية وُلدت في منفى التاريخ، وتفتّحت لا على طاولة حرية، بل على موائد الرقابة والاضطهاد. فالصحافة الكوردية، منذ لحظة ميلادها في نهايات القرن التاسع عشر، لم تكن مجرّد ممارسة إعلامية تسعى لنقل الأخبار أو تحليل الواقع، بل كانت مشروعاً رمزياً لإعادة تشكيل الذات الكوردية المهددة بالمحو.
تاريخ الصحافة الكوردية هو تاريخ الصراع من أجل الوجود، تاريخ الكلمة التي كُتبت من خارج الوطن، لتكتب الوطن نفسه. إنّ أول جريدة كوردية، وهي "كوردستان" التي أصدرها مقداد مدحت بدرخان في القاهرة عام 1898، لم تُكتب في أرض كوردية، بل كُتبت عن كوردستان، من خارجها، ومن أجلها. هكذا نجد أنفسنا منذ اللحظة الأولى أمام مفارقة: الكلمة التي لا تصدر من الأرض، لكنها تحاول أن تُعيد امتلاك الأرض رمزياً. الكلمة كمنفى، لكنها أيضاً كعودة رمزية. الكلمة كمعارضة سياسية، ولكن أيضاً ككينونة وجودية.
من هذا المنظور، لا يمكن اختزال الصحافة الكوردية في بعدها التاريخي أو الإعلامي فقط، بل ينبغي النظر إليها كبنية ثقافية مقاومة، بوصفها تجلياً لصراع طويل بين السلطة والصوت، بين الدولة التي تسعى إلى إنتاج الصمت، وبين شعب يسعى إلى إنتاج ذاته من خلال الخطاب. فالصحافة الكوردية لا تنتمي إلى تاريخ الصحافة التقليدي، بل إلى تاريخ المقاومة الثقافية، وهي في هذا المعنى، ليست مجرد كتابة عن الحدث، بل هي كتابة ضد الحدث، ضد ما يحدث من محوٍ للهوية، ومن نفيٍ للوجود، ومن تجزئة للوعي.
إنّ السلطة، أيًّا كان شكلها، تدرك خطر الكلمة، لا حين تكون حيادية، بل حين تكون منحازة للحقيقة. ولذلك لم تكن الرقابة على الصحافة الكوردية مجرد رقابة سياسية، بل كانت رقابة على اللغة ذاتها، على الحرف، على اللهجة، على المعنى. الكلمة الكوردية لم تُحارب لأنها تكتب سياسة، بل لأنها تكتب الحياة بلغة مهددة بالزوال. ومن هنا تتخذ الصحافة الكوردية طابعها الخاص: إنها ليست فقط فعلاً ثقافياً، بل فعل مقاومة، مقاومة للغُربة، للنسيان، للطمس، للنفي، للاغتراب.
وعلى خطى غرامشي الذي تحدث عن "المثقف العضوي"، يمكننا أن نرى الصحفي الكوردي بوصفه مثقفاً مقاتلاً، لا يعمل في هامش المجتمع، بل في قلب معاركه، وهو يكتب تحت التهديد، ويطبع في الظلام، ويوزع في الجبال. ولعل أخطر ما في هذه المعادلة أن الكلمة لم تكن فقط ممنوعة، بل كانت مستهدفة بالتصفية، كما استُهدفت الأجساد التي كتبتها. لذا، فكل جريدة كوردية هي أيضاً ضريح رمزي، وكل افتتاحية هي شجرة مرويّة بالدم، وكل عنوان هو صرخة في وجه مؤرخي الدولة الذين أرادوا محو الحكاية.
إنّ هذا البحث لا يهدف فقط إلى رصد تاريخ الصحافة الكوردية من منظور تأريخي، بل يسعى إلى تحليل بنيتها الفلسفية، بوصفها خطاباً للكينونة، وأداة لمقاومة المحو الرمزي، ومساحة لبناء الذات الجماعية. وسنحاول من خلال فصول هذا العمل أن نعيد قراءة الصحافة الكوردية كجزء من مشروع تحرر أكبر، وأن نسلّط الضوء على تحولات الخطاب من الخبر إلى النضال، من الحياد إلى الانتماء، من الورق إلى الثورة.
فالصحافة الكوردية ليست مجرّد صفحات منشورة، بل هي أرشيف الوعي الكوردي في أكثر لحظاته هشاشة وقوة معاً. وهي ليست سجلاً لما حدث فقط، بل فعلاً لتغيير ما يجب أن يحدث. إننا إذ نكتب عن الصحافة الكوردية، إنما نكتب عن الكلمة التي رفضت الصمت، عن الكلمة التي كتبت رغم أن كلّ شيء كان ضدها: اللغة، الجغرافيا، التاريخ، الدولة، وحتى المنطق.
لهذا كلّه، فالبحث في الصحافة الكوردية هو بحث في معنى أن تكتب وأنت محكوم بالصمت، أن تصدر جريدة في منفى، أن تطبع صوت شعبٍ على ورقٍ لا يعترف به أحد، أن تحوّل الكلمة إلى مقاومة، لا فقط إلى خبر.
هذا البحث يحاول أن يستعرض مسيرة الصحافة الكوردية من منظور فلسفي وثقافي، ليرى فيها أكثر من مجرد وسيلة إعلام، بل شكلاً من أشكال الوعي القومي، وتجلياً من تجليات الذات الكوردية وهي تحاول أن تكتب نفسها في عالم لا يعترف بها.
أولاً: السياق التاريخي لولادة الصحافة الكوردية
1- جريدة "كوردستان": الولادة في المنفى
حين نعود إلى التاريخ لنبحث عن اللحظة التي نطقت فيها الكلمة الكوردية المطبوعة لأول مرة، فإننا لا نجدها في ديار بكر، ولا في السليمانية، ولا في مهاباد، بل في القاهرة. هذه المفارقة وحدها تقول الكثير: الكلمة الكوردية ولدت في المنفى، في الغربة، في الهامش الجغرافي، لكنها في الحقيقة كانت ولادة في قلب الهوية، في مركز الحاجة إلى التعبير. جريدة "كوردستان"، التي أُصدرت في 22 نيسان عام 1898، هي أول صوت كوردستاني مطبوع، وأول محاولة لتأسيس خطاب جماعي يتجاوز التشتت العشائري والانغلاق المحلي نحو بناء وعي قومي كوردستاني شمولي.
لم تكن هذه الجريدة "جريدة عادية"، بالمعنى الوظيفي، بل كانت تأسيساً رمزياً لحضور الأمة الكوردية في الفضاء الحداثي للدولة العثمانية، الذي كان يزداد انغلاقاً في نزعاته الطورانية والسلطوية. لقد مثّلت "كوردستان" لحظة قطيعة معرفية وسياسية: قطيعة مع الصمت، مع الانعزال، مع خضوع الشعب الكوردي لخطابات الآخرين. هي لحظة تحوُّل الكوردي من موضوع في نصوص الغير، إلى ذات تكتب ذاتها بنفسها، وتنطق باسمها.
لكنّ المفارقة الأكبر، والتي تحكم كل مسار الصحافة الكوردية اللاحقة، أن هذه الولادة حدثت لا من داخل الوطن، بل خارجه. المنفى إذاً ليس فضاءً جغرافياً فقط، بل هو الشرط البنيوي للكلمة الكوردية: تكتب نفسها من الخارج، ضد الداخل. لقد كتب مقداد مدحت بدرخان جريدته من المنفى، ووجّهها إلى وطن لم يعترف به التاريخ الرسمي، لكنه كان حيّاً في قلوب أبنائه. جريدة "كوردستان" هي فعل مقاومة منفى ضد وطن مغتصب.
2- مقداد مدحت بدرخان: من النخبة العثمانية إلى ضمير الأمة
شخصية مقداد مدحت بدرخان تجسّد التحوّل العميق الذي عاشته النخبة الكوردية في نهاية القرن التاسع عشر. ينتمي بدرخان إلى عائلة أرستقراطية عريقة كانت تمثل إحدى آخر البنى السياسية الكوردية المستقلة نسبياً قبل السقوط الكامل تحت الهيمنة العثمانية، وهي عائلة بدرخان باشا، حاكم إمارة بوطان. وقد تلقى مقداد تعليمه في إسطنبول، وتأثر بالمناخ الإصلاحي والثوري الذي كان يتفاعل داخل نخب "الآستانة" آنذاك، خصوصاً بين أوساط المثقفين العثمانيين الشباب، الذين كانوا يعيشون صراعاً داخلياً بين الولاء للإمبراطورية، والرغبة في إنقاذ قومياتهم من التهميش.
لقد كان مقداد من أوائل الذين تجاوزوا الخطاب القبلي أو العشائري الكوردي نحو وعي قومي شامل. لم يكن ينظر إلى الكوردي كأحد مكونات السلطنة فقط، بل كشعب له لغته وتاريخه وثقافته. ولذلك تحوّلت صحيفته إلى منصة لإحياء هذا التاريخ المنسي، ولنقد السياسات التتريكية، وللدعوة إلى وعي كوردي مستقل. من النخبة العثمانية التي كانت تسعى لإصلاح الإمبراطورية، انبثق مقداد مدحت بدرخان كمثقف كوردي يبحث عن استقلال الذات لا مجرد إصلاح الإمبراطورية التي تُذيب الذات.
بلغة اليوم، يمكن أن نعتبره "المثقف الانتقالي"، الذي لم يكتفِ بدور الإصلاح من داخل الدولة، بل اختار أن يخلق مساحته الرمزية خارجها. هو الذي انتقل من خانة "الموظف العثماني" إلى خانة "الضمير القومي"، وهو الذي زرع البذرة الأولى للخطاب الكوردي الحديث، ليس فقط بلغته، بل بنظرته الكونية: لم يكتب فقط للكورد، بل للعالم عن الكورد، وبذلك فتح أفقاً للهوية خارج الجغرافيا الضيقة التي وُلد فيها.
3- القاهرة كمركز لبزوغ الوعي القومي الكوردي
اختيار القاهرة كمكان لإصدار أول جريدة كوردية لم يكن مصادفة جغرافية، بل دلالة سياسية وثقافية عميقة. فالقاهرة في نهاية القرن التاسع عشر كانت مركزاً نابضاً للفكر، والحريات النسبية، والتلاقح الثقافي، ومهداً للصحف الحرة التي أسسها مثقفون من أطياف متعددة هرباً من القمع العثماني. لقد كانت ملتقى المنفيين السياسيين، ومختبراً مبكراً للخطاب القومي العربي والتركي والأرمني، وفي هذا الفضاء الحداثي المتعدد، بزغ الخطاب الكوردي أيضاً.
يمكن القول إن القاهرة لم تكن فقط مكان إصدار الصحيفة، بل كانت رحماً تاريخياً لولادة الذات الكوردية الحديثة. في القاهرة بدأت الكلمة الكوردية تُفكّك خطاب الدولة، وتبني خطاب الأمة. ولعلّ هذه المفارقة: أن يولد الخطاب القومي الكوردي في مدينة عربية، خارج السلطنة، من مثقف كوردي تعلّم في إسطنبول، تخبرنا أن الهوية لا تُولد فقط من الأرض، بل من الشعور بالغياب عنها، من الحنين، من المنفى، من الحاجة إلى قول "نحن" في وجه خطاب يقول "أنتم جزء من الآخرين".
ولذلك، فإن الصحافة الكوردية لم تبدأ كـ"وسيلة إعلام"، بل كصرخة هوية، وكإعادة بناء للذات. إنّ صدور جريدة "كوردستان" في القاهرة هو إعلان مبكر أن الوطن ليس فقط الأرض التي نعيش عليها، بل اللغة التي نكتب بها، والوعي الذي نصوغ به سرديتنا، والجرأة على امتلاك صوتنا في مواجهة الصمت المفروض علينا.
ثانياً: تطور الصحافة الكوردية بين القمع والبناء الثقافي
إنّ مسار الصحافة الكوردية لم يكن خطاً تصاعدياً بسيطاً، بل كان أقرب إلى نبضات مقاومة متقطعة، تصعد في لحظات التنوير، وتنقمع في لحظات القمع، لكنها لا تموت. لقد رافقت الصحافة الكوردية تاريخ الأمة الكوردية في كل مآسيها وثوراتها، وعكست تطوّر الوعي الذاتي في مواجهة ثلاثي التحديات الكبرى: الرقابة، المنفى، وتمزق الجغرافيا.
- في مواجهة الرقابة: الكلمة الممنوعة والملاحقة الدائمة
منذ ولادتها، كانت الصحافة الكوردية تمارس فعلاً شبه مستحيل: أن تقول ما لا يُقال، بلغة غير معترف بها، عن شعب غير معترف به، داخل دول لا تعترف بوجود "قضية" أصلاً. لقد كانت الرقابة أول من يستقبل الكلمة الكوردية، لا القرّاء. ففي تركيا بعد تأسيس الجمهورية، مُنعت كل الصحف والمطبوعات الكوردية، وتم تجريم الكتابة باللغة الكوردية بحجج "وحدة الأمة"، و"تهديد الأمن"، و"التآمر الخارجي". وفي العراق، خضعت الصحافة الكوردية لمراقبة الدولة المركزية، وتم إغلاق عشرات الصحف خلال فترات التوتر القومي. أما في سوريا، فحتى منتصف القرن العشرين، لم تكن هناك صحيفة كوردية واحدة مسموح بها. وفي إيران، تذبذبت المساحة المسموحة بين الحظر المطلق والاعتراف المشروط، بحسب تبدلات الحكم.
الصحفي الكوردي كان دوماً يعيش في منطقة الشك: تُراقب كتابته، ويُعتقل بسهولة، وتُصادر مطبعته. ولهذا لم تكن الكتابة مجرّد مهنة، بل كانت مخاطرة وجودية. فأن تكتب بالكوردية، يعني أن تتحدى سياسة الصهر، وتكشف زيف الخطاب الرسمي، وتعيد الاعتبار لثقافة مُراد لها أن تختفي. لقد كانت الرقابة السياسية تشتبك مع اللغة نفسها، فتمنع الحرف، والنص، وحتى الحكاية.
- المنفى كمساحة حرة ومأساوية في آن
مثلما وُلدت الصحافة الكوردية في المنفى، فقد استمرت طويلاً في التنفس خارجه. باريس، ستوكهولم، برلين، يريفان، بغداد، أربيل، السليمانية، بيروت، كانت محطات كوردية للصحافة، تنبض بالكلمة، وتشهد تحوّل المنفى إلى مساحة ثقافية وسياسية بديلة عن الوطن. لقد كانت الصحافة الكوردية في المنفى أكثر حرية في التعبير، لكنها في المقابل، كانت تعاني من قطيعة مع الجمهور الحقيقي، أي مع القارئ الكوردي الذي يعيش في الجبال والمدن المقموعة.
وفي المنفى أيضاً، وُلدت مجلات فكرية وثقافية حملت مشاريع تنويرية مهمة، مثل مجلة هاوار في دمشق التي أسسها الأمير جلادت بدرخان، والتي ساهمت في ترسيخ الأبجدية الكوردية اللاتينية، ومجلة رووناكي في بغداد التي كانت منابر للأدب واللغة. وفي أوروبا، ظهرت عشرات الدوريات التي تناولت القضية الكوردية من منظور حقوقي وثقافي، وربطت نضال الكورد بالسرديات العالمية عن التحرر والعدالة.
لكن المنفى –رغم حريته– ظل يعاني من الإحساس بالفقد: فقدان الأرض، والجمهور، والتأثير المباشر. فكانت الصحافة تُكتب من الخارج، وتُهرب إلى الداخل، أو تُطبع من أجل الشتات، لكنها ظلت –في جوهرها– صحافة مقاومة، لأنها لم تفقد اتصالها بالقضية الأم.
- التمزق الجغرافي وتعدد اللهجات والفضاءات
انقسام كوردستان بين أربع دول (تركيا، العراق، إيران، سوريا) خلق تحدياً فريداً للصحافة الكوردية: كيف تبني خطاباً مشتركاً في ظل تباين السياسات، واللهجات، والأبجديات؟ لقد استعمل الكورد ثلاث أبجديات مختلفة (العربية، اللاتينية، الفارسية)، وتعددت اللهجات (كورمانجية، سورانية، زازاكية، هورامية)، ما صعّب من توحيد الخطاب الصحفي والثقافي.
ومع ذلك، استطاعت الصحافة الكوردية أن تتجاوز هذه التحديات تدريجياً، وظهرت محاولات جادة لبناء لغة صحفية كوردية حديثة توفّق بين اللهجات. كما لعبت الصحافة دوراً محورياً في الحفاظ على اللغة نفسها من الانقراض، عبر نقلها من المجال الشفهي إلى المكتوب، ومن الأدب الشعبي إلى التحليل السياسي.
التمزق الجغرافي لم يكن عائقاً فقط، بل كان دافعاً لخلق خطاب يتجاوز الحدود. فكل صحيفة كوردية، كانت تكتب عن كوردستان كلها، لا عن "جزء" منها فقط. وهكذا تحوّلت الصحافة إلى أداة لوصل الأجزاء المتفرقة، وتكوين ذاكرة كوردية مشتركة، رغم الحواجز المصطنعة.
- من الإعلام إلى التنوير: الكلمة كفعل بناء ثقافي
الصحافة الكوردية لم تكتفِ بنقل الأخبار، بل كانت رافعة ثقافية كبرى. كانت تُعرّف القارئ الكوردي على الأدب، والتاريخ، والفكر، والفلسفة، وتخلق نوعاً من "النهضة الكوردية" الصامتة. لعبت دور الجامعات البديلة، خصوصاً في المناطق المحرومة من التعليم باللغة الكوردية. وعبرها، تم تخليد التراث الشفهي، وتوثيق الأغاني، والأساطير، والتاريخ المنسي.
كما شكلت الصحافة الكوردية منبراً للتجريب الأدبي، وظهر فيها كتّاب وشعراء غيّروا المشهد الثقافي، مثل عبد الله كوران، وشيركو بيكه س، وغيرهم. لقد كانت الكلمة الصحفية تعانق الكلمة الشعرية، وتبني روحاً جديدة لشعب يبحث عن نفسه في مرآة الكلمة.
ثالثاً: الجغرافيا المنفية للصحافة الكوردية
🔹. من المهجر إلى الجبال: الصحافة في فضاء لا مركزي
الصحافة الكوردية، على امتداد أكثر من قرن، لم تولد في مركز جغرافي تمتلك فيه السلطة أو السيادة، بل نشأت في مناطق خارجة عن نطاق القرار السياسي الكوردي، وتطورت في فضاءات هامشية، أو بالأحرى، فضاءات مقموعة ومضادة للمركز الرسمي للدولة. فكانت القاهرة، لندن، باريس، يريفان، بغداد، بيروت، جبال قنديل، وحتى الكهوف والأنفاق، بمثابة مراصد كونية تطلّ منها الكلمة الكوردية على العالم، وتعلن وجود أمة منفية من التاريخ الرسمي، ولكنها حاضرة في جغرافيا الكلمة.
كانت تلك الصحافة لا مركزيّة بالمعنى السياسي والجغرافي معاً، لكنها ظلت متمركزة حول الذات الكوردية بوصفها كينونة مأزومة ومقاومة. فالمنفى لم يكن مجرد موقع طارئ، بل أصبح مسرحاً دائماً لإنتاج الخطاب الكوردي، ومع كل موجة قمعٍ سياسي، كانت الصحافة تنتقل من مكان إلى آخر، تكسر جدران الرقابة، وتعيد تشكّلها من جديد.
وفي هذا المعنى، يمكن الحديث عن "خرائط متعددة للصحافة الكوردية" لا تعترف بحدود الدول، بل ترسم حدوداً للذاكرة، والنضال، والتجربة، حيث تصبح الجبال منصات إعلامية، وتتحول الخنادق إلى مطابع سرية.
لقد كانت الصحافة الكوردية دوماً صوتاً في العتمة، تبحث عن الضوء لا في العواصم، بل في الفجوات، في الأماكن التي تُقصى عنها السلطة المركزية، وتُستبعد منها الكلمة الحرة.
🔹. المنفى كمنصة خطابية
في سياق الاستعمار، المنفى يُستخدم كأداة إقصاء. لكنه عند الكورد، تحوّل إلى أداة إنتاج. فبدلاً من أن يكون طرداً من الجغرافيا، أصبح تمكيناً من الخطاب.
المنفى الكوردي، الذي عاشه الصحفيون والكتّاب والسياسيون، لم يكن مجرد اغتراب جغرافي، بل تجربة تفجير وجودي للذات. لقد أجبرهم على إعادة تعريف ذواتهم، لغتهم، ورؤيتهم للعالم. وهكذا، أصبحت الصحافة في المنفى ليست فقط ناقلاً للأخبار، بل بناءً رمزياً للهوية. هي اللغة التي كتبت الذات الكوردية من خارج الوطن، فصارت أكثر التصاقاً بالوطن من الوطن نفسه.
وقد ساهم المنفى في فتح أفق الصحافة الكوردية نحو العالمية. فحين كانت الكلمة تُحاصَر في دمشق وبغداد وطهران وأنقرة، كانت تُطبع وتُنشر في لندن وبرلين وستوكهولم. وهكذا ولدت صحافة كوردية هجينة: تتحدث بلغة الهوية، وتُطبع بأدوات الحداثة، وتخاطب كوردستان من وراء البحار، لتعيد تشكيل وعي الداخل.
لقد تحوّلت الصحافة الكوردية في المنفى إلى ما يشبه "الميدان الرقمي قبل العصر الرقمي" – فضاءً حرًا يخلق لغة بديلة، ويتجاوز الرقابة، ويُعبّر عن المهمشين.
🔹. علاقة الصحافة الكوردية بالفضاء الاستعماري والرقابة
منذ ولادتها، كانت الصحافة الكوردية في مواجهة مباشرة مع الأنظمة الاستعمارية أو الدول القومية التي ورثت خطاب الاستعمار. كانت هذه الصحافة فعلاً مضاداً للرقابة، بل وجودها ذاته كان فعل تمرّد.
لم تُمنح الصحافة الكوردية حقَّ النشر، بل كانت تُنتزع بالقوة أو تُكتب في الخفاء. وكان على الصحفي الكوردي أن يختار: إمّا المنفى أو السجن، إمّا الحبر أو الدم. لذلك، كانت المطابع تُداهم، والصحف تُصادر، والكتّاب يُغتالون أو يُنفون، لكن الكلمة لم تتوقف، بل تحوّلت إلى "خطاب هارب" من السلطة، متنقل، مراوغ، ومليء بالحياة.
في هذا السياق، يمكن القول إن الصحافة الكوردية تعرّضت لما أسماه فوكو بـ"رقابة الخطاب"، حيث لا تُمنع فقط من التعبير، بل يُعاد تشكيل شروط إمكان الكلام نفسه. فاللغة الكوردية ذاتها كانت ممنوعة، والمصطلحات القومية تُعد جرائم، واستخدام اسم "كوردستان" كان يُعامل كفعل عدائي.
رغم ذلك، شكّلت الصحافة الكوردية نوعاً من الكتابة المضادة للسلطة – أي مقاومة بنيوية لأشكال الهيمنة الرمزية، من خلال انتزاع الحق في تسمية الذات، في رواية التاريخ، وفي إنتاج معرفة ذاتية مغايرة. وفي قلب كل هذا، أصبحت الصحافة الكوردية حارساً لذاكرة أمة تُراد لها النسيان، ومحرّكاً لوعي جمعي يتحدى الاستعمار لا بالسلاح فقط، بل بالكلمة.
رابعاً: الصحافة الكوردية والهوية: تشكيل الذات في مرآة الكلمة
في هذا الفصل، سنتناول علاقة الصحافة الكوردية بإنتاج الهوية، ليس بوصف الهوية مفهوماً ثابتاً، بل باعتبارها بناءً رمزياً وتاريخياً يتشكل من خلال الخطاب، واللغة، والذاكرة، والصراع. سنتوغل في تحليل الدور الذي لعبته الصحافة في بلورة الذات الكوردية، ضمن سياقات النفي والقمع والانبعاث، وسنقف عند الكلمة الكوردية كـ"مرآة" تنعكس فيها صورة الأمة: مجروحة، متشظية، لكنها تعيد تكوين ذاتها بالكلمات.
1- اللغة والهوية – من اللسان المحظور إلى الوعي الحيّ:
"الهوية ليست ما نحن عليه، بل ما نقوله عن أنفسنا". وفي السياق الكوردي، كانت الصحافة هي المجال الأول الذي قال فيه الكورد أنفسهم بلغتهم، في مواجهة دولة أرادت منهم أن يصمتوا أو يتكلموا بلغة الآخر.
لقد وُلدت الهوية الكوردية الحديثة – كهوية قومية وثقافية – في سياق لغوي مضاد. فاللغة الكوردية، في أغلب دول المنطقة، كانت ممنوعة من التداول الرسمي، محرومة من التعليم، بل كانت تُعامل كـ"لهجة عامية" لا تستحق التدوين. وهنا، ظهرت الصحافة بوصفها الحيّز الذي استردت فيه اللغة شرعيتها الوجودية.
كانت الصحف الكوردية، رغم بدائيتها التقنية أحياناً، بمثابة "مختبر لغوي للهوية". فمن خلالها، تم تثبيت الأبجدية، وتطوير المصطلحات، وبلورة خطاب سياسي وفكري بالكوردية، لا يترجم ذاته من لغة أجنبية، بل ينبع من التجربة الداخلية للشعب.
وفي هذا السياق، تصبح الصحافة الكوردية فعلاً لغوياً مقاوِماً، يواجه الإبادة الرمزية التي تمارسها الدولة عبر طمس اللغة. وبهذا المعنى، فإن الكلمة الكوردية في الصحافة ليست فقط أداة للتعبير، بل هي كيان وجودي للذات.
2- الصحافة كذاكرة مضادة – من النسيان الرسمي إلى أرشيف الذات:
في الدول المركزية التي حكمت كوردستان، كان التاريخ يُكتب من فوق، بلغة السلطة، وبذاكرة المنتصر. أما الصحافة الكوردية، فكانت "الذاكرة من تحت" – ذاكرة المهمشين، المنفيين، والمقموعين، التي لا تعترف بالسرديات الرسمية، بل تكتب سرديتها الخاصة.
لقد شكّلت الصحف الكوردية نوعاً من الأرشفة الذاتية للمأساة الكوردية. من تقارير عن المجازر، إلى مقالات حول حملات التهجير والتعريب، ومن شهادات المعتقلين إلى وصف لحياة الجبل والمنفى – هذه النصوص لم تكن مجرد أخبار، بل وثائق وجودية، تحفظ ما أرادت السلطة طمسه.
وفي هذا الإطار، لا يمكن فهم الصحافة الكوردية إلا باعتبارها ذاكرة سياسية وثقافية جماعية. ذاكرة تقاوم النسيان، وتستعيد الضحايا، وتبني من الحطام سرداً جديداً لهوية لا تزال قيد التشكل.
3- بين الداخل والمنفى – انقسام الهوية أم تعدديتها؟:
أحد الجوانب الفلسفية المعقدة في الصحافة الكوردية هو سؤال "المكان": أين تُنتج الهوية؟ هل في الداخل المضطهد؟ أم في المنفى الحرّ؟
فالصحف الكوردية التي نُشرت في أوروبا وأمريكا والمنفى السوفييتي، قدمت صورة كوردية عالمية، حداثية، نقدية، بينما الصحف في الداخل كانت غالباً أكثر واقعية، ميدانية، ملتصقة بالأرض، لكنها أيضاً أكثر عرضة للرقابة.
هذا الانقسام الجغرافي أنتج تعددية في أشكال الهوية. لكن بدل أن يكون هذا الانقسام ضعفاً، فقد منح الصحافة الكوردية ثنائية نادرة: لغة الداخل التي تعبّر عن التجربة الحيّة، ولغة الخارج التي تنظّر وتفكر وتحلل.
وهنا، نستطيع القول إن الصحافة الكوردية لم تنتج هوية واحدة، بل هويات كوردية متعددة ومتصارعة أحياناً، لكنها تشترك في رفض الاستعمار، وفي السعي نحو كوردستان ممكنة.
4- الكلمة بوصفها مرآة الذات المجروحة:
أخيراً، لا بد من العودة إلى البُعد الوجودي: فالصحافة الكوردية، في جوهرها، ليست فقط ممارسة إعلامية، بل مواجهة فلسفية مع العدم.
في كل مرة يكتب فيها صحفي كوردي مقالاً عن القمع، أو يروي مأساة شعبه، أو ينشر صورة من الجبل، فإنه يقول: "أنا هنا. نحن هنا." هذه الكتابة هي فعل تأكيد للذات في وجه المحو.
والكلمة هنا تتحوّل إلى مرآة مجروحة تعكس ذاتاً تنزف، لكنها لا تزال قادرة على أن ترى نفسها، وتعيد تشكيل صورتها عبر اللغة. وبهذا المعنى، فإن الصحافة الكوردية لا توثق فقط الواقع، بل تعيد خلقه من جديد.
خامساً: التحول من الصحافة الإخبارية إلى الصحافة النضالية
الصحافة الكوردية لم تكن يوماً مجرد نقلٍ محايد للخبر، بل كانت على الدوام حقلاً مفتوحاً للمقاومة، ومنصةً لقول المسكوت عنه، وخندقاً متقدماً في معركة الوجود القومي والثقافي. فمع تصاعد القمع السياسي، وانسداد الأفق الديمقراطي، وسلب الشعب الكوردي لأبسط حقوقه في التعبير واللغة، تحوّلت الصحافة من وسيلة إعلام إلى أداة نضال، ومن نقل المعلومة إلى صياغة الوعي، ومن الإخبار إلى الثورة.
- من الخبر إلى البيان السياسي:
في السياق الكوردي، حيث الكلمة نفسها قد تؤدي إلى السجن أو الإعدام، لم يكن ممكناً للصحافة أن تحافظ على مفهوم "الموضوعية الباردة" أو "الحياد الميت"، كما في الدول المستقرة. فالخبر الكوردي لم يكن خبراً عادياً، بل صرخة سياسية، وقنبلة لغوية، وفضحاً لما تُخفيه الأنظمة.
تحوّل النص الصحفي إلى بيان سياسي معلن أو ضمني، لا يكتفي بوصف الواقع، بل يسعى إلى تغييره. فمقال عن المجازر هو إدانة، وتقرير عن القرى المحروقة هو استنهاض، وحوار مع مناضل في الجبل هو إعلان انتماء. كل كلمة كانت تضع الكاتب أمام احتمالية الاعتقال أو النفي أو القتل، مما يجعل الكتابة ذاتها فعلاً من أفعال العصيان المدني.
لقد تماهت الصحافة الكوردية مع البيان الثوري، سواء في أسلوبها، أو في مضمونها، أو حتى في خطابها الشعري التحريضي. وهكذا، ذابت الحدود بين المقال والتصريح السياسي، بين الخبر والموقف، وبين الصحافة والعمل الثوري.
- الصحافة الكوردية كمنبر للتعبئة الوطنية:
عندما حُرمت الشعوب الكوردية من أدوات التعبئة الرسمية: المدارس، الجامعات، الإعلام العام، والمؤسسات الثقافية، تحوّلت الصحافة إلى الوسيلة الوحيدة للتربية الوطنية.
كانت الصحف والمجلات الكوردية تشكّل فضاءً عمومياً بديلاً، يُعرّف فيه الناس بأنفسهم، ويتعلمون تاريخهم الممنوع، ويعيدون كتابة خرائطهم الثقافية والسياسية. المقالات لم تكن تُكتب للخبرة الصحفية بقدر ما كانت تُكتب لـ"تكوين المواطن الكوردي الجديد"، الذي يعرف تاريخه، ويؤمن بقضيته، ويستعد للتضحية من أجلها.
وبين السطور، كانت تتشكل أخلاقيات وطنية جديدة: الوفاء، الفداء، الكرامة، الإصرار، الحلم، وغيرها من القيم التي نسجت الضمير القومي الحديث. كان القارئ الكوردي لا يستهلك الصحافة، بل ينخرط فيها، ويعيد إنتاجها شفوياً، في جلسات القرية، أو في جبهات القتال، أو داخل الزنازين.
- النشرة السرية: من الورق إلى الجدران إلى الفم:
من أبرز التحولات التي عكست طبيعة الصحافة الكوردية النضالية، هو نشوء ما يمكن تسميته بـ"الصحافة السرية"، أو "النشرة المقاومة"، التي لا تمر عبر القنوات الإعلامية التقليدية، بل تُنتج وتُوزع في الظل، وتعيش في الخفاء، وتُهمَس في الزوايا.
كانت هذه النشرات تُكتب باليد أحياناً، أو تُطبع بسرية في مطابع سرية داخل الجبال أو المدن، ويتم تهريبها عبر الحدود أو القرى. ومع انعدام الأمان، بدأت الصحافة الكوردية تنزل إلى الشارع بشكل حرفي: عبر الشعارات الجدارية، أو المنشورات الليلية، أو حتى القصائد الشفوية التي كانت تتناقلها الألسن وتُغنّى في الأعراس والمآتم على حد سواء.
هذه "الصحافة الفموية" كانت فعالة أكثر من أي وسيلة تكنولوجية، لأنها عبرت الحواجز الرقابية، ووصلت إلى القلوب مباشرةً، وكانت تكتب التاريخ من فم إلى أذن، ومن ذاكرة إلى ذاكرة.
إن النشرة السرية الكوردية كانت فعل وجود رمزي. لا تكتفي بنقل الحدث، بل تُشكّل هي ذاتها حدثاً نضالياً. إنها التمرد المتنقل، والصوت الذي لا يمكن اعتقاله، لأن الكلمة حين تُقال في الفم، لا يمكن مصادرتها على الورق.
في الختام، إن تحوّل الصحافة الكوردية من وسيط إعلامي إلى أداة نضال يعكس خصوصية السياق الكوردي، حيث لا يمكن للكلمة أن تكون بريئة. فكل خبر هو موقف، وكل مقال هو جبهة، وكل نشرة هي سلاح. لقد علمت الصحافة الكوردية الكوردَ كيف يقولون "لا" حين كان الصمت هو السياسة الرسمية، وكيف يكتبون أنفسهم من جديد، لا بوصفهم ضحايا فقط، بل فاعلين في سردية العالم.
سادساً: المثقف الكوردي بين الحياد والمقاومة
في خضمِّ الصراع الوجودي الذي خاضه الشعب الكوردي، لم يكن للمثقف الكوردي ترف الانعزال، ولا إمكانية التموضع في موقع "الحياد الموضوعي" الذي تتغنّى به بعض المدارس الصحفية الغربية. لقد وجد نفسه ـ بحكم الواقع والتاريخ واللغة ـ في قلب المأساة، وعلى حافة السكين. وهكذا، أصبح الصحفي الكوردي مثقفاً عضوياً بامتياز، كما وصفه أنطونيو غرامشي: مثقفاً منخرطاً في معركة تحرير شعبه، لا مجرد ناقلٍ للحدث أو محللٍ للواقع.
- الصحفي كمثقف عضوي (بتعبير غرامشي):
يرى غرامشي أن "المثقف العضوي" هو ذاك الذي لا يكتفي بموقعه في البنية الثقافية للمجتمع، بل يشارك في بناء الوعي الجمعي، ويتحوّل إلى جزء من الصراع الطبقي والسياسي. في السياق الكوردي، يمكن القول إن الصحافة كانت المنصة الأساسية التي أنتجت هذا النمط من المثقفين، والذين اندمجوا في قضايا الناس، وعبّروا عن آلامهم وآمالهم، وتحوّلوا إلى صوت الجماعة المغيّبة.
لقد كانت مقالات الصحفيين الكورد تفيض بألم الجبال، وحنين القرى المحروقة، وشوق المنفى، وقهر اللغة المحظورة. لم تكن مجرد تقارير صحفية، بل بيانات وجدانية لمثقفين ملتزمين بقضايا التحرر، يدفعون ثمن كلماتهم من حريتهم وحياتهم أحياناً.
الصحفي الكوردي لم يكن مراقباً محايداً، بل شاهداً ومتهماً في آن. لم يكن وسيطاً بين الحدث والجمهور، بل فاعلاً في الحدث نفسه. وهكذا، صار المثقف الكوردي ابناً للصحافة، والمثقف ـ الصحفي هو بطل الثقافة الكوردية المعاصرة.
- حدود الحرية في ظل الأنظمة الشمولية:
عمل الصحفيون الكورد لعقود طويلة في ظل أنظمة شمولية تحظر اللغة، وتجرّم الهوية، وتُراقب الكلمة، وتُسجن القلم. في هذه الأنظمة، كانت الصحافة فعلاً شبه مستحيل، وكانت حرية التعبير نادرة كالمطر في صيف الجبال.
لذا، كان على المثقف الكوردي أن يُراوغ، أن يكتب بالرمز، أن يستعين بالشعر، أن يحوّل الواقع إلى أسطورة لكي يمرّ بها عبر الرقابة. وكان عليه أن يختار بين المنفى الداخلي أو المنفى الخارجي، بين الصمت المذل أو الاعتقال المشرّف.
لقد تحولت الحرية الصحفية من حقّ قانوني إلى حلم وجودي، ومن مساحة للجدل إلى ميدان للمخاطرة. فالصحافة الكوردية لم تعمل أبداً في ظل فضاء ديمقراطي، بل في زمن الطوارئ المستمر، حيث تُلغى الحدود بين المثقف والسجين، بين المقال والحكم القضائي.
هذه القيود لم تُضعف الصحافة، بل صقلتها. من قسوة الظروف وُلدت بلاغة المقاومة، ومن قمع الحرية نشأت ثقافة التحدي، ومن اختناق الحبر انفجر الشعر والنثر والصراخ.
- ثنائية "السلطة والمعارضة" في الخطاب الصحفي الكوردي:
من الملامح اللافتة في تطور الصحافة الكوردية، هو تموضعها التاريخي في موقع المعارضة. إذ لم تكن هناك "سلطة كورديّة" مركزية يمكن للصحافة أن تنتقدها أو تدافع عنها في معظم مراحل التاريخ الحديث، بل كانت هناك سلطات خارجية تهيمن على القرار والمصير، وتمنع وجود صحافة حرة.
لكن، مع تطور الحركة السياسية الكوردية، وخاصة في بعض الكيانات شبه المستقلة أو مناطق الإدارة الذاتية، ظهرت ملامح صحافة السلطة، مقابل استمرار الصحافة المعارضة. وهنا، واجه المثقف الكوردي تحدياً جديداً: كيف يكون مناصراً لقضية شعبه دون أن يتحوّل إلى بوق للسلطة الناشئة؟
لقد بدأت تتشكل ثنائية داخلية في الخطاب الصحفي الكوردي: بين خطاب رسمي يبرّر، وخطاب نقدي يفضح. وبين مثقف "تابع" يبرر قرارات الأمر الواقع، ومثقف "عضوي" يُصر على أن الحرية لا تتجزأ، وأن انتقاد الذات جزء من المقاومة أيضاً.
وهكذا، انتقلت معركة الصحافة الكوردية من مواجهة الرقابة الخارجية، إلى صراع داخل الجسم الكوردي نفسه: هل يمكن لصحافة قومية أن تبقى حرة؟ وهل يمكن للمثقف المناضل أن يحاسب رفاقه في السلطة؟
هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة، وتشكل أحد أبرز تحديات المرحلة المقبلة من تطور الصحافة الكوردية.
في الختام، إن الصحافة الكوردية، من خلال مثقفيها، لم تكتفِ بنقل الأحداث أو التعليق عليها، بل ساهمت في صنع التاريخ الكوردي الحديث. فالمثقف الكوردي لم يكن حارساً على باب السلطة، بل كاشفاً لزيفها. لم يكن محايداً، بل منحازاً إلى المقهورين. لم يكن أداةً بيد الدولة، بل لساناً للذين لا صوت لهم.
لقد جسدت الصحافة الكوردية أحد أجمل تعبيرات "المثقف العضوي"، الذي لا يسكن في برج عاجي، بل يعيش في الجبال، ويُطبع في السر، ويُعتقل في العلن، ويكتب بدمه إن لزم الأمر.
سابعاً: الكلمة كفعل مقاومة
"اللغة هي بيت الكينونة" كما يقول هايدغر. وحين يُجتثّ الإنسان من لغته، يُسلَب من وجوده. لا يمكننا أن نفهم الصحافة الكوردية بوصفها مجرد نشاطٍ مهنيّ أو إعلامي، بل هي قبل كل شيء فعلٌ وجوديٌّ في وجه النفي، وصرخةٌ ضد العدم، وممارسةٌ رمزية لمقاومة الإبادة الثقافية. إنها ليست فقط وسيلة لنقل الأخبار، بل وسيلة لتثبيت الوجود ذاته. في هذا الفصل، نقرأ الصحافة الكوردية من منظور فلسفي نقدي، من هايدغر إلى فوكو، مروراً بكل معارك اللغة ضد الإقصاء والتهميش.
- من هايدغر إلى فوكو: اللغة، السلطة، والكينونة
يتعامل هايدغر مع اللغة باعتبارها المكان الذي تسكن فيه الكينونة. نحن لا نعيش في العالم أولاً ثم نستخدم اللغة، بل نحن نوجد من خلال اللغة. الكوردي حين يتكلم بلغته، فهو لا يُعبّر فقط، بل يُوجِد نفسه في العالم. لذلك، فإن قمع اللغة الكوردية في التاريخ الحديث، لم يكن مجرد سياسة تعليمية أو إجراء إداري، بل كان اعتداءً على كينونة جماعية.
أما ميشيل فوكو، فربط اللغة بـالسلطة والمعرفة. اللغة ليست أداة بريئة بل تُنتج أنظمة الهيمنة والمعرفة والسيطرة. الخطاب – كما يرى فوكو – لا يصف الواقع فقط، بل يصنعه. في هذا السياق، يمكن النظر إلى الصحافة الكوردية بوصفها ممارسة خطابية تقف في وجه إنتاج "الحقيقة الرسمية" التي تفرضها السلطات المركزية على التاريخ والجغرافيا والهوية.
الصحافة الكوردية إذاً ليست مجرد استعادة للغة، بل تفكيك للخطاب السلطوي وبناء لخطاب بديل. هي مواجهة بين سلطة تُقصي، ولسانٍ يرفض أن يُطمس. بين دولة تصنع "الرواية الواحدة"، وصوتٍ يريد أن يُعيد للإنسان حقيقته وكينونته.
- الصحافة الكوردية كفعل وجودي في وجه العدم
في واقعٍ تُحرَق فيه القرى، وتُغيَّب الجغرافيا من الخرائط، ويُمنع الاسم الكوردي في شهادة الولادة، تُصبح الصحافة أكثر من مهنة: تغدو مقاومة وجودية.
أن تُنشر جريدة بالكوردية في المنفى، أو أن تُوزَّع نشرة سريّة في الأزقة، أو أن يُكتب مقال عن مأساة شعبك... كل ذلك ليس رفاهية فكرية، بل معركة مع العدم. معركة ضد محاولة تحويل الكورد إلى "جماعة بلا تاريخ، بلا لغة، بلا ذاكرة".
الصحفي الكوردي لا يكتب ليُقنِع، بل ليقول "أنا موجود". الكلمة هنا ليست حبراً، بل تجسيد للذات ضد العدم. كل مقال، كل افتتاحية، كل قصيدة تُنشَر، هي بمثابة شاهد قبر فوق ركام الإبادة الرمزية.
حتى الصمت الذي فرضته السلطات، كان يُجابَه أحياناً بكلمةٍ واحدة مكتوبة على الجدران: "ئهمه ههن" (نحن هنا). لم تكن الكلمة زينة لغوية، بل صرخة وجودية تشبه حجراً يُرمى في وجه العدم.
- مقاومة الإبادة الرمزية عبر الخطاب
من أخطر ما واجهه الكورد، لم تكن الإبادة الفيزيائية فقط، بل الإبادة الرمزية: محو الذاكرة، تشويه اللغة، مصادرة الحكاية. هنا، لعبت الصحافة دوراً محورياً في مواجهة هذا النوع من الفناء.
لقد أعادت الصحافة الكوردية كتابة الذات الكوردية، واستعادت الوجوه التي حاول التاريخ طمسها، والقصص التي حوّلتها الأنظمة إلى فراغ. المقال الصحفي صار أرشيفاً مضاداً، ودفتراً بديلاً لوقائع شعب لا تذكره الكتب الرسمية.
حتى حين كانت الإمكانات شحيحة، ظلّ الخطاب الصحفي الكوردي يقاوم بلغة الحبر والورق والفم، رافعاً جداراً رمزياً ضد العدم.
وهكذا، تحوّلت الكلمة إلى خندق دفاع، وإلى ممارسة يومية للمقاومة. لم تكن المقاومة بالسلاح وحده، بل كانت الكلمة أيضاً سلاحاً رمزياً يُخيف الطغاة، ويُغذّي ذاكرة الجماعة.
ففي عالمٍ يُقمع فيه الاسم، ويُجرَّم الحرف، يُصبح "الخطاب" ساحة حرب، والكلمة آخر قلاع الوجود.
في الختام، إن قراءة الصحافة الكوردية من هذا المنظور تكشف عن عمقها الفلسفي ووجوديتها الرمزية. الكلمة لم تكن مجرد وسيلة للتواصل، بل مكاناً للمقاومة، ومأوى للكينونة، ومنصة للرفض.
لقد واجه الكورد عدواناً على لغتهم، وتزييفاً لتاريخهم، وإنكاراً لوجودهم. وكان ردّهم الأكبر هو: أن يكتبوا.
أن يكتبوا، رغم الحظر. أن ينشروا، رغم الرقابة. أن يصرخوا، رغم العتمة.
أن يقولوا — ببساطة عميقة: "نحن هنا... ونكتب".
ثامناً: اللغة الكوردية والصحافة – التوازي البنيوي
منذ بداياتها، لم تكن الصحافة الكوردية مجرد حاملة للمضامين، بل كانت تُشكّل في ذاتها بنية مقاومة موازية لبنية اللغة الكوردية. لم تكن العلاقة بين الصحافة واللغة علاقة وسيطٍ بمحمول، بل كانت علاقة تكوينية تبادلية: فكما كانت الصحافة وسيلة للتعبير باللغة الكوردية، كانت اللغة هي الأخرى تتشكّل وتتبلور داخل جسد الصحافة. وفي هذا التوازي البنيوي، نرى كيف تتحول اللغة من أداة إلى كيانٍ، ومن وسيلة إلى هوية، ومن حاملة للمعنى إلى حاملٍ للذاكرة.
- اللغة كهوية: من اللسان إلى الكينونة
اللغة الكوردية، كما أشار الكثير من الفلاسفة وعلماء اللسانيات، ليست مجرد نسق من الأصوات والمفردات، بل هي هوية متجسدة. فالانتماء إلى شعبٍ مُستَلب الأرض، محروم من الدولة، يَمنح للغة وظيفةً إضافية: أن تكون الدولة الرمزية للكورد.
في الصحافة الكوردية، كانت اللغة دائماً مرآةً للذات الجمعية، تُعيد تشكيل الوعي، وتُقنِّن الانتماء، وتُجدّد التاريخ. لم تكن اللغة مجرد وسيلة للإخبار، بل كانت مساحةً لإعادة تعريف "من نحن"، و"ماذا نُريد"، و"بِمَ نحلم".
ولهذا السبب، كانت محاربة اللغة الكوردية تُعادِل محو الهوية، والكتابة بها تعني مقاومة الاستيعاب والطمس.
- تحديات الكتابة بالكوردية: الأبجدية، اللهجات، والقمع:
- الأبجدية: ثلاث لغات في لسانٍ واحد
نتيجة للواقع السياسي والجغرافي المتشظي، وُجدت اللغة الكوردية في ثلاث أبجديات:
- العربية (في سوريا والعراق)
- اللاتينية (في تركيا، ومعظم المهاجرين)
- السريالية (في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة)
هذا التعدد الأبجدي أربك مسار التوحيد اللغوي، وجعل كل منطقة تكتب وتقرأ بلغتها وأبجديتها الخاصة. وهنا حاولت الصحافة أن تلعب دوراً تكاملياً، فبعض المجلات والجرائد نشرت نسخاً متعددة أو استعملت رموزاً هجينة لتقريب الهوات بين الأبجديات.
- اللهجات: سوراني، كرمانجي، زازا، لوري...
أدى التنوع اللهجي إلى إشكاليات في التواصل العام. ولكن الصحافة، بدورها، كانت مختبراً لغوياً، تجرّبت فيه اللهجات، ثم صيغت لغة معيارية هجينة، تحاول الجمع بين الفصاحة والعمومية.
- القمع: الكلمة المحرّمة
لم يكن التحدي فقط لغوياً، بل سياسياً وأمنياً. في كثير من الفترات، كان يُمنع استخدام اللغة الكوردية حتى في الأحاديث الخاصة، فكيف في الصحف؟
كانت الصحافة الكوردية تكتب تحت الحظر، ضد الرقابة، وغالباً في المنفى أو السرّ. ومع ذلك، استمرت، واستطاعت أن تخلق تراثاً صحفياً غنياً رغم المنع.
- دور الصحافة في توحيد وتثبيت اللغة:
إن أهم أدوار الصحافة الكوردية لم تكن فقط سياسية أو إعلامية، بل كانت لغوية ومعرفية. فالصحافة لعبت دوراً محورياً في:
- تثبيت المصطلحات وتوحيد الاستخدامات
- نشر اللغة المكتوبة على نطاق أوسع
- تحويل اللغة من استعمال شعبي شفهي إلى استعمال رسمي ثقافي
لقد ساعدت الصحف على صقل معجم كوردية حديثة: سياسية، فكرية، تقنية. ومن خلال الحوار اليومي والمقال والتحقيق، ساهمت في خلق وعي لغوي جماعي، ودفعت نحو التركيز على لغة مشتركة تتجاوز الجغرافيا واللهجات.
كما كانت الصحافة أيضاً منبراً للمثقفين اللغويين، الذين ناقشوا قضايا النحو، الترجمة، المصطلحات، ونشروا رؤاهم حول لغة موحدة. كان هناك وعيٌ متزايد بأن الوحدة اللغوية شرط أساسي للوحدة القومية، وأن الصحافة هي الحاضنة الأهم لهذا المشروع.
في الختام، في التاريخ الكوردي، لم تكن الصحافة مجرّد ناقلٍ للأحداث، بل كانت اللسان الذي نَحت اللغة من الحصار، وجعلها قابلة للحياة، والتداول، والكتابة.
وفي بلدٍ حيث يُحظَر فيه الحرف، وتُجرّم المفردة، تُصبح كل جملة مطبوعة بالكوردية عملاً بطولياً، وكل صحيفة أداةً لتوحيد اللغة، وحمل الوعي، وتثبيت الكينونة.
إن العلاقة بين الصحافة واللغة الكوردية لم تكن علاقة تبعية، بل علاقة تكافؤ وتضامن. كلاهما خاض حرباً ضد النسيان، وكانا معاً رئةً للوجود الكوردي في عالمٍ حاول خنقه.
تاسعاً: المرأة الكوردية والصحافة – صوت الهامش في قلب الكلمة
إذا كانت الصحافة الكوردية منذ ولادتها تمثّل فعلاً مقاوماً للسلطة والقمع، فإنّ مشاركة المرأة الكوردية في هذا المجال تمثّل مقاومة مزدوجة: مقاومة ضد أنظمة القمع السياسي والرقابة القومية، ومقاومة ضد السلطة الذكورية والبنى الأبوية التي غالباً ما حاولت تهميش صوتها. لقد تحوّلت المرأة الكوردية، من موضوع للكتابة في الصحف، إلى كاتبة، محررة، وفاعلة لغوية وسياسية، تخترق الممنوع، وتقول "أنا" بلغتها ونيابة عن مجتمعها.
- من التمثيل إلى الفاعلية: تحوّلات صورة المرأة في الصحافة الكوردية
في بدايات الصحافة الكوردية، ظهرت المرأة غالباً في الخطابات الرومانسية أو الوطنية، إما كرمز للأرض، أو كأم مناضلة، أو كمعشوقةٍ وطنية. كانت تُستَحضَر في النصوص، لكنها نادراً ما كتبتها.
لكن مع تحوّلات الزمن، وخصوصاً في المنفى والمناطق التي شهدت ثورات اجتماعية، بدأنا نرى ظهور أسماء نسائية حقيقية في العمل الصحفي الكوردي، لا كرمز بل كصوت.
من هؤلاء، من خاضن معارك مزدوجة: التحرر الوطني والتحرر الجندري، وكتبن عن المرأة ليس فقط باعتبارها ضحية للسلطة، بل كقوة نضالية، تقاوم بالنص والكلمة والموقف.
- الصحافة النسوية الكوردية: الولادة من رحم النضال
لقد نشأت صحافة نسوية كوردية من واقع المعاناة، لا من نظرية مستوردة. كانت المرأة الكوردية تقاتل في الجبل، وتكتب في الكهف، وتوزّع المنشورات في الخفاء، وتخوض الحوارات عن الجندر على صفحات جرائد المعارضة والمنفى.
المجلات الكوردية النسوية، لم تكن فقط فضاءً للحديث عن الجندر، بل عن القومية، واللغة، والحق، والحب، والشتات.
وكان من بين رموزها نساء تحدين كل شيء: الحجاب المفروض، الزواج القسري، اللغة المحظورة، وحتى الموت.
لقد مثلت الصحافة النسوية الكوردية تحولاً في بنية الخطاب:
- من الحديث عن المرأة إلى الحديث من المرأة.
- من تمثيل رمزي إلى فاعلية لغوية.
- من الهامش إلى القلب.
- تحديات مزدوجة: بين السلطة الذكورية والنظام القومي القامع
المرأة الكوردية الصحفية كانت دوماً في مرمى النيران من جهتين:
- من جهة، القمع السياسي الذي لا يرحم أي صوت كوردستاني حر، خاصة إن كانت امرأة.
- ومن جهة أخرى، المجتمع الأبوي الذي يُصادر صوتها، ويمنح الرجال الحق في احتكار الحديث باسم "القضية".
هذا الوضع أنتج خطاباً نسوياً مقاوماً، أكثر وعياً بالهويات المتقاطعة، وأكثر جرأةً في تسمية الأعداء الحقيقيين:
"القامع ليس فقط الدولة، بل كل من يحرمنا من الكلام – بما فيهم من يدّعي أنه يدافع عن قضيتنا!"
- من الجسد إلى النص: المرأة الكوردية تكتب ذاتها
في الثقافة الكوردية التقليدية، حُصرت المرأة في الجسد: كزوجة، كأم، كعار يجب ستره، أو جمال يجب تزويجه. لكن في الصحافة، بدأت المرأة تكتب عن جسدها كأرض سياسية، وعن حياتها كسيرة مقاومة، وعن الحب من منظورها، وعن الأمومة كفعل نضالي.
وهكذا تحوّلت الكلمة إلى جسدٍ بديل، والنص إلى مجال حريةٍ جديد.
لم تَعُد الكتابة فقط "عن الحياة"، بل أصبحت هي الحياة البديلة التي تصوغ فيها المرأة حريتها الجديدة.
في الختام، إن الحديث عن الصحافة الكوردية دون الحديث عن المرأة، هو إعادة إنتاج للإقصاء نفسه الذي قاومته الصحافة الكوردية منذ بداياتها.
فالمرأة الكوردية لم تكن فقط ضحيةً لسياسات الإنكار، بل كانت في مقدمة من قالوا "لا"، وفي طليعة من كتبوا، وحرّروا، وأطلقوا الكلمات في وجه الصمت.
الصحافة النسوية الكوردية ليست مجرد فصل من فصول النضال، بل هي لغةٌ ثالثة، تنبني على أنقاض الصمت، وتبني للهوية الكوردية جسداً أكثر شمولاً، وعدالةً، وتعدداً.
عاشراً: أخلاقيات الصحافة الكوردية – التزام، لا حياد
■ من يكتب لمن؟ سؤال الضمير
في عالم الصحافة، يُفترض أن يكون الصحفي شاهداً لا فاعلاً، مراقباً لا محرّضاً، ناقلاً لا مؤوِّلاً. لكن حين تكون الأمة مهددة، واللغة مقموعة، والتاريخ مشوّهاً، ينقلب السؤال من "ما الذي حدث؟" إلى "من يكتب لمن؟ ولماذا؟". وهنا، لا يعود الحياد قيمةً عليا، بل يصبح موقفاً أخلاقياً مريباً، لأن ما يبدو "حياداً" في ظل القمع، هو في جوهره شكلٌ من أشكال التواطؤ.
في السياق الكوردي، حيث الهوية نفسها موضوع نزاع، تصبح الكلمة ليست فقط أداة تعبير، بل أيضاً أداة نضال أو خيانة. فالصحفي الكوردي لا يكتب من برج عاجي، بل من خندق ثقافي. ولهذا كان الضمير دوماً هو الفصل بين الكتابة كمسؤولية، والكتابة كوظيفة.
"من يكتب لمن؟" ليس سؤالاً بلاغياً، بل هو مفتاح أخلاقيات الصحافة الكوردية، لأن الصحفي لا يكتب لجمهور محايد، بل لشعب ينزف، ولمجتمع يعيد اختراع ذاته، ولمقاومة تُولد من الحرف مثلما تولد من السلاح.
■ الصحفي الكوردي بين الحقيقة والمصلحة الحزبية
من أخطر التحديات التي واجهتها وتواجهها الصحافة الكوردية هي العلاقة المركبة بين الصحفي والأحزاب السياسية الكوردية. فالكثير من الصحف الكوردية تأسست في رحم التنظيمات السياسية، مما جعل الخط التحريري مشروطاً بولاءٍ مسبق. وهكذا، وجد الصحفي الكوردي نفسه ممزقاً بين ولائه للحقيقة وولائه للحزب.
في البيئات التي تندر فيها المؤسسات الإعلامية المستقلة، يصبح الصحفي رهينة تمويل حزبي، وتوجيه أيديولوجي، مما يحوّل الخبر إلى بيان، والتحقيق الصحفي إلى بروباغندا، والمقالة إلى أداة تصفية سياسية.
غير أن هذا الواقع لا يعفي الصحفي من المسؤولية الأخلاقية. ففي خضم هذا الانقسام، ظهرت تجارب صحفية مستقلة وشجاعة، حاولت إعادة الاعتبار إلى المعايير المهنية. لكنها اصطدمت بواقع يتداخل فيه الصحفي بالمقاتل، والمحرر بالناطق باسم الفصيل، والناقد بالعدو.
إن السؤال الأخلاقي هنا ليس فقط: "هل تقول الحقيقة؟" بل أيضاً: "هل تقول الحقيقة التي لا تُرضي ممولك؟" وهذه، في السياق الكوردي، معضلة كبرى في أخلاقيات الصحافة.
■ أخلاقيات "الانتماء" في الخطاب الصحفي الكوردي
بخلاف النموذج الليبرالي الغربي الذي يُشيد بـ"الحياد الموضوعي"، فإن الصحفي الكوردي يتحرك في أرضٍ لا تزال فيها الانتماءات جزءاً من الوجود وليس فقط من الهوية. وفي هذا الإطار، يُصبح الانتماء – حين لا يُفسد المهنية – شكلاً من أشكال الشرف الأخلاقي.
الصحفي الكوردي الذي يكتب بالكوردية، عن الكورد، من أجل مستقبلٍ كوردستاني، لا يُعد "غير مهني"، بل قد يكون أكثر صدقاً ممن يدعي الموضوعية وهو ينقل رواية المحتل. فالانتماء هنا ليس تحيزاً، بل اعترافاً بالواقع ووقوفاً في صف الضحية.
ومع ذلك، فإن هذا الانتماء لا يُعفي الصحفي من احترام معايير الحقيقة، ولا يمنحه حق التضليل باسم القضية. بل يجب أن يكون انتماءً نقدياً، يرى العيوب داخل الذات الكوردية، ويُعرّيها، لا حباً في جلد الذات، بل حفاظاً على قيم النضال ذاتها.
إن أخلاقيات الصحافة الكوردية لا تُبنى على "الحياد البارد"، بل على التزام حارّ بالحقيقة، بالحلم، وبالمجتمع. إنّه انحياز لا للسلطة، بل للضعفاء. لا للتاريخ الرسمي، بل للذاكرة المسروقة. لا للبيان الحزبي، بل للصوت الذي لا يُسمع.
خاتمة: نحو صحافة كوردية حرة ومتحررة
■ الكلمة مشروع تحرر، لا وظيفة فقط
الصحافة، في السياق الكوردي، ليست مجرد مهنة أو وسيلة اتصال، بل هي مشروع تحرر كامل. إنها امتداد للهوية، للمقاومة، للذاكرة، وللحلم. كل كلمة تُكتب بالكوردية، أو من أجل الكورد، في بيئة الاستعمار والرقابة والتشظي، ليست "نصاً"، بل فعلاً سياسياً، وشهادة وجود.
لهذا لا يمكن اختزال الصحفي الكوردي في كاتب خبر أو ناقل معلومة، بل هو فاعل ثقافي ووطني في معركة معقدة؛ معركة ضد التهميش، ضد الإبادة الرمزية، ضد تقنيات محو الذات من النص والزمان والمكان.
فالصحافة الكوردية هي التعبير المدني عن المقاتل، والمثقف، واللاجئ، والمحروم، والمنفي... وهي، حين تكون أمينة لجوهرها، تصبح جسراً بين الماضي المسروق والمستقبل الممكن.
■ استعادة المعنى في زمن التضليل
في عصر ما بعد الحقيقة، حيث يختلط الواقع بالوهم، ويذوب المعنى في بحر من الأخبار المضللة، تصبح مهمة الصحافة الكوردية أكثر من نقل الوقائع؛ إنها مهمة فلسفية وثقافية لاستعادة المعنى.
المعنى الذي سُرق حين اختزلت كوردستان إلى "مشكلة"، وسُجن حين صُورت المقاومة كإرهاب، ودُفن حين مُنعت اللغة من المدارس، والقصائد من الطبع.
الصحافة، في هذا السياق، لا تكتفي بتقويض الرواية الرسمية، بل تعمل على بناء رواية بديلة قادرة على الصمود في وجه التفكيك، قادرة على مخاطبة الآخر دون التماهي معه، وعلى مساءلة الذات دون جلدها.
هي مقاومة للفراغ، للسطحية، للميوعة الإعلامية التي جعلت الحقيقة تُشترى وتُباع. ولهذا، فالصحفي الكوردي، إذا ظل أميناً لرسالة كلمته، يصبح كاهناً للمعنى في معبد مهدد بالخراب.
■ الصحافة الكوردية كجزء من مشروع كوردستان الحديثة
الصحافة ليست قطاعاً معزولاً عن مشروع الدولة أو الأمة، بل هي مرآة هذا المشروع، وركيزته الرمزية. ومن هنا، لا يمكن تصور كوردستان حديثة – متعددة، ديمقراطية، حية – دون صحافة حرة، ناقدة، متحررة من الولاءات الضيقة.
كوردستان الحديثة لا تحتاج فقط إلى مقاتلين، بل أيضاً إلى صحفيين يقاتلون بالحرف، لا يُجردون الحقيقة من سلاحها النقدي، ولا يجعلون من الصحافة ممراً للدعاية.
إنّ المشروع الكوردي الحديث بحاجة إلى صحافة:
- تكتب بالكوردية، لا كواجب لغوي، بل كاحتفاء بالكينونة.
- تكتب من الداخل، ولكن بعين نقدية قادرة على مساءلة الذات والحزب والمجتمع.
- تكتب للمستقبل، ولكن بذاكرة يقظة ترفض النسيان والتدجين.
صحافة تُعيد تشكيل المجتمع من جديد، لا بوصفه جمهوراً سلبياً، بل فاعلاً مدنياً ناقداً ومسؤولاً.
في الختام.. إذا كانت السلطة تَكتب التاريخ، فالمضطهد يَكتب الصحافة.
وإذا كانت الأنظمة الشمولية تزرع الصمت، فإن الكلمة الكوردية تُعيد الصوت إلى اللا مرئيين، والهوية إلى المسلوبين.
لهذا فإن الصحافة الكوردية، كما أردناها في هذا البحث، ليست سرداً عن الماضي فقط، بل خطة عمل من أجل الغد.
فلتكن الكلمة بداية التحرر، لا نهايته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Badrkhan, Miqdad Madhat. Kurdistan: The First Kurdish Newspaper in Exile, Archival Edition, Istanbul, 1898.
- The Kurdish Press: Its Origins and Development. Baghdad: Dar Al-Hurriya for Printing, 1978.
- The History of Kurdish Journalism in the Twentieth Century. Erbil: Ministry of Culture, Kurdistan Regional Government, 2004
- Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. Translated by Albert Hofstadter. Harper Perennial Modern Classics, 2001.
- Said, Edward. Representations of the Intellectual. Vintage Books, 1996.