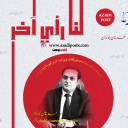بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
مقدمة:
الأدب هو مرآة الشعوب، صوتها، ذاكرتها الحية، ومستودع مشاعرها وأفكارها وقيمها. وإذا كان الأدب المحلي يعكس خصوصيات ثقافية واجتماعية معينة، فإن الأدب العالمي هو المساحة التي تتلاقى فيها الثقافات، وتتجاور فيها الحكايات الإنسانية رغم اختلاف الألسن والحدود. إنّه تعبير عن الكوني في الإنسان، عن تلك التجربة المشتركة التي يخوضها البشر رغم تنوّعهم. ولكن، ما الذي نعنيه تحديداً بمصطلح "الأدب العالمي"؟ ولماذا نقرأه؟ وما التحديات التي تقف في طريقه؟
لطالما كان الأدب أكثر من مجرد كلمات مرصوفة أو حكايات تُروى للترفيه، بل هو البعد الروحي والثقافي الأعمق في حياة الشعوب؛ إنه الذاكرة الجمعية التي تختزن الانفعالات الكبرى، والتحولات الحاسمة، والهموم اليومية، والآمال البعيدة. هو مرآة الهوية، وصرخة الوجود، وهمس المعنى الذي يتوارى خلف ضجيج الوقائع. في طيّات النصوص الأدبية تختبئ أنفاس المدن القديمة، وأحلام العشاق، وصرخات الثائرين، وصلوات المنفيين، وذكريات الأطفال الذين كبروا على هامش التاريخ.
وإذا كان الأدب المحلي يُجسّد تفاصيل المكان بلغة القلب، ويعكس صورة المجتمع في مراياه الداخلية، فإن الأدب العالمي هو ذلك الجسر العميق الممتد بين الثقافات، الذي يربط الضفاف المتباعدة للتجربة الإنسانية، ويمنح للغريب فرصة أن يصير قريباً، وللآخر أن يصبح شبيهاً. الأدب العالمي ليس مجرد أدب تُرجم إلى أكثر من لغة، بل هو ذلك النص القادر على العبور، على التحول، على التغلغل في الوجدان الإنساني المشترك، وتجاوز العوائق الجغرافية واللغوية والزمانية.
في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث، وتتقلص فيه المسافات، ويصبح الإنسان جزءاً من شبكة معلوماتية ضخمة تتقاذفه بين العناوين واللغات، يبرز الأدب العالمي كأداة مقاومة لهذا التفتت، وكوسيلة للعودة إلى الجذر الإنساني المشترك. إنه صوت الإنسان حين يتكلم إلى الإنسان، متجاوزاً الفروق، ومعترفاً بالتنوّع لا بوصفه تهديداً، بل ثراءً ضرورياً لفهم الذات والكون.
ولعل جوهر الأدب العالمي لا يكمن فقط في تنوع ألسنته أو انفتاحه على القرّاء عبر القارات، بل في قدرته على إثارة الأسئلة الكبرى: من نحن؟ لماذا نتألم؟ ماذا يعني أن نحب؟ كيف نعيش مع الآخر؟ ما معنى أن نكون في هذا العالم؟ هذه الأسئلة لا تخصّ ثقافة دون أخرى، بل هي صميم الإنسان في كل مكان.
ووسط كل هذا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في هذا المفهوم المعقد: ما الذي نعنيه حقاً بـ"الأدب العالمي"؟ هل هو تصنيف نخبوي تحتكره النظم الأدبية الكبرى؟ أم هو حالة كونية تنشأ حين يلتقي النص بوجدانٍ لا يعرف الحدود؟
ثم، ما الفائدة الحقيقية من قراءته؟ أهي فقط ثقافية ومعرفية؟ أم أنّ هناك بعداً أخلاقياً وإنسانياً يتجاوز المتعة والفائدة؟
وأخيراً، ما التحديات البنيوية والثقافية والاقتصادية التي تعيق تحققه، وتحول دون أن يُسمع صوت الجنوب كما يُسمع صوت الشمال، وأن تترجم القصيدة الكوردية أو الأمازيغية أو البورمية بنفس الحماسة التي تُترجم بها رواية أوروبية أو أمريكية؟
إنّ محاولة الغوص في مفهوم الأدب العالمي ليست مجرّد تمرين نظري، بل هي فعل من أفعال الوعي الكوني، وصرخة ضد الانغلاق، ودعوة لتوسيع المدارك، والانصات لا لذاتنا وحدها، بل لصوت الآخر فينا. في هذا البحث، نسعى لتفكيك المفهوم، وتتبع أصوله، واستكشاف فوائده، والغوص في تحدياته، في محاولة لفهم كيف يمكن للكلمة أن تصبح وطناً عابراً، وكيف يمكن لحكاية وُلدت في قريّة صغيرة، أن تُقرأ كأنها تتحدث عنّا، جميعاً، مهما تباعدت المسافات.
أولاً: تعريف الأدب العالمي
1- المصطلح والنشأة:
ظهر مصطلح "الأدب العالمي" (World Literature) في أوائل القرن التاسع عشر، ونُسب ظهوره أول مرة إلى الأديب الألماني يوهان فولفغانغ غوته، الذي استخدمه في رسائله وأحاديثه، مشيراً إلى أن زمن الأدب القومي قد أزف نهايته، وأن الأدب العالمي قد بدأ.
قال غوته:
"الأدب القومي لم يعد كافياً، لقد آن الأوان للأدب العالمي".
وقد ربط غوته هذا المفهوم بانفتاح الثقافات على بعضها عبر الترجمة، والتبادل الفكري، وحرية السفر والتنقل بين اللغات. ومن هنا، نشأ الأدب العالمي كفكرة تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.
2- التعريف الإجرائي للأدب العالمي
حين نتحدث عن "الأدب العالمي"، لا نعني بذلك مجرد مجموعة من الكتب التي نُقلت إلى لغات أخرى، ولا قائمة من الكتّاب الذين حظوا بشهرة عابرة للحدود، بل نشير إلى ظاهرة ثقافية معقدة تتداخل فيها عناصر الترجمة، التلقي، التأويل، والسياسة الثقافية. ولهذا، فإن أي تعريف للأدب العالمي لا بد أن يكون إجرائياً، أي قائماً على الوظيفة التي يؤديها النص، لا على موطنه أو لسانه.
يمكن تعريف الأدب العالمي بأنه ذلك الـcorpus الأدبي المتنوع، متعدد الأصول واللغات، الذي يُقرأ ويُدرّس ويُناقش خارج الإطار الجغرافي أو الثقافي الذي وُلد فيه. هو الأدب الذي ينجح، في لحظة ما، في تجاوز شرطه المحلي، ليصبح موضع اهتمام في سياقات أخرى، في جامعات بعيدة، ومكتبات رقمية شاسعة، ومنصات عالمية للنشر والحوار.
وما يمنح هذا الأدب صفة "العالمية" ليس فقط ترجمة النصوص أو تداولها، بل قدرتها على ملامسة القضايا الإنسانية الكبرى: الحب، الموت، الحرية، الاغتراب، الهوية، العدالة، الصراع، المنفى، الخوف، التوق إلى المعنى. إنها موضوعات تتخطى الانتماء الضيق، وتُحاكي الإنسان في هشاشته وقوّته، في حيرته وقدرته على الحلم، مهما كان موضعه من الجغرافيا.
بمعنى آخر، فإن الأدب العالمي هو النص الذي يتجاوز "لغته الأم" ليولد من جديد في لغة أخرى، ويُعاد تأويله في سياقات ثقافية مغايرة، ويُدمج في الذاكرة الثقافية المشتركة للإنسانية. هو الأدب الذي لا يتكل على قوميته أو خصوصيته فحسب، بل يتحول إلى ما يُشبه "الرمز المتنقل"، القابل لأن يُعاد إنتاج معناه، وتفكيك دلالاته، بحسب الزمان والمكان والمُتلقي.
وهنا تكمن المفارقة الجميلة: فكلما كان النص أكثر صدقاً في تمثيله لتجربة محلية خاصة، كلما امتلك إمكانات أوسع لأن يصبح عالمياً، لأن المشترك الإنساني يبرز في تفاصيل التجربة العميقة، لا في تعميماتها. فـ"البؤساء" لفيكتور هوغو ليست مجرد رواية فرنسية، و"ألف ليلة وليلة" ليست حكراً على الثقافة العربية، و"الأم" لمكسيم غوركي ليست بياناً روسياً فقط، بل هي نصوص استوعبت العالم رغم خصوصياتها، لأن الألم والعدالة والحب والفقر مفاهيم لا تعرف الحدود.
إذن، فالعالمية في الأدب ليست صفة جاهزة أو معياراً شكلياً، بل هي سيرورة، عملية ديناميكية تتشكل من خلال:
- الترجمة بوصفها فعلاً ثقافياً لا لغوياً فقط.
- التأويل والتلقي بوصفهما عمليات فكرية تُعيد إنتاج النص في سياقات جديدة.
- الدمج في الأنظمة التعليمية والنقدية والإعلامية حول العالم.
بهذا المعنى، لا يمكن اختزال "العالمية" في شهرة الكاتب أو عدد النسخ المباعة، بل في قابلية نصه للعيش في ذاكرة الآخر، وفي قدرته على أن يُقرأ بعيداً عن شروطه الأولى، دون أن يفقد روحه.
3- خصائص الأدب العالمي:
إن الأدب العالمي ليس كياناً مغلقاً أو متجانساً، بل هو فضاء حي ومفتوح، تتقاطع فيه الحساسيات الإنسانية والتجارب المتباينة، ليشكل نسيجاً غنياً يتجاوز الانتماء الأحادي، وينفتح على تعددية المعنى والهوية. ويمكن تمييز الأدب العالمي بعدد من الخصائص الجوهرية التي تُميّزه عن غيره من أنماط الكتابة الأدبية، وتمنحه صفته العابرة للقارات والثقافات:
- الكونية: حضور الإنسان كفكرة لا كهوية
الخاصية الأولى والأعمق للأدب العالمي هي كونيته، أي قدرته على النفاذ إلى جوهر الإنسان، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو الجغرافي. إنه الأدب الذي يتناول موضوعات تتعلق بتجربة الإنسان الكونية: الحب بكل ما فيه من توق وشقاء، الحرب وما تخلّفه من خراب وجودي، الموت بوصفه سؤالاً فلسفياً يتكرر منذ الأزل، الحرية كحلم لا يخبو، الاغتراب كحالة وجودية يعيشها كل فرد مهما اقترب أو ابتعد، والعدالة والقهر كصراع أبدي بين القيم والبنى السلطوية. هذه الموضوعات لا تنتمي إلى ثقافة بعينها، بل إلى التجربة الإنسانية في جوهرها.
- التنوع الثقافي: فسيفساء الرؤى والأنساق
يتميّز الأدب العالمي أيضاً بـتنوعه الثقافي، إذ لا ينطلق من رؤية واحدة للعالم، بل يعكس فسيفساء حضارية متشابكة. فبين نصّ صيني قديم يتأمل في الزمن، ورواية أفريقية تتحدث عن الاستعمار، وقصيدة لاتينية تصف الحنين، ونص كوردي يحتفي بالأرض والهوية، تتعدد المناظير وتتغاير الحساسيات. هذا التنوع لا يُفقر الأدب بل يُغنيه، ويجعل منه مختبراً إنسانياً لفهم الآخر من الداخل، من خلال لغته ومجازاته وأساطيره. فالعالمية لا تعني التنميط أو الذوبان، بل الاعتراف بالاختلاف والاحتفاء به.
- الترجمة كوسيط وجودي: عبور النص إلى حياة أخرى
لا يمكن الحديث عن أدب عالمي دون التطرّق إلى الترجمة، التي تمثل الوسيط الحيوي الذي يسمح للنص بأن يولد من جديد في لغات وثقافات مغايرة. فالترجمة ليست مجرد نقل ميكانيكي للكلمات، بل هي إعادة خلق للنص في سياق ثقافي مختلف، وفي كثير من الأحيان، يكون المترجم هو الكاتب الثاني للنص، يضفي عليه حساسية جديدة دون أن يُفرّغ معناه الأصلي.
إن الترجمة هي التي منحت "كافكا" صوته العالمي، و"محمود درويش" لغته في الفرنسية، و"ماركيز" حضوراً في الشرق، وهي الجسر الذي به يتحول الأدب من فعل محلي إلى خطاب عالمي.
- قابلية التأويل: تعددية المعنى والانفتاح
تتمتع النصوص التي تُصنّف ضمن الأدب العالمي بقدر كبير من قابلية التأويل، إذ تستطيع أن تنتج معاني متعددة بحسب القارئ وسياقه الثقافي والمعرفي. فالرواية التي كُتبت في أمريكا اللاتينية قد تُقرأ في اليابان بوصفها نقداً للحضارة، وقد تُقرأ في الشرق الأوسط كأداة لتفكيك السلطة.
إنّ هذا التعدّد في التأويل ليس ضعفًا، بل قوة رمزية، تدل على عمق النص واتساع أفقه. كل قراءة تعيد كتابة النص بطريقتها، وكل قارئ هو مفسّر ومعماري جديد للمعنى. وهنا يظهر البعد الفلسفي للأدب العالمي: هو النص الذي لا ينغلق على قراءة واحدة، ولا يكتمل بمعنى واحد.
بهذه الخصائص الأربع، يتضح أن الأدب العالمي ليس تجميعاً للنصوص "المشهورة"، بل هو حالة أدبية تتأسس على القدرة على العبور، والتلاقح، والتحوّل، وتحمل في طياتها رؤى متشعبة للعالم، ونداءً دائماً إلى الإنسان، في كل زمان ومكان، ليصغي إلى صوت شبيهه في الآخر.
ثانياً: فوائد قراءة الأدب العالمي
إنّ القراءة ليست مجرّد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هي تجربة وجدانية وروحية تتجاوز حدود النص لتلامس العمق الإنساني في القارئ. وحين نتحدث عن قراءة الأدب العالمي، فنحن لا نتحدث فقط عن المتعة الجمالية أو الفضول الثقافي، بل عن فعلٍ وجودي يمكّن الإنسان من الخروج من ذاته والتقاط أنفاس الآخر.
فالأدب العالمي هو ذلك النهر المتعدد الروافد الذي يصب في محيط الإنسانية، وكل كتاب نقرأه بلغة أخرى (أو مترجماً من لغة أخرى) هو بمثابة نافذة تُفتح على عالم جديد، ومنظور مغاير، وتجربة مختلفة. إنه فعل مضاد للعزلة، ومقاومة للجهل، وتوسيعٌ لمفهوم "الذات" كي تشمل ما هو خارجها.
قراءة الأدب العالمي تمنح القارئ قدرة فريدة على العبور بين الثقافات، وتقوده إلى اكتشاف ذاته من خلال الآخر، وتحفّزه على مساءلة مسلّماته، وتُسهم في بناء وعي نقدي وإنساني يتجاوز الأحكام المسبقة. إنها تغرس في النفس تواضع المعرفة، وتوق التعدد، وجمال الاختلاف.
وفي هذا السياق، يمكن استعراض أبرز فوائد قراءة الأدب العالمي، وأوّلها:
- توسيع الأفق الثقافي: عبور اللغة إلى الذاكرة الكونية:
من أهم وأعمق فوائد قراءة الأدب العالمي هي أنه يوسّع أفق القارئ بطريقة لا تُضاهى. فالإنسان الذي يقرأ أعمال تولستوي أو طاغور أو ناغيب محفوظ أو بورخيس لا يكتفي بتلقي قصة ما، بل يدخل إلى أنسجة ثقافية معقدة، وإلى وعي حضاري مختلف، وإلى طقوس ومرجعيات وتصورات للحياة قد لا تكون مألوفة له.
قراءة الأدب العالمي هي بمثابة رحلة فكرية وعاطفية إلى “داخل الآخر”، الآخر الذي قد يكون من قارة أخرى، أو دين مغاير، أو خلفية تاريخية متموجة، لكنها جميعاً تشكل مرآة يمكن للقارئ أن يرى فيها إنسانيته بطريقة جديدة. إنها كمن يتجول في مدن لم تطأها قدماه، ويأكل من أطباق لا يعرف أسماءها، ويحب في لغات لا يتقنها، ولكنه مع ذلك، يشعر بانتماء عميق وغامض.
في زمن العولمة والتداخل الثقافي السريع، لم تعد المعرفة النمطية عن الآخر كافية، ولا الصور النمطية المنقولة عن الإعلام مبرراً للحكم عليه. وحده الأدب – في صدقه وفرادته – يمنحك فرصة أن تعيش حياة الآخر من داخله، أن تشعر بشكوكه وألمه ولغته وموسيقاه الداخلية.
فعندما نقرأ "ألف ليلة وليلة" أو "الإلياذة"، أو نتتبع خطوات كافكا في دهاليز البيروقراطية الوجودية، أو نغوص في مأساة أفريقية مع تشينوا أتشيبي، فإننا لا نكتسب فقط معرفة بالثقافة أو التاريخ، بل ندخل في حوار عميق مع بنيات العقل والشعور لدى الشعوب الأخرى.
ومن هنا، فقراءة الأدب العالمي ليست ترفاً ثقافياً، بل أداة مركزية في بناء إنسانٍ منفتح، ناقد، غير متمركز حول ذاته أو ثقافته. إنها تدفع القارئ ليرى نفسه من الخارج، من خلال عين الآخر، فتتبدّى له الأشياء من زوايا لم يفكر فيها من قبل.
ولعلّ هذا ما يجعل من القارئ الحقيقي للأدب العالمي مواطناً كونياً، لا لأنه تخلّى عن جذوره، بل لأنه عمّق جذوره بوعي الآخرين، وفهم أنّ الحقيقة لا تُختزل في ثقافة واحدة، وأن الإنسان أكبر من حدوده، وأشد تعقيداً من لغته.
- تنمية الحس الإنساني المشترك: الأدب بوصفه جسداً واحداً للمعاناة والأمل:
في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو الفردانية، العزلة، والصراعات الثقافية والهوياتية، تبرز قراءة الأدب العالمي كفعل أخلاقي وإنساني بامتياز، بوصفها أحد أكثر السبل فعالية لتنمية الشعور بالتعاطف، وفهم معاناة الآخر، والانخراط في الهمّ الإنساني العام.
حين نقرأ رواية يابانية عن الحب الصامت في مجتمع تقليدي مكبوت، أو نتأمل قصيدة روسية عن المنفى والتشظي، أو نعيش عبر قصة كوردية لحظة مقاومة شعب في وجه الفناء، فإننا لا نتعلّم فقط معطيات تاريخية أو معرفية، بل نتشرب عاطفة الآخر، نسمح لها أن تسري في أوصالنا، ونمنح أنفسنا فرصة أن نشعر بما يشعر به، أن نبكي معه، ونأمل له، وننهار حين ينهار.
إنّ الأدب العالمي لا يقدّم فقط قصصاً، بل يقدّم تجارب وجودية مكثّفة، ينقلها من خاصية المعايشة المباشرة إلى إمكانية المشاركة الشعورية عبر اللغة. في القصص التي نقرؤها عن الناجين من الهولوكوست، أو عن ضحايا الاستعمار، أو عن العاشقين في ظل القهر السياسي، لا نرى فقط الآخرين بل نبدأ في فهم ذواتنا ككائنات هشّة، مجروحة، تعاني كما يعاني الآخر، وتحلم كما يحلم.
وهنا تتجلّى أعظم قدرات الأدب: إنه يحطّم الفواصل الصلبة بين "أنا" و"الآخر"، ويعيد رسم الحدود بين "هنا" و"هناك"، فيخلق شعوراً بوحدة الكائن الإنساني في جوهره الأعمق، بعيداً عن عوارض العِرق والدين والجغرافيا.
الأدب هو اللغة التي يتكلّم بها الإنسان حين تنفد اللغات. إنه ذلك الحنين المشترك، والخوف المشترك، والفرح المشترك، الذي لا يعرف سوى أن يتجسّد في الحروف. إنّه يُعيد للإنسان وعيه بأنه ليس فرداً معزولاً، بل جزء من شبكة مشاعرية كونية، كل تجربة فيها تُغني وعيه، وتوسّع قلبه، وتعمّق رؤيته.
ولهذا، فإنّ من يقرأ الأدب العالمي لا يصبح فقط أكثر معرفة، بل أكثر إنسانية. يتعلم أن لا يحكم على معاناة الآخر بمقاييسه الذاتية، بل يُنصت إلى ألمه بأذُن قلبه، ويرى فيه نفسه في لحظةٍ ما، زماناً ما، أو مستقبلاً ممكناً.
لقد قال جورج شتاينر إنّ "كلّ فعل قراءة حقيقية هو عمل من أعمال المحبة"، وحقاً، حين نقرأ عن الآخرين في لغاتهم، أو بلغتنا، أو بترجماتهم، فإننا نحبّهم، نعترف بوجودهم، نمنحهم مكاناً في وعينا، ونكفّ عن رؤيتهم كغرباء.
وهكذا، يُصبح الأدب العالمي وسيلة لإعادة اكتشاف إنسانيتنا المهملة، ولبناء عالم أكثر عدلاً، وفهماً، ورحمة، لأنه يبدأ من حيث تنتهي الأنانية: في قلب القارئ.
- إثراء الذائقة الأدبية: حين تتعدد الأساليب تتسع آفاق الجمال:
إذا كان الأدب فنّاً يُصاغ من اللغة، فإن قراءة الأدب العالمي هي الدخول إلى متحف اللغة الكبير، حيث تتجاور الأساليب، وتتقاطع الجماليات، ويُعاد تشكيل الحرف في قوالب لا حصر لها من الإبداع والتعبير. في كل ثقافة، ينبض الأدب بإيقاعه الخاص، بلمسته النحوية، بنكهته السردية، بروحه الشعرية، وبالتالي فإنّ قراءة الأدب العالمي لا تكتفي بتقديم المحتوى، بل تعيد تشكيل الذائقة الجمالية لدى القارئ.
في الرواية الفرنسية مثلاً، سنلمس الرهافة النفسية والانغماس في التفاصيل الباطنية، كما عند مارسيل بروست، حيث يتحوّل الزمن إلى مادة شعورية قابلة للتذوق، بينما تمنحنا الرواية الروسية صوت الأعماق الأخلاقية، ذلك التوتر الوجودي والفلسفي الذي يحكم العلاقات بين الإنسان والعدالة والمصير، كما في أعمال دوستويفسكي. أما في الرواية اللاتينية، فتشرق الواقعية السحرية، حيث تمتزج الأسطورة بالحقيقة، وتصبح الأحلام جزءاً من النسيج الواقعي، كما في عالم ماركيز وأليخو كاربنتيير.
وفي الشعر، نرى في الهايكو الياباني كيف يمكن للحد الأدنى من الكلمات أن يُعبّر عن الكمال العابر للطبيعة، وكيف يمكن لصورة بسيطة – كورقة خريف تتهاوى – أن تختزن إحساساً بالعدم، والسكينة، والحكمة الصامتة. على الجانب الآخر، تقودنا قصائد نيرودا، أو لوركا، أو أدونيس، إلى عوالم من الصور الحسية والانفعالات المتفجّرة، حيث الكلمة ليست فقط معنى، بل إيقاع، وجسد، وصوت داخلي.
كل ذلك يُربّي في القارئ حسّاً تذوقياً متعدد الطبقات. يصبح أكثر قدرة على التفريق بين البلاغة النمطية والجمال الأصيل، بين الزخرفة الشكلية والعمق الشعوري. إنّ الاحتكاك بنصوص مختلفة اللغة والأسلوب والنسق الثقافي، يُنمّي الذائقة النقدية، ويُدرّب الأذن والخيال على التقاط النغمة الجمالية الخاصة بكل نص، تماماً كما يُدرَّب العازف الجيد على التمييز بين نغمات متعددة من آلات موسيقية متنوعة.
ولعلّ من أعمق الفوائد أنّ القارئ يتعلم كيف لا يُصدم من الاختلاف، بل كيف يتقبله، ويُحبّه، ويُدرجه ضمن شبكة الجمال الممكن. يتعلم أن "الأسلوب" ليس مطلقاً، بل سياقيّ، وأن ما يبدو مباشراً في ثقافة ما، قد يكون بالغ الرمزية في أخرى. وأنّ البلاغة ليست حكراً على لغة بعينها، بل هي انفتاح النص على مستويات من الإدهاش تتجاوز المألوف.
وهكذا، تُصبح قراءة الأدب العالمي فعلاً تربوياً للخيال الجمالي، يُعلّم القارئ أن للجمال أوجهاً متعددة، وأن كل لغة تحبّ العالم بطريقة مختلفة، وكل نصّ يعلّمه كيف يكون أجمل... كيف يكون قارئاً أكثر انفتاحاً، وناقداً أكثر حساسية، وإنساناً يرى في الكلمة بوابة إلى دهشة لا تنتهي.
- كسر النمطية الثقافية: الأدب كنافذة على العالم الحقيقي لا المصنوع إعلامياً:
في عالم تُشكِّله وسائل الإعلام والسياسات الاستهلاكية، كثيراً ما تُختزل الشعوب إلى صور كاريكاتيرية ونماذج جامدة. الإفريقي يُصوَّر كمجرد ضحية للمجاعة، والعربي كمصدر للعنف، والآسيوي كرمز للطاعة أو الغرابة، والأوروبي كمثال للتقدّم المطلق. هذه الصور لا تنبع من معرفة حقيقية، بل من تصورات جاهزة تُعيد إنتاج الهيمنة الثقافية وتغذي الانقسام بين "نحن" و"هم".
هنا يتدخل الأدب العالمي بوصفه أداة مقاومة ناعمة لهذه المركزية الثقافية المضلِّلة. الأدب لا يقدّم نموذجاً خارجياً عن الشعوب، بل يتكلم من داخلها، من نبضها، من أعماق وجدانها. فحين نقرأ رواية إفريقية مكتوبة على يد كاتب من نيجيريا مثل تشينوا أتشيبي، فإننا لا نرى إفريقيا التي تروّج لها الشاشات، بل نرى إفريقيا التي تفكر، تحب، تُقاوم، وتحكي عن ذاتها بلغتها ووعيها.
إنّ قراءة رواية من أمريكا اللاتينية، أو قصة من كوريا الجنوبية، أو قصيدة أمازيغية أو كوردية أو هندية، لا تعني فقط الاطلاع على ثقافة مختلفة، بل تفكيك المنظور المهيمن الذي يُصدّر رؤية واحدة للعالم، غالباً ما تنطلق من المركز الغربي الأبيض. فكل نص من "الهامش" هو احتجاج ناعم على صورة مشوهة، وتأكيد على أن الثقافة ليست حكراً على جهة، ولا يحق لأحد أن يحتكر سرد القصة.
الأدب يُعيد الاعتبار للصوت المغيَّب. إنه يُعرّف القارئ على الحياة كما تُعاش فعلاً، لا كما تُروَّج عبر السينما أو نشرات الأخبار. يعرّفنا على الإنسان في تعدده، في عناده ضد التبسيط، في طيف معاناته اليومية. نحن لا نقرأ فقط عن "الآخر"، بل نقرأ من خلاله، وبصوته، وبعينه التي لا تشبه عين الآخر الذي يراقبه من بعيد.
ومن هنا، فإنّ قراءة الأدب العالمي هي شكل من أشكال المقاومة المعرفية. إنها تعلّم القارئ كيف يكون متواضعاً في حكمه على الثقافات الأخرى، كيف ينقض الأفكار الجاهزة، وكيف يُعيد اكتشاف التنوع الإنساني ليس بوصفه تهديداً، بل بوصفه ثروة حضارية.
كما أن هذه القراءة تُسهم في هدم الصور الذهنية الأحادية، وتؤسس لنوع جديد من الحوار الثقافي القائم على الاحترام والمعرفة والتداخل. فكلما قرأنا أكثر من العالم، كلما أدركنا أن العالم ليس ما يُقال عنه، بل هو ما يقوله عن نفسه.
إنّ الأدب العالمي، بهذا المعنى، لا يوسّع فقط الجغرافيا الذهنية للقارئ، بل يعلّمه كيف يكون إنساناً أقل حكماً وأكثر فهماً، أقل استعجالاً في التصنيف، وأكثر انفتاحاً على المختلف.
- تحفيز الإبداع الشخصي: حين يصبح الأدب العالمي وقوداً لتجدد الكاتب وتحرره:
الإبداع الأدبي لا ينمو في عزلة، ولا يتغذى من الفراغ. الكاتب، كأي فنان، هو ابن قراءاته، وتجربته مع اللغة، وتفاعله مع العالم من حوله. وفي هذا السياق، فإن قراءة الأدب العالمي ليست مجرد نشاط ثقافي، بل هي فعل انعتاق داخلي للكاتب، وانفجار في مخياله، وتحرير من قيود النمط والأسلوب المألوف.
حين يقرأ الكاتب تجارب سردية متنوعة من ثقافات مختلفة، فإنه لا يكتسب فقط معرفة جديدة، بل يُعاد تشكيل ذائقته الإبداعية، ويكتشف أن الأدب ليس واحداً، بل عوالم متداخلة من الإمكانيات، والأنماط، والرؤى. فهناك مثلاً من يكتب الرواية بأسلوب شعري، وهناك من يعالج الشعر بنَفَس سردي، وهناك من يجعل اللغة مجرّد خلفية لصراع الأفكار، أو مسرحاً للأصوات المتعددة، كما في تيار "البوليفونية" الذي تجلّى بوضوح في الأدب الروسي.
الكاتب الذي يقرأ "الكتاب المقدّس" في بنائه الحكائي، ثم يتنقّل إلى "كافكا" في غرائبيته، أو إلى "هاروكي موراكامي" في هلاميته، أو إلى "ماركيز" في ميثولوجيته، أو إلى "رضوى عاشور" في سرديتها المقاومة، لا يمكن أن يبقى هو ذاته بعد هذه الرحلة. إنه ينقض قوالبه الداخلية، ويتصالح مع التجريب، ويجرؤ على الكتابة بشكل مختلف.
ذلك لأنّ الأدب العالمي يُربّي في الكاتب جرأة الخروج من "الوصفة المحلية"، ويدفعه إلى إعادة التفكير في أدواته، وصوته، وشخصياته، وبنيته السردية. يصبح أكثر وعياً بأن هناك طرقاً لا تُحصى للكتابة، وأنه ليس مضطراً لتقليد أسلافه، ولا للالتزام بمدرسة معينة. فهو لم يعد يكتب من أجل "الإعجاب المحلي"، بل من أجل الوصول إلى لغة تمثله، تعكس فرادته، وتسمح له بأن يبتكر لا أن يُكرّر.
بل وأكثر من ذلك، فإنّ الاطلاع على أدب الآخر يُعلّم الكاتب كيف يُعيد تأويل هويته الخاصة بطريقة أكثر نضجاً. هو لا يذوب في الآخر، بل يستلهمه ليصوغ ذاته. يصبح قادراً على بناء نصٍّ محليٍّ برؤية كونية، وعلى كتابة "ما هو خاص" بلغة "تتّسع للجميع".
هكذا، فإنّ الأدب العالمي لا يمنح الكاتب مواد جاهزة، بل يفتح له الأبواب لخلق أدواته الخاصة. يُحرّضه على كسر المحرّمات الأسلوبية، وتجاوز الرتابة، وتبنّي الهجنة، والمزج بين الأنواع، والخروج عن القوالب الجاهزة. إنه معمل حرية، وورشة لا نهائية للابتكار، وجدل دائم بين التأثر والتفرّد.
باختصار، الكاتب الذي يغتني بالأدب العالمي لا يصبح مجرد ناقلٍ للقصص، بل يصبح صانع عالمٍ جديد، يكتب لا بوصفه تابعاً، بل بوصفه منخرطاً في حوار إبداعي مفتوح مع العالم كلّه.
ثالثاً: الأدب العالمي والمركزية الغربية
رغم أن مفهوم "الأدب العالمي" يوحي بالشمول والانفتاح والتعدد، إلا أنه في الواقع اصطلاح معقّد يحمل في طيّاته توتراً خفياً بين الكوني والمركزي، بين التعدد الثقافي وهيمنة مركز معيّن على تعريف هذا التعدد. فغالباً ما يُساء فهم الأدب العالمي بوصفه مجرّد "أدب مترجم"، أو على أنه "أدب الآخر الذي حظي باعتراف الغرب"، مما يطرح سؤالاً حاداً: من يملك سلطة تصنيف النصوص على أنها تنتمي إلى الأدب العالمي؟ ومن يقرر ما يستحق أن يُقرأ عالميّاً، وما يُقصى إلى الهوامش؟
إنّ الطابع العالمي للأدب لا يتحقّق فقط بجودة النص أو فرادة التجربة، بل يرتبط أيضاً بقوى النشر، الترجمة، والتوزيع، التي كثيراً ما تتركّز في المؤسسات الثقافية الغربية. وبهذا، تصبح الكونية – في كثير من الأحيان – مرآةً لمعايير مركزية غربية، تُعيد إنتاج صورة الذات الأوروبية بوصفها المعيار، وتختزل تنوع الأدب العالمي في نماذج "صالحة للتصدير" وفق شروط المركز.
وبينما يُحتفى بكتّاب من العالم الثالث في الجوائز الدولية، غالباً ما يكون هذا الاحتفاء مشروطاً بـ"قابلية نصوصهم للقراءة الغربية"، أي بانخراطهم في قوالب مفهومة، أو استعراضهم لغرائبية محلية تروق للقارئ الغربي، دون أن يُكترث السياق الثقافي الحقيقي الذي وُلدت فيه النصوص.
من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة النظر في مفهوم "العالمية"، وإلى تفكيك بنيته الرمزية والسياسية، كي لا تكون مرادفاً للتطبيع مع المركز، بل جسراً حقيقياً للتبادل الثقافي القائم على الاعتراف بالندية، والانفتاح على الاختلاف، لا امتصاصه.
في هذا الفصل، سنتناول بإمعان علاقة الأدب العالمي بالمركزية الغربية، كيف نشأت، وكيف تُعيد إنتاج نفسها، وما البدائل الممكنة لرؤية أكثر عدلاً وتعدداً في مفهوم الكونية الأدبية.
1- هل الأدب العالمي هو فقط الأدب الغربي؟
يُطرح هذا السؤال كثيراً في أوساط النقاد، لا سيما في ظل سيطرة أدباء أوروبا وأمريكا على قوائم "الروائع العالمية". فهل الأدب العالمي مجرد إعادة إنتاج للثقافة الغربية؟
الإجابة تكمن في نقد المركزية الغربية التي كثيراً ما فرضت معاييرها في تصنيف الأدب، وتحديد ما هو "جدير" بأن يكون عالمياً. ولذلك، يطالب كثير من النقاد من العالم الثالث وآسيا وأفريقيا بإعادة تعريف الأدب العالمي بحيث يشمل الأصوات المهمشة، والنصوص غير المكتوبة بالإنجليزية أو الفرنسية.
يبدو هذا السؤال للوهلة الأولى استفزازياً أو حتى تبسيطياً، لكنه في الحقيقة سؤال جوهري في فهم البنية الثقافية والسياسية لمفهوم "الأدب العالمي". فحين نتأمل قوائم "الأعمال الخالدة"، و"الروائع الأدبية"، و"الكتب التي يجب أن تقرأها قبل أن تموت"، نجد أنفسنا أمام هيمنة شبه مطلقة للأدب المكتوب باللغات الأوروبية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، وفي أحسن الحالات الإسبانية أو الإيطالية. أما باقي آداب العالم – من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط – فتُذكر غالباً بوصفها "استثناءات مثيرة للاهتمام"، أو تُقرأ فقط عبر عدسة غرائبية تُرضي فضول القارئ الغربي.
فهل الأدب العالمي هو بالضرورة أدب الغرب؟ أم أن ما يُسمّى "عالمياً" هو ما تمت الموافقة عليه واعتماده من قبل المؤسسات الثقافية الغربية؟
هنا يطرح النقاد من الجنوب العالمي (العالم الثالث سابقاً) تساؤلاً جوهرياً:
"هل الكونية الحقيقية تعني الانفتاح على الآخر، أم أنها طريقة ناعمة لإعادة إنتاج المركزية الغربية؟"
- نقد المركزية الغربية:
المركزية الغربية (Eurocentrism) هي رؤية للعالم تضع أوروبا والغرب في مركز التاريخ والثقافة والمعرفة، وتنظر إلى ما عداها بوصفه إما "تأخراً حضارياً"، أو "ظاهرة مثيرة للفضول". وهذه الرؤية لم تنتهِ بانتهاء الاستعمار العسكري، بل استمرّت في أشكال أكثر خفاءً، كالمناهج الدراسية، والجوائز الأدبية، وخريطة الترجمة العالمية، وحتى في تصنيفات دور النشر الكبرى.
وفي هذا السياق، يُعاد إنتاج الأدب العالمي بوصفه مرآة لمعايير الذوق الغربي، لا لتعدد الذائقات العالمية. ويصبح الاعتراف العالمي بالأدباء من الجنوب مشروطاً بمدى قدرتهم على الترجمة إلى "لغة المركز"، أو على الكتابة بطريقة يفهمها المركز ويتماهى معها، أو على تقديم "تجربة محلية" تُرضي توق الغرب لاكتشاف الآخر، دون أن تزعجه.
- الترجمة: سلاح ذو حدّين:
الترجمة، التي يُفترض أن تكون جسراً بين الثقافات، كثيراً ما تتحول إلى أداة انتقائية تحدد من يعبر الجسر ومن يُترك على ضفته. فالنصوص التي تُترجم غالباً ما تُختار بناءً على ما يتوافق مع توقعات السوق الغربية، لا بناءً على قيمتها الجمالية أو رؤيتها الثقافية.
ويُلاحظ أن الترجمة تتمّ في اتجاه واحد: من "لغات الأطراف" إلى "لغات المركز"، نادراً ما يحدث العكس.
- أصوات من الهامش:
أدباء من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل:
- نغوغي واثيونغو (كينيا)،
- محمود درويش (فلسطين)،
- طيب صالح (السودان)،
- رضوى عاشور (مصر)،
- بريللو بونتيكورفو (أمريكا اللاتينية)،
- كوابينا سينيور (غانا)...
- جكر خوين ( كوردستان سوريا)،
غالباً ما تم تجاهلهم في بداياتهم أو اختُزلوا في تصنيفات ضيقة (أدب ما بعد الاستعمار، الأدب النسوي، الأدب الإثني...) بدلاً من النظر إليهم كأدباء عالميين بجدارة، يُعبّرون عن همّ الإنسان أيّاً كان.
إنّ المعيار الجغرافي واللغوي لا يجب أن يكون شرطاً للاعتراف العالمي، بل يجب أن يكون المعيار هو القدرة على التعبير عن التجربة الإنسانية بعمق وأصالة، وهو ما يستطيع أن يفعله الكاتب في قرية نائية من كوردستان، أو في حيّ شعبي في مومباي، أو في جزيرة نائية من الكاريبي، تماماً كما يفعله كاتب في باريس أو لندن.
- نحو أدب عالمي متعدد المراكز:
ينادي النقاد اليوم بإعادة تعريف الأدب العالمي، لا بوصفه قائمة ثابتة من "الروائع الكلاسيكية" المنتقاة من المركز، بل بوصفه شبكة حيّة من النصوص، تتفاعل، وتتناص، وتتحاور، دون أن تُخضع أحدها للآخر.
العالمية لا تعني الكتابة "كأنك غربي"، بل أن تكتب بأصالة محلية، وبنفسٍ إنساني قادر على العبور. وبدلاً من مركز واحد يقرر ما هو عالمي، يجب أن نؤمن بعالم أدبي متعدد المراكز، متعدد اللغات، متعدد الذائقات.
خلاصة:
إذاً، الأدب العالمي ليس، ولا يجب أن يكون، مرادفاً للأدب الغربي. لكنه للأسف كثيراً ما تم اختزاله بذلك بفعل أنظمة القوة الثقافية والاقتصادية والمعرفية. والمطلوب اليوم تحرير مفهوم "العالمية" من هيمنة المركز، وفتح المجال لأدب "العوالم" كلّها، لا أدب عالمٍ واحدٍ فقط.
2- مقاومة "الاستشراق الأدبي"
كما كشف إدوارد سعيد في كتابه الشهير الاستشراق عن الكيفية التي صاغ بها الغرب صورة "الشرق" كمخلوق خيالي، مفعم بالعجائبية، والغموض، والدونية في آنٍ معاً، فإننا نجد في الحقل الأدبي شكلاً موازياً من هذا التحيّز يُعرف بـالاستشراق الأدبي. وهو ليس فقط طريقة في تمثيل الشرق والجنوب العالمي، بل آلية للهيمنة الرمزية داخل ما يسمى بـ"الأدب العالمي".
- ما هو الاستشراق الأدبي؟
الاستشراق الأدبي هو اختزال النصوص غير الغربية إلى طابعها الغريب Exotic، والتركيز على عناصر الإثارة الثقافية أو الطرافة الاجتماعية فيها، دون اعتبار جديّ لقيمتها الجمالية أو تعقيدها البنيوي أو عمقها الإنساني. وبهذا، تتحول رواية أفريقية أو آسيوية أو عربية إلى سلعة ثقافية تُستهلك من باب الفضول، لا من باب الندّية.
فبدل أن تُقرأ رواية كوردية، مثلاً، بوصفها تعبيراً عن تجربة إنسانية عميقة، تُقرأ فقط باعتبارها "نافذة على معاناة شعب غريب"، أو "قصيدة من المنفى الشرقي"، وكأنها قطعة فولكلورية، لا نص أدبي يتساوى في القيمة والتقنية مع نصوص تولستوي أو ماركيز.
- كيف يعمل هذا النوع من الاستشراق؟
- من خلال انتقاء النصوص التي تتماشى مع توقعات القارئ الغربي عن "الشرق الغريب".
- ومن خلال ترجمات تتعمد تبسيط أو تلطيف النصوص، فتُقصى تجارب التمرد أو الراديكالية أو الفكر النقدي فيها.
- وأحياناً، من خلال مقدمات نقدية أوروبية تضع النص في إطار استهلاكي، كأن تقول: "هذه رواية رائعة لأنها تكشف لنا كيف يعيش الناس في المجتمعات المتخلفة!" بدلاً من تحليلها كعمل أدبي مكتمل.
- المقاومة تبدأ من الوعي:
مواجهة الاستشراق الأدبي لا تتم فقط بفضحه، بل أيضاً بإعادة تعريف شروط العالمية في الأدب. وهذا يتطلب:
- المطالبة بتنوع حقيقي في قوائم "الروائع" التي تُدرّس وتُترجم.
- الاهتمام بجماليات النصوص "غير الغربية" لا فقط برسالتها الإثنوغرافية.
- خلق فضاءات نقدية جديدة، من داخل العالم المُهمَّش، تُعيد الاعتبار للكتابة بوصفها فعلاً فنياً لا فقط شهادة ثقافية.
كما تحتاج المقاومة إلى مترجمين ناقدين، لا يترجمون النص من أجل السوق فقط، بل يعيدون تقديمه كجزء من التقاليد الأدبية الكبرى في العالم، لا هامشاً لها.
خلاصة:
الاستشراق الأدبي هو امتداد لصراع الهيمنة في عالم الثقافة، حيث تُقاس الأدبيات غير الغربية بمسطرة الغرب، وتُستهلك بوصفها "الآخر" لا "الذات النظيرة".
ولذلك، لا يمكن الحديث عن أدب عالمي عادل حقاً دون تفكيك هذا النموذج الاستشراقي، واستبداله بمفهوم "العالمية التعددية"، حيث كل صوت هو مركز، وكل لغة تحمل شرعية الأدب، وكل تجربة تُقرأ لجمالها وعمقها، لا لطرافتها أو "غرابتها" فحسب.
رابعاً: الترجمة بوصفها رافعة وهاوية
الترجمة هي الجسر الذي تعبر من خلاله النصوص الأدبية لتبلغ الآخر، وهي في الوقت ذاته البوابة التي قد تُحرّر العمل الأدبي من محليته، أو تسجنه في قوالب لم يقصدها الكاتب. إنها الفعل الثقافي الأكثر التباساً في تاريخ الأدب العالمي: فهي الرافعة التي تحمل النصوص من هامش اللغة إلى مركز التداول العالمي، وهي الهاوية التي قد تفقد فيها الأعمال صوتها الأصلي وتغرق في إسقاطات الآخر.
لقد كانت الترجمة، منذ فجر الحضارة، حاملةً للمعرفة، موصلةً للحكايات، مرآةً للغريب والمجهول. ولكن، في ظل النظام الثقافي العالمي غير المتوازن، أصبحت الترجمة ساحة للصراع بين التمثيل والهيمنة، بين الأمانة والانزياح، بين ما يُنقل وما يُؤوَّل. فهي ليست مجرد نقلٍ لغويّ، بل فعلٌ سياسي وثقافي بامتياز، تُحدَّد من خلاله مصائر النصوص، وأحياناً هويّات الأمم.
في سياق الأدب العالمي، تصبح الترجمة الفيصل بين أن تكون الرواية منسية في لغتها الأم، أو أن تتحول إلى "تحفة عالمية" تتصدر القوائم وتُقرأ في الجامعات. ولكن بأي شروط؟ ومن الذي يختار ما يُترجَم؟ ومن الذي يقرر كيف يُترجَم؟
من هنا، فإن مناقشة الترجمة لا تعني فقط تأكيد أهميتها، بل أيضاً مساءلة دورها في إعادة تشكيل النصوص، بل في إعادة تشكيل "العالمية" ذاتها:
هل الترجمة تُحرّر الصوت المحلي من عزلة اللغة، أم تُعيد تشكيله ليتلاءم مع توقعات القارئ الغربي؟
هل هي فعل تواصل، أم شكل من أشكال إعادة التملّك الثقافي؟
في هذا القسم، نحاول الغوص في هذا المأزق المزدوج الذي تمثّله الترجمة: كيف تكون أداة لرفع الأدب إلى مصاف الكونية، وفي الوقت نفسه أداة اختزال وتشويه حين يُفرض عليها منطق السوق، أو تهيمن عليها رؤى المركزية اللغوية والثقافية؟
إنها جدلية عميقة بين الوفاء والخيانة، بين الأمانة والإبداع، بين أن نكون كما نحن، أو كما يريد الآخر أن نكون.
1- الترجمة كجسر:
لا وجود فعلي للأدب العالمي دون الترجمة. فهي ليست مجرّد تقنية لغوية، بل فعل ثقافي عميق يُشبه إعادة ولادة للنص في سياق لغوي وثقافي مغاير. الترجمة هي الجسر الذي تعبر من خلاله الحكايات، والأصوات، والمشاعر من ضفة اللغة الأصلية إلى ضفاف أخرى، حيث ينتظر قارئ لا يعرف شيئاً عن الكاتب سوى ما يُقدَّم له من خلال هذا الوسيط السحري.
في هذا المعنى، تُعدّ الترجمة شرطاً أساسياً لكونية الأدب؛ فالرواية اليابانية لا تصبح رواية عالمية لأنها كُتبت، بل لأنها تُرجمت، وقُرئت، وتفاعل معها قرّاء بلغات مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة للقصيدة الروسية، أو السرد الكوردي، أو الرواية الإفريقية المكتوبة بلغة محلية، جميعها تحتاج إلى عين مترجم حسّاسة تلتقط النبرة، والإيقاع، والروح، لا الكلمات فحسب.
إنّ الترجمة، بهذا المنظور، تُعيد تشكيل الجغرافيا الثقافية، وتكسر الحدود، وتمنح النصوص فرصة للحياة خارج أوطانها الأصلية. ولكنها، في الوقت ذاته، ليست فعلاً بريئاً؛ فالمترجم لا ينقل النص فقط، بل يؤوّله، ويعيد إنتاجه في ضوء معجمه الشخصي وثقافته وخياراته الجمالية. وبالتالي، فإن كل ترجمة هي قراءة مزدوجة للنص: قراءة لفهمه، وقراءة لإعادة تقديمه للآخر.
الترجمة كجسر، إذاً، لا تتيح فقط مرور النصوص، بل تتيح أيضاً مرور الأفكار، والقيَم، والحساسيات الثقافية، وهي التي تجعل من الأدب فعلاً كونياً، يتجاوز ضيق الحدود، ويصنع حواراً عابراً للغات والهويات. إنها البوابة التي تُدخلنا إلى "الآخر" وتُدخل "الآخر" إلينا، فنتعلّم أن نرى العالم بعينين لا تشبهان أعيننا، دون أن نفقد بصرنا.
2- مشاكل الترجمة: حين يصبح الجسر هشّاً
رغم كون الترجمة شرطاً أساسياً لوجود الأدب العالمي، فإنها ليست عملية محايدة، ولا دائماً ناجحة. فكما أن الجسر قد يصل، فقد ينهار في منتصف الطريق، أو قد يُفضي إلى جهة لا تشبه الوجهة الأصلية للنص. إذ تُطرح في ميدان الترجمة مجموعة من التحديات والمشكلات البنيوية والجمالية والثقافية، تجعل من فعل الترجمة ساحةً للتوتر بين الوفاء للنص، والانزياح نحو أفق القارئ الجديد.
- فقدان "النكهة الثقافية" الأصلية
كل نص أدبي يُولد في بيئة لغوية وثقافية فريدة، تحمل معها طقوسها، ومفرداتها، وصورها المتجذّرة في ذاكرة جماعية خاصة. حين يُنقل هذا النص إلى لغة أخرى، هناك دوماً خطر تبخّر تلك "النكهة" المحلية التي تمنح النص فرادته. فكيف يمكن ترجمة مثلاً كلمة يابانية ترتبط بفلسفة الزِنّ، أو مثل كوردي شعبي مشحون بحمولة وجدانية وتاريخية، إلى لغة أخرى لا تمتلك هذه الخلفية؟
الجواب غالباً: يُترجم المعنى المباشر، وتضيع الروح.
- تغييب الألفاظ أو الحمولات الرمزية
الترجمة ليست فقط تمريراً للمعاني، بل أيضاً للرموز والإيحاءات والمجازات. وفي كثير من الأحيان، يُضطر المترجم إلى الاختصار أو التحوير حين لا يجد مكافئاً دقيقاً في اللغة المستهدفة. وهذا ما يؤدي إلى فقدان طبقات متعددة من الدلالة، وخصوصاً في النصوص الشعرية أو الفلسفية، حيث يكون الإيحاء أهم من المباشرة.
- هيمنة اللغات الكبرى
من أكبر إشكاليات الترجمة في العصر الحديث هي هيمنة اللغات "المهيمنة" – كالإنجليزية والفرنسية – على عملية الترجمة والتلقي. فالجزء الأعظم من الأدب العالمي الذي يُقرأ ويُدرَّس اليوم هو ما تُرجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية، ما يعني أن المنظور الثقافي الغربي يظل هو المسيطر على "عالمية" النصوص.
وهذا يُقصي الأدب المكتوب بلغات الشعوب "الصغيرة" أو المهمّشة، سواء كانت الكوردية أو الأمهارية أو الأمازيغية أو أي لغة لا تملك "سوقاً" أو "قوة مؤسساتية" لنشر ترجماتها. وبهذا المعنى، تصبح الترجمة أداة تكرّس اللامساواة الثقافية بدلاً من أن تزيلها.
إن مشاكل الترجمة تكشف أن الأدب العالمي ليس حقلاً بريئاً، بل هو فضاء تتداخل فيه القوة والمعنى، السوق والجمال، التمثيل والتأويل. ولذلك، يجب النظر إلى الترجمة لا كفعل تلقائي، بل كممارسة ثقافية وسياسية تتطلب وعياً نقدياً، وإعادة تفكير دائم في معايير "العالمية" نفسها.
3- سؤال: هل الترجمة خيانة؟
يُقال في المثل الإيطالي "المترجم خائن". ولكن هذا القول يتجاهل أن الترجمة هي إعادة خلق، لا مجرد نقل حرفي. المترجم ليس مجرد وسيط، بل شريك إبداعي.
(Traduttore, traditore) — "المترجم خائن"، هكذا يقول المثل الإيطالي القديم، في عبارة أصبحت رمزاً للتوتر الأزلي بين الوفاء للنص والاستجابة لذوق القارئ الجديد.
لكن، هل الترجمة فعل خيانة فعلاً؟ أم أنها شكلٌ آخر من الخلق الإبداعي؟ وهل يمكن حقّاً محاكمة المترجم لأنه لم "ينقل" النص بحذافيره، كما لو كان جهاز استنساخ؟
الواقع أن فكرة الخيانة تفترض وجود أصل مقدّس لا يجوز المساس به، ولكن النص الأدبي ليس آلةً جامدة بل كائناً حياً ينبض بلغة وثقافة وبيئة تاريخية. حين نقرأ "دوستويفسكي" بالعربية أو "شِكسبير" بالكوردية أو "جلال الدين الرومي" بالإنجليزية، فإننا لا نقرأ النسخة الأصلية، بل ولادة جديدة للنص في جسد لغوي آخر. ومن هنا، فالمترجم لا "ينقل" النص، بل "يُعيد كتابته" بما يناسب شروط لغوية وجمالية ومعرفية مغايرة.
- الترجمة كإبداع
المترجم الجيد هو قارئ مبدع وكاتب ثانٍ في آن. هو يختار من بين تأويلات ممكنة، يصوغ إيقاعاً جديداً، يعيد ترتيب المعاني دون أن يفرّط بروح النص. إنه يسير على حدّ السكين: إن اقترب أكثر من الأصل فقد الجاذبية؛ وإن اقترب من القارئ خسر الدقة. وفي كلا الحالتين، لا يمكن اتهامه بالخيانة بقدر ما يجب فهمه كشريك في إعادة إنتاج النص عبر الزمن والمسافة.
- من "الخيانة" إلى "التحرر"
في بعض الحالات، تكون الترجمة نفسها فعل تحرر. فكم من كاتب لم يعرفه العالم إلا بعد ترجمته؟ كم من نص ظلّ سجيناً حتى جاء مترجم شجاع و"خان" لغته الأم ليحرره إلى آفاق أوسع؟ إن الترجمة لا تُنتج نسخة أقل شأناً من الأصل، بل نسخة جديدة لها استقلالها وفرادتها وحقّها في الوجود.
إذن، فالمقولة "المترجم خائن" قد تصلح نكتة أدبية أو تحذيراً ساخراً، لكنها لا تصمد أمام تعقيد فعل الترجمة بوصفه ممارسة جمالية وثقافية ووجودية. والخيانة الحقيقية ليست في تغيير الكلمات، بل في فقدان الشغف والدقة والصدق في إيصال روح النص إلى قارئ آخر، في عالم آخر.
خامساً: تحديات الأدب العالمي في العصر الحديث
رغم الآفاق الواسعة التي فتحها مفهوم "الأدب العالمي"، ورغم الإقبال المتزايد على ترجمة النصوص وتداولها بين الثقافات، إلا أن هذا الأدب لا يعيش في فراغ، بل في عالم معقد متحوّل، تفرض فيه السياسة والتكنولوجيا والاقتصاد أنماطاً جديدة من التلقي والإنتاج. إن الأدب العالمي، بوصفه كياناً حياً، يواجه اليوم مجموعة من التحديات العميقة التي لا تهدد انتشاره فقط، بل تهدد جوهره كفن يعبر عن الإنسان في خصوصيته وتعدده.
وفيما يلي أبرز هذه التحديات:
1- الرقمنة وتغيّر الذائقة:
لقد دخلنا زمناً تسوده ثقافة السرعة والتجزئة. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى المصوّر، والتطبيقات الذكية، هي المصدر الأول للمعرفة والتسلية عند الأجيال الجديدة. في هذا المناخ، يفقد الأدب الطويل – الرواية، الملحمة، القصيدة المطوّلة – مكانته لصالح نصوص سريعة الاستهلاك: اقتباسات، خواطر، مقاطع مرئية لا تتجاوز الدقيقتين.
هذا التحوّل لا يؤثر فقط على شكل التلقي، بل أيضاً على طريقة الكتابة والإنتاج: فبعض الكتّاب بدأوا يكتبون "روايات على المقاس الرقمي"، مختزلة، متسارعة، تناسب القراءة على الهاتف المحمول. وقد يُنتج هذا تنميطاً في الأسلوب، وفقراً في العمق.
كما أن القراءة النقدية المتأنية، التي تتطلب وقتاً وتأملاً وتفاعلاً عاطفياً وفكرياً، بدأت تتآكل. فهل يمكن للروايات العظيمة كـ"مدام بوفاري" أو "الأم" أو "مائة عام من العزلة" أن تُقرأ بنفس الشغف في زمن التيك توك والريلز؟
2- العولمة والتماثل الثقافي:
رغم أن العولمة تُسهّل انتقال النصوص بين الشعوب، إلا أنها تحمل خطراً موازٍ يتمثل في إفراغ النصوص من نكهتها المحلية، لصالح ما هو "صالح للتصدير". يضطر بعض الكتّاب، خصوصاً من بلدان الجنوب، إلى كتابة أعمالهم بأسلوب "مفهوم عالمياً"، أي محايد ثقافياً، خفيف الخلفية التاريخية، مملّس الزوايا الاجتماعية، لكي يحظوا بفرصة الترجمة أو الفوز بجائزة أو الدخول في نادي الأدب العالمي.
هذا يؤدي إلى نوع من التماثل الثقافي: تصبح الشخصيات متشابهة، والموضوعات مكررة، والأساليب مستوردة. وتغدو الكتابة ضرباً من "التسويق الثقافي" بدل أن تكون تعبيراً أصيلاً عن الذات والبيئة.
الأدب العالمي الحقيقي لا يجب أن يُكتب وفق نموذج معياري غربي أو استهلاكي، بل أن ينبع من جذر محلي عميق، ويتّسع ليصل إلى الآخر دون أن يُفرّط في فرادته.
3- إشكالية النشر والتوزيع:
لا يزال حاجز النشر أحد العوائق الكبرى في وجه الأدب العالمي العادل والمتعدد. فرغم وجود آلاف النصوص القيمة في لغات غير أوروبية (الكوردية، السواحيلية، التاميلية، الأمازيغية...)، إلا أن معظمها لا يجد طريقه إلى الترجمة أو النشر العالمي.
وتكمن الأسباب في عدة نقاط:
- هيمنة دور النشر الغربية التي تملك القدرة المالية والبشرية للتوزيع والترجمة والترويج.
- ضعف مؤسسات الترجمة في العالم العربي والنامي، التي لا تمتلك استراتيجيات بعيدة المدى.
- سوق القراءة العالمي الذي تحدده أحياناً أولويات سياسية وثقافية، وليس دائماً القيم الفنية أو الإنسانية للنص.
في هذا السياق، يمكن لنص عالمي حقيقي كأعمال "جكر خوين" الكوردية، أو "طه محمد علي" الفلسطينية، أن يظل محصوراً في جغرافيا صغيرة، فقط لأنه لم يُترجم جيداً، أو لم يُعرض على دار نشر مؤثرة.
خاتمة هذا المحور
إن التحديات التي تواجه الأدب العالمي اليوم ليست فقط تقنيّة أو تجارية، بل هي تحديات وجودية وفكرية تتعلق بجوهر سؤال "ما معنى أن يكون الأدب عالمياً؟". هل هو الأدب الذي ينتشر؟ أم الذي يُترجم؟ أم الذي يعبّر بصدق عن الإنسان في مكانه وزمانه؟
لكي نضمن مستقبلاً حقيقياً للأدب العالمي، علينا أن نعيد النظر في معايير العالمية، وأن نحتفي بالتعدد والتنوع والاختلاف، لا بالتشابه والنجومية والموضة الثقافية. الأدب العالمي ليس نادٍ للنخب، بل فضاء للإنصات العميق لأصوات البشر، كل البشر، من ضفاف الغانج إلى جبال زاغروس، ومن أحلام مهاجري الضواحي إلى حكايات نساء القبائل.
سادساً: أمثلة من الأدب العالمي
لأجل أن نفهم مفهوم الأدب العالمي لا يكفي التنظير، بل علينا أن نتأمل في النماذج التي تجاوزت حدود الجغرافيا واللغة، وأثّرت في قرّاء من مختلف الثقافات. هؤلاء الكتّاب لم يكتبوا ليكونوا "عالميين"، بل كتبوا من قلب بيئتهم، ولكن بعمق إنساني جعلهم يُقرأون في كل مكان.
فيما يلي أمثلة مختارة من كتّاب يمثلون تيارات مختلفة من "العالمية":
1- فيودور دوستويفسكي (روسيا)
لا يمكن الحديث عن الأدب العالمي دون المرور بـ دوستويفسكي. كتب رواياته في القرن التاسع عشر، لكن هواجسه النفسية والوجودية ما زالت تعيش في أدب القرن الحادي والعشرين.
أعماله مثل "الجريمة والعقاب"، "الأبله"، و*"الإخوة كارامازوف"* حفرت في النفس البشرية، في الخير والشر، في الإيمان والشك، وطرحت أسئلة أخلاقية عميقة.
هو كاتب محلي بامتياز (ابن روسيا القيصرية)، لكنه عالمي لأن الإنسان في رواياته يتجاوز الزمان والمكان.
2- غابرييل غارسيا ماركيز (كولومبيا)
ماركيز لم يكن أول كاتب من أمريكا اللاتينية، لكنه كان أول من فتح باب العالمية على مصراعيه لقارته. روايته الشهيرة "مئة عام من العزلة"، كتبت عن بلدة خيالية تدعى "ماكوندو"، لكنها أصبحت رمزاً لحكاية أمريكا اللاتينية بتناقضاتها وسحرها ودمويتها.
استخدم الواقعية السحرية كأداة أدبية جعلت الواقع أكثر شعرية، والمخيال أكثر واقعية.
بفضله، دخلت اللغة الإسبانية وعوالم الجنوب العالمي إلى مركز الأدب العالمي.
3- نجيب محفوظ (مصر)
محفوظ هو أول روائي عربي ينال جائزة نوبل للأدب (1988)، وهو ما اعتُبر اعترافاً دولياً بالأدب العربي. لكن محفوظ لم يكتب للغرب، بل كتب الحارة القاهرية، وعمّقها إنسانياً.
من خلال ثلاثيته الشهيرة (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية)، رسم تحولات المجتمع المصري، وصراعاته بين الحداثة والتقاليد، بين السلطة والشعب.
كان أدبه محلياً في التفاصيل، عالمياً في الأسئلة الكبرى التي طرحها عن الإنسان والسلطة والزمان.
4- كازو إيشيغورو (اليابان – بريطانيا)
ولد في اليابان، لكنه نشأ في بريطانيا، وجعل من هذا التداخل الثقافي هوية إبداعية فريدة.
في روايات مثل "بقايا النهار" و*"لا تدعني أذهب"*, يعالج إيشيغورو قضايا الذاكرة، والندم، وفقدان الهوية. أسلوبه الإنجليزي منضبط، لكن روحه تأملية شرقية.
هو نموذج لكتّاب "الهجرة والانتماء المزدوج"، الذين جعلوا من الغربة نقطة انطلاق نحو كتابة كونية.
5- أورهان باموق (تركيا)
باموق هو الوجه الأبرز للأدب التركي المعاصر في العالم. فاز بجائزة نوبل عام 2006، وأعماله مثل "اسمي أحمر"، و*"ثلج"، و"البيت الصامت"*، تجسّد صراع الهوية بين الشرق والغرب، بين الحداثة والتقاليد في تركيا.
بأسلوبه الذي يدمج بين العمق الفلسفي والحنين الشرقي، استطاع أن يقدّم أدباً تركياً لا يتنكر لجذوره، لكنه منفتح على الأسئلة الكونية.
6- جكر خوين (كوردستان)
جكر خوين هو أحد أبرز الكتّاب والشعراء الكورد المعاصرين، الذين نجحوا في نقل تجربة الشعب الكوردي إلى قارئ عالمي. أعماله تتناول قضايا الهوية، المنفى، المقاومة، والانتماء، بأسلوب سردي شعري يجمع بين التقاليد الكوردية والحداثة الأدبية.
يُعتبر جكر خوين نموذجاً للأدب الذي ينبع من خصوصية ثقافية لكنه يحمل رسائل إنسانية عميقة عن الحرية والكرامة، ما يجعله جزءاً لا يتجزأ من الأدب العالمي.
7- هيمن موكرياني (كوردستان)
هيمن موكرياني شاعر وروائي كوردي معروف بقصائده التي تعبر عن الحنين للوطن والنضال من أجل الحرية، وكتبه تعكس المشاعر الكوردية الوطنية والعالمية في آن معاً.
يكتب بلغة شعرية عميقة توثق التاريخ الكوردي وتعبر عن الألم والأمل، وهو بذلك يقدم صوتاً مميزاً يُغني المشهد الأدبي العالمي.
هذه الأمثلة ليست سوى عيّنة من أدب عالمي حقيقي. فهناك كتّاب في إفريقيا وآسيا وأمريكا الأصلية وجزر المحيط الهادئ لم يُترجموا بعد، ولم يُقرأوا بعد، فقط لأن العالمية لا تزال مرتبطة بقنوات النشر الغربية.
إن كان ثمة من معيار لعالمية الأدب، فهو عمقه الإنساني، وفرادة صوته، وقدرته على ملامسة الآخر دون أن يتخلى عن ذاته.
الخاتمة:
الأدب العالمي ليس مجرد تجميع نصوص من ثقافات مختلفة أو سرد لحكايات مترجمة، بل هو جسر إنساني متين يصل بين القلوب والعقول عبر الزمان والمكان. إنه نافذة نطل منها على عوالم متعددة، نفهم من خلالها تجارب الآخرين، ونشعر بأوجاعهم وأفراحهم، فتتقلص المسافات بيننا وتصبح الإنسانية وحدة واحدة متكاملة.
في زمن تتصاعد فيه النزاعات، وتزداد فيه محاولات فرض الأحادية الثقافية، يظل الأدب العالمي بمثابة منبر للحوار والتفاهم، يذكرنا بأن الإنسان، رغم كل ما يفرقه، يشترك مع أخيه الإنسان في أعمق القيم والرغبات: الحب، الحرية، الكرامة، والعدالة.
وهكذا، يصبح الأدب العالمي أكثر من مجرد فن أو ثقافة؛ إنه فعل مقاومة للتهميش، ودعوة مستمرة للتلاقي والتعايش، وحصن يحمي التنوع الإنساني في وجه التحديات التي تحاول تذويبه. من خلاله نتعلم أن نحترم الاختلاف، ونغني التنوع، ونعمل معاً على بناء عالم أكثر فهماً ورحمةً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Damrosch, D. (2003). What is world literature? Princeton University Press.
Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
Moretti, F. (2013). Distant reading. Verso.
Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility: A history of translation. Routledge.
Spivak, G. C. (1993). The politics of translation. In Outside in the teaching machine (pp. 179–200). Routledge.
Apter, E. (2006). The translation zone: A new comparative literature. Princeton University Press.
Casanova, P. (2004). The world republic of letters. Harvard University Press.
Damrosch, D. (Ed.). (2009).
The Princeton sourcebook in comparative literature: From the European enlightenment to the global present. Princeton University Press