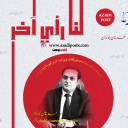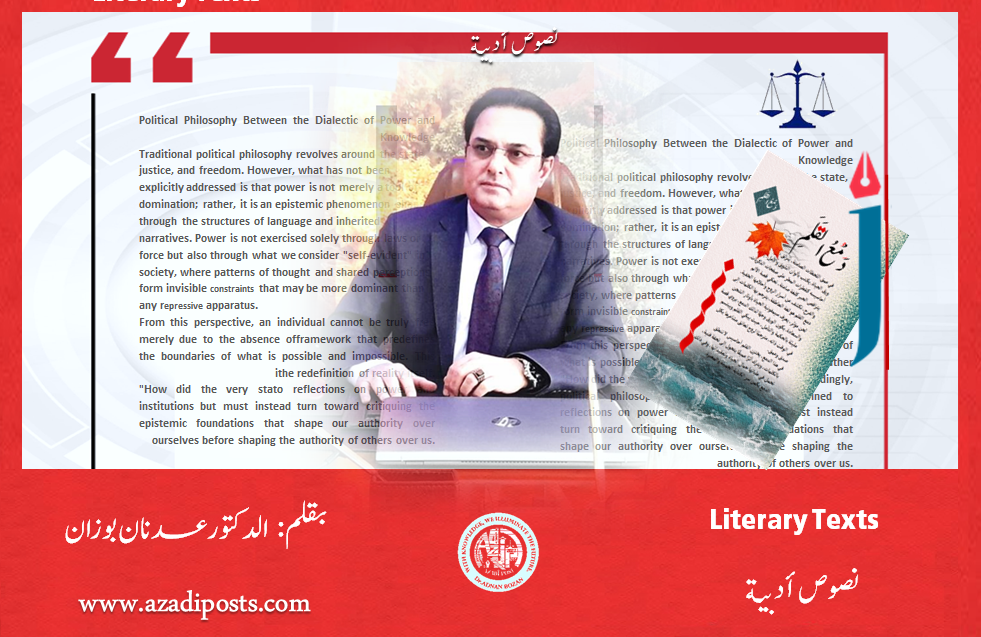 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
الحياة ليست مروراً عابراً فوق جسرٍ من الأيام، بل هي محطاتٌ متشابكة بين الأمل والانكسار، بين شمسٍ تشرق لتعلن ميلاد يومٍ جديد، وظلامٍ يتكئ على بقايا الجثث والرماد. هي معركة أبدية بين الوجود والعدم، بين البقاء والزوال، معركة تصنعها الأقدام التي تصرّ على المشي رغم النزيف، والصدور التي تختزن أنفاسها رغم رائحة البارود، والعيون التي تظلّ تبحث عن ومضةٍ بعيدة تُدعى الحرية.
في زمن الحرب، تتحول المدن إلى حقولٍ للتيه، والبيوت إلى أطلالٍ باهتة، والطفولة إلى سؤالٍ بلا جواب. هناك، حيث يُستبدل دفء الأمهات بضجيج المدافع، وحيث يرحل الأحبة كما لو أن الأرض لفظتهم دفعةً واحدة، يظهر وجه آخر للتاريخ: وجه مشوَّه ينهش فيه تجار الدم جسد المجتمعات، ويزرع فيه سحرة الخراب بذور الحقد، فيحوّلون حدائق الربيع المزهرة إلى صحارى مقفرة، وينسفون بسمة الطفولة كما لو أنّها ترفٌ لا مكان له في قواميسهم.
كم من مناضلٍ قاوم الرياح العاتية وعبر البحار والمحيطات، لا ليهرب من وطنه، بل ليحمله في قلبه إلى مكانٍ آخر، باحثاً عن حياة تحفظ كرامة الإنسان وتمنح الأجيال المقبلة فرصةً لرؤية شمسٍ لا تلطخها الدماء على مآذنها! لكن في الجهة الأخرى، كم من ذئاب العصر أصرّوا أن يحيلوا الوجود إلى رماد، وأن يجعلوا من الإنسان رقماً في سجل الفقدان، وأن يُبقوا الشعوب معلّقة على أسلاكٍ شائكة تفصلها عن برّ الأمان.
آهٍ من هذا الزمن الغدّار، زمن البارود الذي لا يعرف الرحمة، زمن القوافل البشرية التي تتيه في دروب الهجرة كما الطيور حين تفقد بوصلتها في العاصفة. في ليالٍ خريفية قامت القيامة في مدننا الجريحة، ودقّت أجراس الخطر كما لو أنّها صفارات إنذار كونية تخبرنا أن الخراب لم يعد احتمالاً، بل قدراً نافذاً.
في التاسع عشر من أيلول، يوم نزف كوباني، كانت الجموع تهتز في كل اتجاه: نساءٌ يحملن الأطفال كأمانةٍ مقدسة، رجالٌ يركضون دون أن يلتفتوا وراءهم، شيوخٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء وكأنهم يستنجدون بها، وجدرانٌ تبقى شاهدةً على كل شيء، بينما البشر يغادرون فرادى وجماعات، تاركين وراءهم طفولتهم وذكرياتهم وأحلامهم المعلقة. لقد كانت الهجرة هناك أشبه بانتزاع الروح من الجسد، قسريةً، داميةً، لا مفرّ منها.
لم نحمل معنا سوى ذاكرةٍ مثقوبة، مبعثرةٍ بين غبار الكتب وتجاعيد الزمن، بين دفاتر قديمة تحكي عن مدارس لم يبقَ منها سوى الأطلال، وأغانٍ كانت تُردد في الأعراس صارت اليوم صدى بكاءٍ يتردّد في المنافي. كان السؤال الذي يحرق قلوبنا: إلى أين نمضي؟ هل هناك مستقبل ينتظرنا، أم أننا ذاهبون إلى ضياعٍ آخر يرتدي قناع النجاة؟
تدافعت الأقدام نحو الأسلاك الشائكة، وارتفعت صرخات الأطفال كأجراس موت، وانسكبت دموع الأمهات كأنهارٍ من ملح. ومع ذلك، لم نكن ندرك حجم الألم تماماً، لكنه كان يكفي أن نشعر أننا نهاجر بلا عودة، أن نُقتلع من الأرض كما تُقتلع الشجرة من جذورها، ونُلقى في المجهول كأوراقٍ في مهبّ الريح.
التغريبة الكوبانية لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت جرحاً غائراً في تاريخنا الحديث، علامةً فارقة تقول للأجيال: هنا كانت مدينة، هنا كان شعب، هنا انكسرت الأجنحة، وهاجر الطير قبل أوانه. قوافل البشر مضت نحو الشمال، نحو الجليد، نحو أراضٍ لم تعرف دفء الشرق، تاركين وراءهم الدفء الوحيد: تراب الوطن.
وفي المنافي، كان القهر يسكننا كما يسكن الغبار رئة المدينة المدمرة. هناك، انكشفت زيف الشعارات الرنانة، سقطت الأقنعة، وظهرت وجوه الكذب والنفاق. لم يبقَ سوى ضياعٍ طويل يتغذّى على انتظار العودة. البعض عاد حين انكفأ الغزاة وفقهاء الظلام، فعاد ليجد مدينته كما رآها جلجامش وهو يتأمل جثة إنكيدو: خرابٌ وجثثٌ وأرضٌ لا تنبت إلا الديدان. والبعض الآخر مضى شمالاً أكثر وأكثر، باحثاً عن بداية جديدة.
أما أنا، فبقيت وحيداً، فرداً في خريف الغبار والعمر الهارب. رأيت مدينتي تتحول إلى حائط مبكى، والطرقات التي كنا نضحك فيها صارت مسرحاً للدموع. كانت صدفة صادمة أن نُلقى في هذا التيه، لكنها صدفة صنعت قدراً، وجعلت الهجرة تسكن جسدنا كمرضٍ مزمن لا شفاء منه.
إن الهجرة ليست مجرد انتقالٍ جغرافي، إنها انكسار داخلي، وصراع مع الذات، ورحلة من الذاكرة إلى المجهول. هي لوحة سريالية تُرسم بدماء الضحايا، وبدموع المهاجرين، وبحبر التاريخ الذي يكتب بلا رحمة.
في هذا الزمن الغدّار، سيظل صوت المهاجرين يدوّي في فضاءات العالم: لم نهرب حباً في الغربة، بل لأن الحرب سرقت منا الوطن، ودفعتنا لنحمل قبورنا على أكتافنا ونمضي كأننا نسير في جنازةٍ لا تنتهي. ومع ذلك، سنظل نبحث عن شمسٍ جديدة، لعلها تشرق يوماً فوق أرضٍ لا تعرف البارود، فوق وطنٍ لا يبيع أبناءه ولا يطردهم، فوق حياةٍ تمنح الإنسان ما يستحقه: الحرية والكرامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: مقال يتناول أحداث عام 2014، وقد كُتب في أيلول 2015.