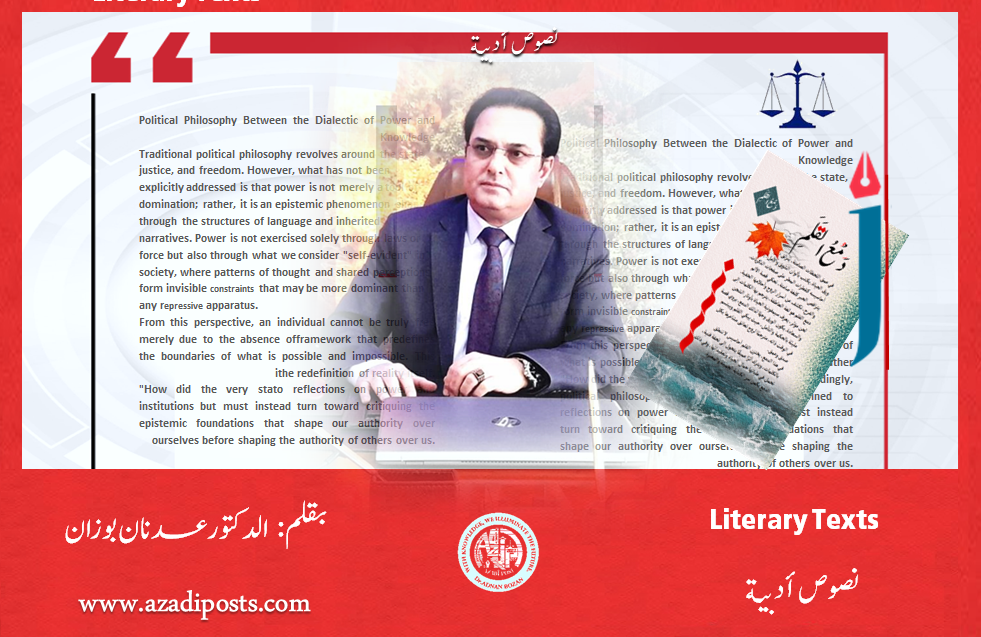 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
في المنفى، لا تنكسر الأوطان فقط... بل تنكسر اللغة.
وفي انكسار اللغة، تُعاد صياغة الوجود.
المنفى ليس مكاناً بعيداً عن حدود الجغرافيا، بل هو انشقاق في الروح، تشظٍّ في الهوية، فراغ يتمدّد في الذاكرة كظلٍّ لا ينتهي. كل منفى هو طردٌ من الفردوس الأول، من دفء المعنى، من بيتٍ اسمه "نحن". وإن كان الوطن هو مكان الشعور بالانتماء، فإن المنفى هو هندسة دقيقة للقلق، خريطة من التمزّق، ومختبرٌ لخلق الذات من جديد، ولكن خارج رحمها.
في المنفى، تغدو اللغة نفسها منفى. الكلمات التي كانت تشعل الدفءَ بين الأهل، تصبح حمماً باردة في فم الغريب. تحاول أن تقول "أمي" بلغة الآخر، فترتجف الحروف وتضيع نبرة الحنان. تحاول أن تكتب عن "الوطن"، فتكتشف أنك لا تكتب عنه، بل تنزف منه.
الكتابة في المنفى ليست فعلاً إبداعياً، بل طقساً من طقوس البقاء. هي مقاومةٌ للصمت الذي يُفرض قسراً، وللنسيان الذي يتسلل خلسةً كالرطوبة في جدران الذاكرة.
المنفى سياسي بطبيعته، لأنك لا تُنفى إلا حين تكون شاهداً على جريمة، أو مشاركاً في حلم، أو حاملاً لصوتٍ أرادت السلطة أن تخنقه. النفي قرار سياسيّ قبل أن يكون تجربة وجودية، لكنه يتحوّل في روح المنفي إلى فلسفة؛ إذ ماذا يعني أن تكون خارجاً عن المكان، وأنت بعدُ لم تخرج من الزمن الذي ينتمي إليه؟
أنت هناك، في "المكان الجديد"، لكن قلبك لا يزال على أرصفة المدن التي قُصفت، في الأزقّة التي ضحكت فيها الطفولة، في لهجات الناس ووجوههم وروائح الخبز في الصباح.
المنفيّ لا يعيش اللحظة، بل يعيش الشقَّ بين اللحظتين. هو عالقٌ دائماً بين "ما كان" و"ما لن يكون". ليس ابنَ الآن، ولا مواطنَ الغد. هو نازحٌ زمني، سجين الأسئلة التي لا تجد وطناً للإجابة.
وفي المنفى، تتغيّر العلاقة بالزمن. لا تعود الأيام وحداتٍ من الوقت، بل تتحوّل إلى علاماتٍ تشبه أطلال المدن المهجورة. كل صباح احتمالٌ للحنين، وكل ليلٍ حوارٌ مع الأشباح. لا شيء أكثر مرارةً من أن تستيقظ على صوتِ لغةٍ لا تخصّك، وتنام على صدى أحلامٍ لا تفهمها.
إن المنفى يعيد تشكيل الوعي، يزرع الشكَّ في كل يقين، ويدفعك إلى مساءلة حتى أكثر الأشياء بداهة.
لماذا نُنفى؟
من يملك حقَّ طرد الإنسان من ترابه؟
وهل يصبح الإنسان كاملاً من دون أرضه؟
أم أن الاكتمال ذاته خدعةٌ اخترعتها السلطة لتروِّض بها الرؤوس التي ترفض الانحناء؟
وفي السياسة، المنفى يشبه الاعتراف بالفشل، لكنه أيضاً إعلان مقاومة. فأعظم الحركات السياسية وُلدت في المنفى، لأن الحرية لا تُمنح في قلب الاستبداد، بل تُخلق خارج حدوده.
المنفى قد يكون مساحةَ عجز، لكنه أيضاً رحمُ الأفكار الجديدة. من هناك، من بعيد، نكتب رسائل إلى الداخل، نرسم أحلاماً مؤجّلة، نحيك لغةً بديلة، ونصنع أوطاناً مؤقتة من الحروف، نكسر بها الحصار، ونربّي بها جيلاً لن يُهزم مرتين.
السياسي في المنفى يجب أن يكون فيلسوفاً أيضاً، لا ليبرّر نفيه، بل ليعيد إنتاج المعنى من تحت الركام. والمنفيّ الحقيقي لا يرضى أن يكون شاهداً صامتاً، بل يحوّل غربته إلى منصةٍ للقول، للعصيان، للكتابة، للغضب النبيل.
لكن، في عمق هذا كلّه، يبقى السؤال:
هل يمكن للمنفيّ أن يعود يوماً إلى وطنه؟
وأخطر من هذا السؤال: هل سيعرف وطنه حين يعود؟
المنفى لا يتركنا كما نحن. إنه يبدّل خرائطنا الداخلية. وقد نعود يوماً، لكن نحمل في جيوبنا رماداً بدل المفاتيح، وصوراً لمدنٍ لم تَعُد موجودة، وحنيناً لأماكن لم تَعُد تتعرّف علينا.
العودة ليست دائماً خلاصاً، بل قد تكون منفىً من نوع آخر.
لأن الذين لم يُنفَوا لا يفهمون لغتنا الجديدة، ولا يعرفون كم بكينا بصمت، ولا كم خُنّا اللغة حين لم نجد من يفهمها.
نعود، ولا نعود.
نرجع، ولا نجد أنفسنا.
وفي لحظة تأمّلٍ صامتة، أقف أمام نافذة المنفى.
أنظر إلى العالم وهو يعبرني... لا أنا هو، ولا هو أنا.
لكنّي، على الأقل، أعرف الآن من أكون:
أنا المنفيّ الذي لم يعُد يبحث عن وطنٍ في الخارطة، بل في الكلمة.
أنا من أدرك أن المنفى ليس نهاية، بل بداية...
بداية وعيٍ جديد،
ووطنٍ لا تُطال رايته،
لأنه مرفوعٌ في القلب.


