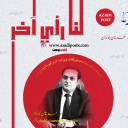سلطة بلا دولة... ودولة بلا مواطنة: مأزق المشروع الإسلامي في سوريا
- Super User
- ملفات سياسية
- الزيارات: 3715
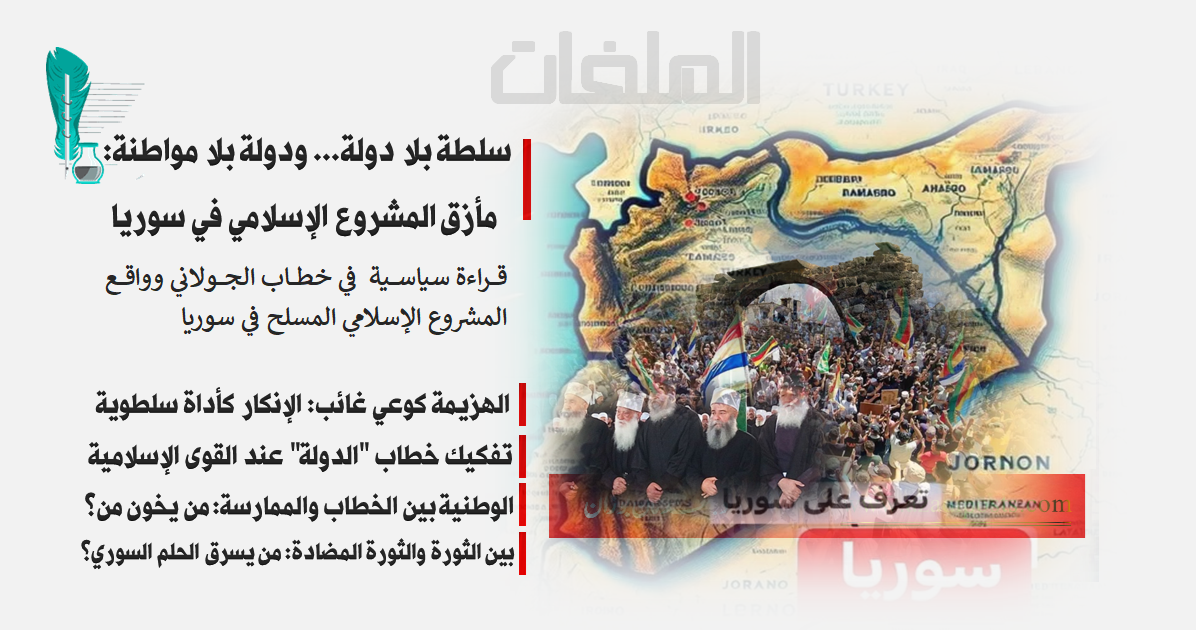 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
في أعقاب الانهيار التدريجي لبنية الدولة المركزية في سوريا، لم يفتح الباب فقط أمام الفوضى الجغرافية والعسكرية، بل أمام انفجار الأسئلة المؤجلة في الهوية، والسيادة، وطبيعة السلطة. تحولت البلاد إلى ساحة لتجارب سياسية وأيديولوجية متضادة، سرعان ما أصبحت – في غياب المرجعية الوطنية الجامعة – مشاريعَ سلطوية تتنازع تمثيل الثورة بدل أن تخدم أهدافها. وفي هذه المساحات الرمادية، لم يبرز فقط غياب الدولة، بل الأدهى: بروز سلطات متناحرة تدّعي تمثيل الدولة، بينما تهدم أسسها من الداخل.
من بين تلك المشاريع، يتصدر المشهد ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام"، بقيادة أبو محمد الجولاني ( أحمد الشرع)، بوصفه النموذج الأوضح لما يمكن تسميته بـ"السلطة البديلة المقنّعة"، أو "الدولة الدينية بلا مواطنين". إنه مشروع لا يسعى لإعادة بناء الدولة وفق أسس مدنية أو تعاقدية، بل يعيد إنتاج منطق الغلبة، والوصاية العقائدية، والإقصاء تحت رايات دينية. بهذا المعنى، لا تمثل الهيئة انتقالاً من الاستبداد إلى الحرية، بل من استبداد قومي مركزي إلى استبداد ديني تفكيكي، يحمل من سمات النظام البعثي ما هو أكثر قسوة، ولكنه يغلفها هذه المرة بخطاب شرعي لا يقر بحقوق الآخر، ولا يعترف بالتعدد، ولا يفهم المواطنة إلا ضمن حدود "الطاعة".
لقد ولد انهيار النظام المركزي فراغاً سياسياً، كان من المفترض أن تملأه قوى ديمقراطية بديلة، تعبر عن مطالب الثورة وتترجمها إلى بنى تشريعية ومؤسساتية جديدة. لكن ما حدث في شمال سوريا – لا سيما في مناطق إدلب – هو نقيض ذلك تماماً. إذ تم ملء الفراغ بسلطة تستند إلى العنف الرمزي والمادي، وتفرض شرعيتها من خلال التدين المسيّس، لا من خلال التعاقد المدني. وعلى الرغم من ادعائها أنها تمثل "السنّة" بوصفهم مكوّناً اجتماعياً كبيراً في سوريا، إلا أنها – في جوهرها – لا تمثل إلا فئة عقائدية متشددة الإرهابية اختزلت الإسلام السياسي في نسخته الأشد انغلاقاً وتكفيراً.
الخطير في هذا التحولً ليس فقط في كونه يفشل مشروع الثورة، بل في أنه ينتج سردية مشوهة عن الدولة ذاتها: حيث تتحول من فضاء مشترك، إلى غنيمة. ومن آلية لحماية التنوع، إلى أداة لفرض التماثل. ومن مؤسسة سيادة، إلى هيكل إيديولوجي يخضع لفتوى الأمير لا لمبادئ القانون. هذا هو جوهر الأزمة: سلطة تدعي أنها بديل، بينما لا تمتلك لا شرعية الدولة، ولا مشروعها، ولا أداتها القانونية، ولا تصوراً عن الإنسان خارج حدود الطاعة.
ومن هذا المنطلق، فإن مأزق المشروع الإسلامي في سوريا – ممثلاً بهيئة تحرير الشام – لا يكمن فقط في طبيعته القمعية، بل في كونه يغلق كل أفق للتحول السياسي، ويعيد صوغ العلاقات الاجتماعية والسياسية على أساس ديني متشدد، يفرغ الثورة من مضمونها التحرري، ويعيد الشعب إلى مربع التسلط، ولكن هذه المرة باسم "الشريعة" لا باسم "القومية".
إن هذه الورقة تحاول أن تفكك خطاب الجولاني ليس من باب النقد الأيديولوجي فحسب، بل بوصفه نموذجاً لكيفية فشل المعارضة المسلحة في إنتاج بديل حقيقي للدولة. كما تحلل كيف تحولت السلطة الإسلامية من وعد بالخلاص إلى أداة جديدة للاستعباد، ومن بشارة سياسية إلى كابوس اجتماعي يعيد هندسة المجتمع على مقاس جماعة، لا وطن.
في زمنٍ تخترق فيه الحدود وتشطب فيه المعاني، لا يكفي أن نرفض النظام، بل علينا أن نرفض أيضاً ما يشبهه، حتى وإن رفع رايات "الثورة" أو "الشرع". فالثورة التي لا تتحرر من كل أشكال الطغيان، لا يمكنها أن تبني دولة، بل فقط أن تعيد إنتاج المأساة.
أولاً: الهزيمة كوعي غائب: الإنكار كأداة سلطوية
في النظم السياسية المتصدعة، لا يقاس الفشل فقط بنتائج المعارك أو انكسارات الجغرافيا، بل يقاس أولاً بمدى قدرة الفاعل السياسي على مواجهة الهزيمة بوصفها لحظة للوعي النقدي، وإعادة تقييم المسار. لكن في خطاب أبو محمد الجولاني ( أحمد الشرع) – كما في خطاب كثير من رموز السلطوية الحديثة – تغيب هذه القدرة تماماً، بل يتم استبدالها بتقنية خطيرة: الإنكار بوصفه بنية سياسية متكاملة، لا مجرد موقف ظرفي أو انفعال عابر.
الجولاني، في ظهوره الإعلامي الأخير، لا يعترف لا بهزيمة سياسية ولا بعزلة اجتماعية ولا حتى بانكماش جغرافي. يتحدث كما لو كان ممثلاً للثورة، وقائداً لمشروع تحرري، وصوتاً لأكثرية مفترضة. هذا الإنكار المنهجي لا يعبّر عن جهلٍ بالواقع، بل عن تصميم واعٍ على تجاوز الواقع بتزويره، وإنتاج سردية بديلة تبرر البقاء في السلطة، ولو على حساب الحقيقة والمنطق.
إننا أمام مشهد مألوف في تاريخ الأنظمة الشمولية: تحويل الهزيمة إلى انتصار رمزي مؤجل، وتحويل النقد إلى خيانة، وتحويل المأزق إلى "مرحلة انتقالية" ضرورية. إنها نفس التقنية التي استخدمها النظام البعثي بعد نكسة حزيران 1967، حين اعتبر أن الحفاظ على "وحدة الجبهة الداخلية" أهم من استعادة الأرض، وأن "صمود النظام" هو الانتصار بعينه، حتى وإن ضاعت الجغرافيا وانهار المعنى. الفارق الوحيد أن الجولاني يستبدل القومية بالشريعة، لكنه يحافظ على الجوهر ذاته: أولوية السلطة على الوطن، والهيئة على الشعب، والبقاء على التغيير.
ما يجب فهمه هنا، أن الإنكار في هذا السياق ليس هروباً من الواقع فحسب، بل تدشين لواقع بديل، يعاد فيه تأويل الوقائع لصالح بقاء المنظومة الحاكمة. فالهزيمة لا تُقرّ بوصفها فشلاً، بل تعاد صياغتها كجزء من مسار "تمحيصي"، وكأن المعاناة قدرٌ إلهي لا نتيجة خيارات سياسية كارثية. وبهذا، يخلق خطاب محصّن ضد النقد، ومصمم لتخدير الجمهور، وإيهامه أن "النجاة قريبة"، وأن "الحق سيظهر"، ما دام القائد – أي الجولاني – على رأس الهرم.
لكن أخطر ما في هذا الإنكار، أنه ينتج ثقافة سياسية كاملة قائمة على الكذب المؤسسي، لا تقبل بطرح الأسئلة، ولا تترك مساحة للمحاسبة. فالاعتراف بالهزيمة يقوّض صورة "القائد المعصوم"، ويحرج خطاب "الشرعية الدينية"، ويفتح الباب أمام مساءلة شرعية العنف ذاته. لذلك، فإن الجولاني – ومن على شاكلته – لا يستطيعون أن يعترفوا، حتى لو أرادوا، لأن اعترافهم سيُسقط شرعيتهم دفعة واحدة.
بالتالي، فإننا لا نتحدث عن إنكار جزئي، بل عن استراتيجية متكاملة تُبنى عليها "شرعية ما بعد الحقيقة" التي تحكم مناطق سيطرة الهيئة. ويتم فيها إنتاج مشهد متخيّل عن النصر، يتم تعزيزه بخطاب تعبوي، وتصريحات إعلامية منمقة، واستدعاء دائم للعدو الخارجي (النظام البائد، الكورد، المسيحيين، العلويين، الدروز، الغرب...) كتبرير دائم لفشل المشروع، وتحويل كل مأزق داخلي إلى مؤامرة خارجية.
والنتيجة، أننا أمام عقل سياسي سلطوي يؤسّس للهزيمة القادمة حتى قبل أن تنتهي الهزيمة السابقة. عقل لا يملك مشروعاً للتحرير، بل مشروعاً للبقاء في السلطة. مشروع يحوّل كل من يختلف إلى "مخترق"، وكل من ينتقد إلى "مرتد"، وكل من يسأل إلى "متآمر"، في مشهد لا يختلف من حيث الجوهر عن ذهنية الأنظمة العربية التقليدية، التي حكمت شعوبها بالإنكار، وأسقطتها الهزائم واحدة تلو الأخرى.
إن هذا الإنكار المُمنهج، إذا لم يفكك ويعرّى، لن ينتج فقط سلطة جديدة تشبه القديمة، بل سيحبط أي مشروع بديل فعلي، وسيدفن بذور الثورة تحت ركام المزايدات الخطابية والشعارات المزيفة. لأن الوعي بالهزيمة شرطٌ للانتصار القادم، أما إنكارها فهو تمهيد لهزيمة أشمل، وأعمق، وأكثر فتكاً بالمعنى.
ثانياً: تفكيك خطاب "الدولة" عند القوى الإسلامية: من التوحيد إلى التفريد، ومن المجتمع إلى الإمارة
إن ما يقدّم اليوم على أنه "مشروع دولة" في خطاب القوى الإسلامية الجهادية، لا سيما "هيئة تحرير الشام"، هو في جوهره سلطة بدون دولة، ونظام بدون مجتمع، وهوية دون مواطنة. فخطاب الجولاني لا يتعاطى مع الدولة كفكرة قانونية-مؤسساتية قائمة على الشرعية التعاقدية والتعدد والحقوق، بل يعيد تعريفها بوصفها كياناً عقائدياً فوقياً، لا يقبل المساءلة، ولا يعرف إلا الولاء الأيديولوجي والانتماء الديني.
في هذا الخطاب، تتحول الدولة من كونها إطاراً جامعاً لكل المواطنين، إلى جهاز فرض إيماني يتماهى مع العقيدة السلفية الجهادية، ويختزل مفهوم الحاكمية إلى سلطة الأمير، لا سيادة القانون. ومثل هذه الرؤية لا تقتصر على الهيئة وحدها، بل تتقاطع مع ما رأيناه سابقاً في تجارب "الدولة الإسلامية" (داعش)، أو "الإمارة الإسلامية" لطالبان، حيث تم تجريد الدولة من مضمونها المدني الحديث، وتم اختزالها في مزيج من السلاح والفتوى والتراتبية الذكورية.
الهيئة، كما يظهر من ممارساتها وخطاب قادتها، لا تتجه نحو بناء مؤسسات دولة، بل نحو ترسيخ كيان شبه إماري، يدار بعقلية الجماعة المغلقة، ويفرض سلطته عبر تحالف مركب بين القوة العسكرية و"الشرعية الدينية"، التي تستدعى لتبرير كل قرار، من فرض اللباس، إلى قمع التظاهرات، إلى إغلاق المنظمات المدنية، أو تصفية الخصوم الفكريين والسياسيين.
وهنا نلحظ التفكيك المنهجي لمعنى الدولة الحديثة: حيث يتم استبدال السلطة التشريعية بـ"الهيئة الشرعية"، ويتم إلغاء استقلال القضاء لصالح "محاكم العقيدة"، وتُحلّ الشرطة المجتمعية لتحلّ محلها "الحسبة"، ويغدو الإعلام مجرد منبر تعبوي لا مساحة فيه للجدل أو النقد. لا أحزاب، لا نقابات، لا تعددية، لا صحافة حرّة... باختصار: لا مجتمع سياسي، بل فقط رعايا تحت إمرة الحاكم الشرعي.
الأكثر خطورة أن خطاب الجولاني يلبس هذا النموذج ثوب "الدفاع عن الأكثرية السنية"، لكنه في الحقيقة يقزم هذه الأكثرية، ويحولها إلى جماعة متخيلة يتم الحديث باسمها دون أن يسمع صوتها. يتم الحديث عن "حقوق السنّة"، لكن لا يسأل السنّة أنفسهم إن كانوا يقبلون بهذا النموذج السلطوي، أو يرغبون بدولة دينية مغلقة. بل يتم سجنهم داخل تصورات أحادية لا تترك مجالاً لا للاختلاف، ولا للتنوع داخل الطائفة ذاتها.
وإذا كان النظام البعثي قد مارس القمع باسم "الوحدة القومية" و"الهوية العربية"، فإن هيئة تحرير الشام تعيد إنتاج المنطق ذاته، ولكن بلغة "العقيدة الصحيحة" و"المنهج السلفي". فبدل أن تكون الدولة مظلة لكل السوريين، تتحول إلى حصن مذهبي، يتم فيه إقصاء الكورد بوصفهم انفصاليين، والمسيحيين بوصفهم كفاراً ذميين، والعلويين كأعداء عقائديين، والدروز كطائفة "مشتبه بها"... وبهذا المعنى، فإن خطاب الجولاني لا يخرج من بنية الدولة الأمنية الإقصائية، بل يعيد إنتاجها في هيئة دولة دينية متوحشة.
والحق أن هذه المقاربة لا تفشل فقط في بناء دولة، بل تجهض فكرة الوطن من أساسها. لأن الدولة، في تعريفها السياسي والفلسفي، لا تبنى على العقيدة، بل على القانون، ولا تدار بمنطق العصبة، بل بمنطق التعاقد، ولا تقوم على فكرة "الفرقة الناجية"، بل على تعدد الفرق، وتساويها في الحقوق والواجبات.
إن المشروع الذي تطرحه هيئة تحرير الشام، حين يفكك بعمق، يظهر بجلاء كنسخة مستنسخة من الأنظمة التي ثار السوريون ضدها، ولكنه يحمل خطراً مضاعفاً: فهو لا يعد فقط بنموذج سلطوي، بل يعد بنموذج سلطوي مقدس، مغلف بالفتوى، ومعزز بالبندقية، ومحمي بخطاب طهراني مغلق لا يجادل ولا يراجع.
وإذا ما استمر هذا النموذج بالتمدد، فإن مستقبل سوريا لن يكون دولة، بل فسيفساء من "السلطنات" الدينية والمذهبية، حيث تختزل الثورة إلى شعارات زائفة، ويحكم الشعب باسم الله، لا باسم الشعب، وتغلق الأبواب أمام أي أفق ديمقراطي حقيقي.
ثالثاً: الوطنية بين الخطاب والممارسة: من يخون من؟
من اللافت أن الجولاني يتهم الآخرين بالخيانة، في حين أن خطاب الهيئة وممارساتها على الأرض تنطوي على خيانة جوهرية لفكرة الوطن ذاته. فحين تجزأ سوريا إلى "إمارات" دينية ومناطق نفوذ تمولها دول خارجية، وتفرض على شعبها سلطة تجهل معنى التعدد والهوية الوطنية، فإننا لا نكون أمام تحرر، بل أمام استبداد مقنع.
من الذي تخلى فعلياً عن السيادة الوطنية؟ أليس من استبدل التفاوض السياسي بمقايضات استخباراتية؟ أليس من يتعامل مع الفصائل الأجنبية كأدوات للضغط والتخويف؟ من يفاوض الإسرائيليين سراً في أذربيجان، ويستنجد بتركيا لبسط نفوذه، لا يملك أي مشروعية للحديث باسم سوريا أو باسم الإسلام.
الوطنية ليست شعاراً يرفع في نشرات الأخبار، بل موقف يومي تقاس فيه الخيارات الفعلية لا الخطابات. ومن يربط مشروعه بسلطة ما وراء الحدود، ويمارس القمع في الداخل باسم "تحرير الشام"، لا يقل خطورة عن النظام الذي مارس الاستبداد باسم "الوحدة والحرية والاشتراكية".
رابعاً: تحولات النخبة: من التنوير إلى التبرير
من أخطر تحولات المشهد السوري، أن النخبة التي طالما كانت صوتاً للتنوير، أصبحت في كثير من الأحيان بوقاً للسلطة الجديدة. بعض الأسماء التي كانت في يوم ما ترمز إلى خطاب ديمقراطي نقدي، أصبحت اليوم أدوات تبرير للقمع تحت مسمى "الواقعية السياسية" أو "الحفاظ على الثورة". فأن تجد مثقفاً مثل برهان غليون، أو سياسياً كجورج صبرا، يحيي مشروعية الهيئة – ولو ضمنياً – فهذا يعني أن الانهيار لا يخص فقط السياسة، بل يطال البنية الفكرية للمجتمع المعارض ذاته.
لقد رأينا في التاريخ كيف تحول بعض المثقفين من دعاة للحرية إلى أدوات تبرير للأنظمة، لكن في الحالة السورية يبدو المشهد أكثر مأساوية: من تبرير استبداد قومي إلى شرعنة استبداد ديني، من خطاب الممانعة إلى خطاب الميليشيا. وكأن الثورة لم تكن سوى جسراً للعبور من ديكتاتورية إلى أخرى.
خامساً: بين الثورة والثورة المضادة: من يسرق الحلم السوري؟
كانت الثورة السورية، في لحظتها الأولى، أكثر من مجرد احتجاج على الاستبداد، كانت تمرداً وجودياً على نمط الحياة نفسه، على ثقافة الخوف، على العطالة التاريخية التي كبلت السوريين لعقود. لم تكن هبة مطلبية، بل لحظة انفجار وعي جمعي استثنائي، سعى فيها الإنسان السوري إلى استرداد صوته من أنظمة الصمت، ووجوده من جدران الزنازين، ومصيره من القدر السياسي المعلّب. إنها لم تكن تبحث عن بديل سلطوي، بل عن معنى جديد للعيش، عن وطن يشبه الناس لا يشبه السجون.
لكن ما إن بدأ هذا الحلم يتشكل، حتى تكالبت عليه قوى الثورة المضادة بأسماء متعددة: من النظام الذي حاول خنقه بالرصاص والتعذيب، إلى فصائل مسلحة اختطفت روحه وحولته إلى أداة للسيطرة، إلى قوى إقليمية ودولية رأت فيه فرصة لتصفية الحسابات لا لاستنهاض الحرية. فالثورة التي بدأت باسم "الحرية" اختزلت في "مشاريع سلطة"، وتحولت ساحتها إلى حلبة صراع بين أمراء الحرب، ومخابرات الدول، وأوهام الخلافة، وأطماع الإمارات، وبازارات التفاوض.
من سرق الثورة؟ لا يقتصر الجواب على النظام الذي واجه المطالب الشعبية بالدبابات، بل يتسع ليشمل كل من زعم تمثيل الثورة وضيّع بوصلتها. من نصب نفسه ناطقاً باسم الشعب وهو يعقد الصفقات في غرف الفنادق، من بدل شعارات الميادين بشعارات التنظيم، من حول النضال إلى استثمار سياسي، والحلم إلى مشروع فئوي. الثورة المضادة ليست فقط في القصر الجمهوري، بل في كل كيان يحول الثورة من مشروع تحرر إنساني إلى مشروع هيمنة حزبية أو دينية.
إننا أمام مشهد تتقاطع فيه الخيانة مع الجهل، وتختلط فيه الأجندات الخارجية بمآسي الداخل. مشهد تتوزع فيه خريطة سوريا بين ولاءات متناقضة، ولا أحد يتكلم بلغة الوطن. تتحدث الميليشيات عن "تحرير"، وهي تقمع أهلها. تتحدث الأنظمة عن "السيادة"، وهي ترهن القرار للخارج. وتتنافس الخطابات جميعها على تمثيل "سوريا"، بينما تقتل سوريا كل يوم على يد من يدعي حمايتها.
الحلم السوري لا يختزل في شعارات ولا رايات. إنه لحظة صدق خرج فيها الإنسان من ذاته ليطالب بعالم أعدل. وحين يغتال هذا الحلم بأيدي الداخل قبل الخارج، فإننا لا نكون فقط أمام "ثورة مضادة"، بل أمام نفي جذري للثورة كفعل وكقيمة.
وها هو الإنسان السوري، الممزق بين المنفى والمخيم والخراب، يسأل من جديد: من الذي سرق حلمك؟ والجواب، المرّ والمرعب، أن الحلم سرق حين تحولت الثورة إلى سلعة، والنضال إلى تمثيل، وسوريا إلى خريطة مصالح... بلا شعب.
خاتمة: النتيجة – بلا رتوش
لقد تعثرت الثورة السورية في أخطر فخاخها حين توهمت أن العداء للنظام يعني تلقائياً الانحياز إلى الحرية. ففتح هذا التوهم الباب واسعاً أمام قوى لا علاقة لها بمبادئ الثورة ولا بأحلام الناس، لتتسلل إلى قلب الحراك وتعيد تشكيله على صورتها، لا على صورة الوطن المنشود. هكذا جرى استبدال طغيان المركز بطغيان الهامش، وتحول الحلم الجماعي إلى ميدان صراع بين مشاريع سلطوية تتشابه في الاستبداد، وتتناقض فقط في الخطاب.
نحن لا نقف اليوم فقط أمام خيبة، بل أمام انقلاب جذري على معنى الثورة نفسه. من كان يفترض أن يكون حامياً لروح الثورة، صار جلاداً لها باسم "تحرير الشام". من يفترض به أن يطرد الاستبداد، بات يعيد إنتاجه بثوب جديد: خطابات دينية مفرغة، مقايضات أمنية مع الخارج، وقبضة حديدية على الداخل. هيئة تحرير الشام، بهذا المعنى، ليست انحرافاً عابراً في مسار الثورة، بل هي تعبير صارخ عن لحظة انهيار أخلاقي وفكري، حين تحل السلطوية محل التحرر، والمقدس محل السياسي، والخوف محل الأمل.
ليست المشكلة فقط في الهيئة، بل في كل من يروج لها بوصفها "قوة أمر واقع"، أو "شريكاً قابلاً" في الحل السياسي. فالتطبيع مع السلطوية، مهما كانت لبوسها، هو خيانة لجوهر الثورة. وكل من يبرر ذلك بحجج الواقعية السياسية أو الضرورات المرحلية، يشارك – بوعي أو بغير وعي – في ذبح المعنى الذي من أجله خرج السوريون إلى الشوارع ذات ربيع.
لقد أثبتت التجربة المرّة أن الثورة ليست مجرد لحظة صدام مع النظام، بل هي عملية معقدة لتفكيك بنيات الاستبداد في المجتمع والسياسة والدين والثقافة. ومن لا يرى في مشروع الجولاني إلا "قوة محلية" يتجاهل أنه جزء من منظومة أوسع تنتج العنف وتعيد إنتاج الانغلاق، تحت شعارات زائفة عن "التمكين" و"التحرير".
إن ما يرتكب باسم الثورة اليوم لا يقل فداحة عمّا ارتكبه النظام باسم "الوحدة والاشتراكية". فكلاهما صادر صوت الإنسان، وكلاهما استبدل الوطن بالراية، والمواطن بالرعية، والنقد بالطاعة. لكن الفارق الأخطر أن الاستبداد الجديد يمارس ذلك باسم الثورة، وباسم الشعب، وباسم الدين، في آن واحد.
الدرس القاسي الذي ينبغي أن يقال بلا رتوش هو أن الثورة لا تنتصر فقط بإسقاط النظام، بل بانتصار وعيها على نفسها. وأن الأعداء الأخطر ليسوا دوماً أولئك الذين نقاتلهم من الخارج، بل أحياناً أولئك الذين يتسللون إلى داخلنا، ويزرعون فينا بذور القهر تحت غطاء التحرير.
الثورة، في عمقها، ليست راية ترفع، ولا سلاحاً يُشهر، ولا فصيلاً يمول، بل هي حالة وعي أخلاقي وجمالي، تتجدد أو تموت. والوعي الذي لا يراجع نفسه، لا ينتصر. والثورة التي لا تحاسب أبناءها قبل خصومها، يعاد احتلالها... من داخلها.