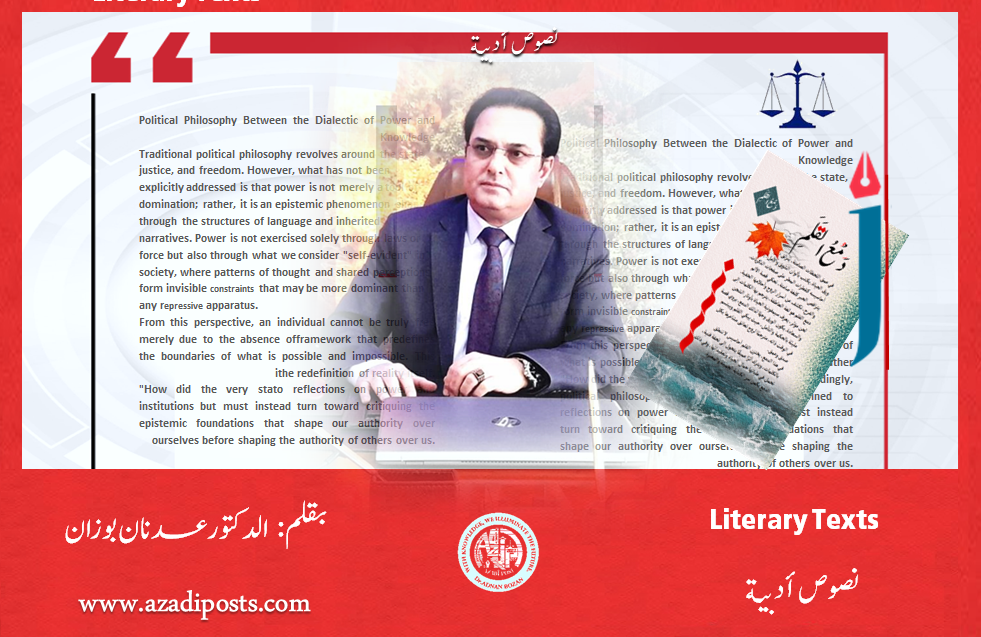 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
لم أكن يوماً فيلسوفاً على الطريقة الكلاسيكية، ولا كاتباً يغريه وهج المعاجم أو سحر المصطلحات، بل كنت دوماً أشبه برجلٍ يعيش في دهليزٍ من المرايا؛ كلّما ظن أنه وجد لنفسه وجهاً أخيراً، تكشفت له صورة أخرى من ذاته، صورة مغايرة، أكثر هشاشةً، أو أكثر اتساعاً.
قرأتُ كانط كما يقرأ اليتيم وصيّة أبيه الغائب، وقرأت فوكو كما يقرأ السجين مذكّرات الحرية، ووقفت طويلاً أمام أفلاطون كما يقف الغريب أمام أبواب مدينةٍ لا يعرف إن كان خرج منها، أم لم يدخلها أصلاً.
قرأتُ الغزالي لا لأتبعه، بل لأبحث عن الظل الذي تركه حين ارتجف قلبه بين العقل والوحي، وقرأت ابن رشد كما يُقرأ الضوء في منتصف العاصفة؛ ضوء لا ينقذ، لكنه يذكرك أن العالم لا يزال هناك… في مكانٍ ما.
لم يكن هدفي أن أُقلد أحداً، ولا أن أتنكّر لهم، بل كنت أستعير مفاتيحهم لأطرق بها أبواباً لم يقصدوها، وربما لم يتخيلوها يوماً. كنت أُقلِّب كتبهم كما يقلب الحالم دفاتر نومه، لا ليعرف ماذا حلم، بل ليفهم لماذا لا يزال قلبه يرتجف كلما أغمض عينيه.
لقد علّموني جميعاً كيف أفكّر، ثم نسيت ذلك كلّه.
نسيت الطرق التي سلكوها، لكن خطواتي لا تزال ترتعد كلما عبرت درباً جديداً. نسيت أقوالهم، لكن وقعها لا يزال يتردّد في أذني كأنها صوتي أنا، صوت لم أنطقه بعد.
أنا تلميذ النسيان، ولكن ليس نسيان الجاهل، بل نسيان الحكيم الذي أدرك أن ما يبقى في القلب ليس ما يدوَّن في الهوامش، بل ما يتسرب خفيةً دون أن يقال، ما يزرَع في الفجوات بين الفكرة والفكرة، في الصمت الذي يفصل الكلمات، في ارتباك العبارة، في الدهشة، في ما لا يُشرَح.
لقد تعلمت من ابن سينا كيف ينهض العقل وسط الخراب، ومن الباقلاني كيف تنطق الحجة في وجه الصمت، ومن باشلار كيف يكون الخيال أصدق من الواقع، ومن هيوم كيف تُهدَم القناعات دون أن يتهدّم القلب. وتعلّمت من ديكارت أن الشكّ لا يقتل الحقيقة بل يحرّرها، ومن سبينوزا أن الله ليس مبدأً نعبده، بل نَسقاً نتحرّر عبره.
لكنني حين أكتب، لا أستحضرهم. لا أستدعيهم كما تُستدعى الأشباح في ليالي العزلة. أنا لا أكتب بفكرهم، بل بما تبقّى مني بعد أن عبرت أفكارهم جسدي وغادرتني دون أن ألاحظ. أكتب بما غمرني منهم دون أن يسمى، بما رسخ في قاع ذاتي مثل طينٍ لا يُغسل.
هذا الذي بقي، الذي لا يستعاد، الذي لا أعرف كيف ومتى ولماذا تشكل في أعماقي… هو ما يمنحني الحق في القول، والحق في الصمت.
أنا لست تابعاً لأحد، ولا وريثاً لمذهب، ولا سليلاً لمدرسةٍ فكرية واحدة. أنا حفيد المجهولين، ابن الأسئلة الضالّة، ربيب الحيرة.
أكتب لأنني لم أعُد أحتمل الصمت. وأفكّر لأنني لا أعرف كيف أعيش دون أن أنقّب في المعنى.
ولعلّي، في نهاية المطاف، لا أطلب إلا شيئاً بسيطاً ومعقداً: أن أكون شاهداً. لا نبيّاً، ولا معلّماً، فقط شاهداً على عبور الإنسان من ظلٍّ إلى ظلّ، دون أن يبلغ النور تماماً.
كل ما أعرفه الآن، أنني كتبت كثيراً دون أن أقول ما أردت، وفكرت طويلاً دون أن أعرف إن كنت على صواب، وأحببت الكلمات كما يحب العطشان خيالاتِ الماء في البيداء.
لكنني، في كل مرة أعود فيها إلى الورقة، أشعر أن شيئاً ما لا يزال في الانتظار:
فكرة لم تولد بعد، جملةٌ تراوغني، معنى يختبئ في انكسار الضوء على حرفٍ نائم.
ربما لا أكون أكثر من صدى لأصواتٍ سبقتني، وربما كل ما في من فرادةٍ هو طريقة ارتجافي حين أنطق ما ظنوه بديهياً.
أنا تلميذهم جميعاً، نعم... لكنني تلميذٌ تعلّم أكثر مما قدم له، لأنه نسي الدروس، وراح يكتب من النسيان نفسه.


