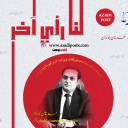الملف الكوردي في سوريا: بين سلطة الأمر الواقع واتفاقات الغموض
- Super User
- ملفات سياسية
- الزيارات: 3883
 بقلم: د. عدنان بوزان
بقلم: د. عدنان بوزان
مقدمة:
في الجغرافيا السياسية المتصدعة لسوريا ما بعد الحرب، يظل الملف الكوردي أحد أعقد وأثقل الملفات على طاولة التفاوض الوطني. فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وحتى تشكيل ما يُعرف بـ"السلطة الجديدة في دمشق" برئاسة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تشكلت خريطة نفوذ جديدة حملت معها تغيرات جذرية في توازن القوى، ليس فقط على صعيد التحالفات الإقليمية والدولية، بل أيضاً في إعادة رسم الهوية السياسية والاجتماعية لكثير من المكونات السورية، وعلى رأسها الكورد.
الوجود الكوردي في سوريا لم يكن يوماً طارئاً على جسد الدولة، بل كان دوماً هامشاً مهمّشاً، يُطلب منه الصمت عندما تُملى الشعارات الوطنية الكبرى، ويُستدعى فقط عندما يحتاج النظام إلى "مناورة إثنية" أو "رسالة سياسية" إلى الخارج. ومنذ أن اتخذ الكورد موقفاً مختلفاً في الثورة – موقفاً معقّداً، مرناً، قائماً على تقاطع المظلوميات بدلاً من الاندماج الكلي في الاصطفافات – بدأت الأنظار تتجه إلى هذه الكتلة الجغرافية والديمغرافية بوصفها "مشكلة مستقبلية"، لا "شريكاً في إعادة التأسيس".
تَشَكُّلُ تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا جاء في لحظة فراغ سياسي وأمني، فاستغلت قسد وواجهتها السياسية (الإدارة الذاتية) هذا الفراغ لبناء نموذج سياسي غير مسبوق في التاريخ السوري، قائم على اللامركزية، التعددية، والمشاركة الجندرية. لكن هذا النموذج، بدل أن يُناقَش كخيار وطني بديل، وُوجه منذ البداية بالريبة من الداخل السوري، وبالعداء من المحيط الإقليمي، وبالتوظيف التكتيكي من القوى الدولية.
ثم جاءت التحولات الأخيرة، وعلى رأسها الانقلاب السياسي العنيف المتمثل في سيطرة "هيئة تحرير الشام" على دمشق وتعيين أحمد الشرع رئيساً لما سُمّيت بـ"الحكومة الجديدة"، لتفتح فصلاً جديداً من الصفقات السياسية والتقلبات في التحالفات، حيث باتت بعض الأطراف تتحدث عن "إعادة كتابة العقد الاجتماعي السوري" بشكل لا يخلو من محاولات القفز فوق حقوق مكونات كاملة من الشعب السوري، بل ومحو تاريخها ووجودها بجرة قلم، تحت شعار "المؤتمر الوطني" أو "اللامركزية المشروطة".
في هذا السياق الملتهب، يجد الكورد أنفسهم عالقين بين معادلات مستحيلة: سلطة مركزية تريد عودتهم إلى ما قبل 2011 دون ضمانات، ومعارضة مسلحة تتحول إلى سلطة جديدة تحمل إرثاً من الإجرام والإرهاب والإقصاء الأيديولوجي، وقوى دولية تستخدم الورقة الكوردية دون أن تضع على الطاولة مشروعاً جاداً للحل.
تتساءل هذه الدراسة: هل الكورد اليوم جزء من عملية تأسيس سوريا جديدة... أم مجرد ورقة تفاوض تُحركها أيادي الخارج؟ هل يملك الكورد القدرة على فرض خطاب وطني جامع يتجاوز الهويات القومية الممزقة؟ وما مستقبل مشروع الإدارة الذاتية في ظل هذه المتغيرات؟
الملف الكوردي ليس مجرد قضية قومية، بل هو مرآة لكل ما فشلت فيه سوريا: من غياب الدولة المدنية، إلى الإنكار المزمن للتعدد، إلى عجز النخب عن إنتاج عقد اجتماعي يَسَع الجميع. ولذلك، فإن مصير هذا الملف لا يعكس فقط مصير الكورد، بل يحدد شكل سوريا القادمة، إن كُتبت لها ولادة جديدة.
أولاً: الكورد وسنوات الثورة السورية
لم يكن للكورد دوراً ثانوياً في الثورة السورية كما تحاول بعض الروايات الإقصائية أن تصوّر، بل كان حضورهم منذ اللحظة الأولى حضوراً أصيلاً ومركزياً في دينامية الحراك الشعبي. ففي مدن الشمال الشرقي مثل عفرين ، كوباني، القامشلي، عامودا، وديريك، صدحت الحناجر الكوردية بشعارات الثورة السورية جنباً إلى جنب مع باقي أصوات السوريين، مطالبة بالحرية والكرامة، منادية بإسقاط نظام الاستبداد الذي لم يوفر أحداً من بطشه، لا عرباً ولا كورداً ولا سرياناً ولا أي مكون آخر.
لكنّ الكورد دخلوا الثورة وهم يحملون جرحاً تاريخياً أعمق من مجرد معارضة سياسية للنظام البعثي، إذ كانوا محرومين من أبسط حقوقهم القومية، مثل تعليم اللغة الأم، واستخدام الأسماء الكوردية، وتسجيل المواليد، فضلاً عن حرمان عشرات الآلاف منهم من الجنسية السورية منذ إحصاء 1962 الشهير في محافظة الحسكة وتغيير الديمغرافي في المناطق الكوردية. وبالتالي، كانت الثورة للكورد فرصة مزدوجة: للتحرر السياسي من الاستبداد، والتحرر الثقافي من سياسات الصهر القومي.
غير أن المشهد الثوري لم يكن بسيطاً، ولم يكن موحداً. فمع عسكرة الثورة، وصعود الفصائل المسلحة ذات الطابع الإسلامي أو العروبي الحصري، ومع انخراط جهات إقليمية متعددة في تمويل وتسليح هذه الفصائل، بدأ الكورد يشعرون بأن الخطاب الثوري ينزاح عن شعاراته الجامعة، ويتحول إلى أداة أخرى من أدوات الإقصاء القومي. ولذلك، لم يكن غريباً أن يتراجع الحضور الكوردي في بعض المفاصل المركزية للمعارضة، لا بسبب "حيادهم" كما يُقال، بل بسبب شعورهم العميق بأن الثورة تُختطف من داخلها.
في هذه الأثناء، برز "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" كقوة سياسية وتنظيمية تسعى إلى ملء الفراغ في المناطق الكوردية بعد انسحاب النظام البعثي منها تدريجياً، ليس بفعل توافق مباشر، بل بحسابات أمنية تخص النظام نفسه. سرعان ما تأسست وحدات حماية الشعب YPG، ثم قوات سوريا الديمقراطية لاحقاً كتحالف متعدد المكونات، وكان الكورد يشكلون عموده الفقري، ما أتاح لهم حماية مناطقهم، وفرض شكلٍ جديدٍ من الإدارة المدنية، أطلق عليه لاحقاً اسم "الإدارة الذاتية الديمقراطية".
هذه التجربة – على محدوديتها ووقوعها تحت الضغوط الدولية والإقليمية – مثّلت أول محاولة جدّية للكورد للمشاركة في إعادة تخيّل سوريا المستقبل، ليس كمجرد أقلية تطلب الاعتراف، بل كمكون وطني يقدم مشروعاً سياسياً واجتماعياً قائماً على اللامركزية، وتعدد الهويات، والمساواة الجندرية، وحقوق الأقليات.
إلا أن هذا المسار لم يكن خالياً من الإشكاليات؛ إذ وُوجهت تجربة الإدارة الذاتية باتهامات من قبل المعارضة السورية التقليدية بأنها "انفصالية"، رغم أن كل الوثائق الرسمية الصادرة عنها كانت تؤكد على وحدة الأراضي السورية، وعلى أن مشروعها لا يتعدى كونه حلاً ديمقراطياً لا مركزياً ضمن سوريا موحدة.
في النهاية، يمكن القول إن موقف الكورد من الثورة السورية لم يكن موقفاً انسحابياً، بل كان تعبيراً عن محاولة عقلانية للتموضع في خريطة معقّدة، كانت تنذر منذ البداية بأن الثورة ستنقلب إلى حرب، وأن الشعوب غير المحمية بخطاب واضح وهياكل تنظيمية قوية ستدفع أثماناً مضاعفة.
ثانياً: حكومة أحمد الشرع (الجولاني) وصعود خطاب جديد
في مشهد سياسي لم يكن أكثر المراقبين جرأةً ليتنبأ به قبل سنوات، برز أحمد الشرع، المعروف باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني"، من بين ركام الحرب الأهلية السورية، متحولاً من زعيم فصيل جهادي مصنف على لوائح الإرهاب الدولية إلى رأس حكومة أمر واقع في دمشق، تملأ فراغ السلطة الذي خلفه انسحاب القوات الروسية والإيرانية بفعل الضغوط الدولية والانهيار الداخلي للنظام الأسدي.
هذه التحولات لم تكن لحظة عفوية، بل ثمرة هندسة سياسية معقدة اشتركت فيها قوى إقليمية دفعت باتجاه إعادة تدوير فصائل المعارضة المسلحة، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، ضمن مشروع يهدف إلى توطين الحل السوري داخل جغرافيا النفوذ المحلي، في مقابل تخفيف حدة التدويل وفك الارتباط بالملف الإيراني.
تحت عنوان "سوريا للسوريين"، طورت حكومة الجولاني خطاباً سياسياً جديداً يحاول تجاوز ماضي الهيئة الجهادي، ويقدّم نفسه كبديل وطني للنظام الأسدي، مستنداً إلى قاعدة شعبية في بعض المناطق، وإلى شبكات أمنية واقتصادية راكمتها الهيئة على مدى سنوات. لكن هذا الخطاب – رغم تجديده الشكلي – لم يستطع الانفكاك التام عن جذوره الإيديولوجية الإسلامية المحافظة، إذ لا يزال يعتمد في جوهره على تفسير ديني للهوية السورية، وعلى تصور قومي – إسلامي يمزج بين مفاهيم الأمة والدولة في قالب إقصائي ناعم.
وهنا تبرز المفارقة الأكبر: فحكومة الجولاني، وإن رفعت شعارات تتحدث عن وحدة البلاد وبناء المؤسسات، فإن بنيتها الفكرية تُبقيها قاصرة عن تمثيل المكونات غير العربية وغير السنية من الشعب السوري، وفي مقدمتهم الكورد، الذين بنوا خلال العقد الأخير مشروعاً سياسياً واجتماعياً متكاملاً يقوم على قيم مدنية، علمانية، وحقوقية، ويرتكز على التعددية واللامركزية بوصفها مبدأ تأسيسياً لا مجرد تكتيك مرحلي.
هذا التباين الجذري بين مشروعين: أحدهما قومي – إسلامي محافظ، والآخر تعددي – علماني لامركزي، يجعل أي محاولة لعقد اتفاق سياسي بين "قسد" من جهة، وحكومة الجولاني من جهة أخرى، محفوفة بالتوتر والغموض. فمن جهة، تخشى الإدارة الذاتية من أن يكون أي تفاوض مجرد مرحلة انتقالية قبل محاولات تفكيك مشروعها بالكامل، خاصة وأن الجولاني لم يُبدِ حتى الآن أي التزام علني بحقوق الكورد الثقافية أو السياسية. ومن جهة أخرى، يخشى تيار الجولاني من أن قبول مشروع الإدارة الذاتية، حتى بشكل صوري، سيُفقده شرعيته داخل قواعده العقائدية التي تربت على فكر أُحادي الهوية.
ومع أن بعض المبادرات ظهرت في الكواليس، تدفع باتجاه "تفاهم أمني" أو "تقسيم إداري" مؤقت بين الطرفين، إلا أن هذه المحاولات غالباً ما تُجهض إما بسبب غياب الثقة، أو بسبب ضغوط إقليمية – خصوصاً من تركيا التي ترفض أي شكل من أشكال الاعتراف بقسد أو بالإدارة الذاتية – أو بسبب الخوف من انفجار داخلي في أحد الطرفين في حال تم الإعلان عن اتفاق لا يحظى بقبول شعبي داخلي.
الخطاب الجديد الذي يطرحه الجولاني يواجه أيضاً تحدياً وجودياً: هل يستطيع أن يتحول من خطاب انتقالي إلى برنامج دولة؟ وهل يمكنه أن يحتمل التعدد والتنوع؟ أم أنه سيعيد إنتاج نسخة "سنية" من الدولة البعثية ولكن بلبوس ديني هذه المرة؟ وإذا كانت هذه الدولة تنظر إلى الكورد كـ"حالة مؤقتة" أو "مشكلة يجب تطويعها"، فإن ذلك ينذر بموجة جديدة من الصراع، لا تقل خطورة عن سنوات الحرب الأولى.
في النهاية، لا يكفي أن تسقط دكتاتورية الأسد ليولد نظام وطني حقيقي، بل يجب أن يتأسس هذا النظام على اعتراف واضح لا لبس فيه بحقوق جميع المكونات، وفي طليعتهم الكورد، لا كمجرد حلفاء تكتيكيين في مرحلة ما، بل كجزء أصيل من نسيج البلاد، ومن مشروع الدولة الديمقراطية المقبلة.
ثالثاً: قسد وحكومة الجولاني: بين التفاهم المستحيل والصدام المؤجل
لا يمكن فهم العلاقة المحتملة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وحكومة أحمد الشرع (الجولاني) إلا بوصفها نتاجاً لتضاد جوهري بين مشروعين متناقضين في الرؤية والبنية والسياق التاريخي. فمن جهة، تمثل قسد الذراع العسكرية لمشروع الإدارة الذاتية الذي نشأ في خضم فراغ الدولة وانهيار مؤسساتها، واستند منذ بداياته إلى خطاب ديمقراطي، علماني، ولامركزي، يرفع لواء "أخوة الشعوب" وحقوق المرأة، ويتبنى نموذج "الكونفدرالية الديمقراطية" كبديل عن الدولة القومية.
ومن جهة أخرى، تمثل حكومة الجولاني تطوراً لمشروع ديني محافظ، خرج من عباءة الحركات الجهادية، ويسعى الآن إلى الانتقال من الفصائلية المسلحة إلى بناء مؤسسات دولة مركزية، ولكن وفق تصور خاص عن الهوية والدين والدور الاجتماعي والسياسي للفرد والجماعة.
في الظاهر، قد تبدو هناك لحظة "تقاطع مصالح" بين الطرفين: كلاهما يعارض نظام الأسد، وكلاهما يتموضع خارج التحالفات الإقليمية التقليدية (وإن بدرجات متفاوتة)، وكلاهما يحاول أن يقدم نفسه كبديل سياسي قابل للحياة. لكن هذه المصالح السطحية تخفي تحتها خنادق عميقة من التناقضات الأيديولوجية والتاريخية، تجعل من مجرد الجلوس إلى طاولة الحوار أمراً ملتبساً ومحمّلاً بالشكوك المتبادلة.
1. فجوة الثقة والتجربة السابقة:
يعود جزء كبير من الحذر المتبادل إلى التجربة القاسية التي خاضها الكورد في علاقتهم مع فصائل المعارضة المسلحة خلال سنوات الحرب. إذ تعرّضت مناطقهم مراراً لهجمات من فصائل محسوبة على "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" و"داعش"، وكلها كانت تتبنى خطاباً دينياً أو قوميّاً إقصائياً تجاه الكورد. ورغم محاولات الجولاني الأخيرة لإعادة تقديم نفسه كرجل دولة أكثر من كونه قائداً لجماعة سلفية، فإن التاريخ الثقيل لهذا التيار لا يزال حاضراً في الذاكرة الجمعية الكوردية، ويجعل من أي تقارب مشوباً بالريبة.
2. الخريطة الإقليمية والفيتو التركي:
أي اتفاق بين قسد والجولاني يصطدم أيضاً بالمعادلة الإقليمية المعقدة، خصوصاً الموقف التركي. فتركيا، التي تعتبر قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني، ترفض الاعتراف بأي صيغة سياسية أو إدارية تتضمن اعترافاً بـ"قسد" أو بالإدارة الذاتية، وتضغط باستمرار على أي قوى سورية معارضة لمنعها من الانخراط في حوار مع الكورد، بل وتشترط على بعض فصائل المعارضة فك الارتباط مع قسد كمدخل لأي دعم سياسي أو عسكري.
في المقابل، لا تستطيع حكومة الجولاني أن تتحرك خارج هامش المناورة المسموح به إقليمياً، حتى لو كانت تمتلك هامشاً أوسع بعد خروجها من العباءة التركية جزئياً. ولذلك، فإن أي تفاهم مع قسد قد يكلّفها فقدان شرعية إقليمية هي بأمسّ الحاجة إليها في الوقت الراهن.
3. لعبة الداخل: ماذا تريد قسد؟ وماذا يريد الجولاني؟:
تسعى قسد إلى الحفاظ على مكاسبها السياسية والعسكرية التي راكمتها خلال عقد من الصراع، وتعمل على تثبيت نموذج الحكم الذاتي ضمن أي تسوية سورية مقبلة، سواء مع النظام أو مع المعارضة. وهي مستعدة للتفاوض – بل ربما للمشاركة – في صيغة وطنية جديدة شرط أن تعترف بخصوصية المناطق الكوردية وبالهوية السياسية للإدارة الذاتية.
أما الجولاني، فهو يطمح إلى توسيع شرعيته من خلال ضم مناطق جديدة أو استيعاب قوى أخرى تحت مظلته، لكن من دون تقويض الخطاب المحافظ الذي يشكل قاعدته الجماهيرية. ولهذا، فإن قبوله المبدئي بالحوار والاتفاق مع قسد سيكون تكتيكياً أكثر منه استراتيجياً، وغايته كسب الوقت أو تحسين التموضع.
4. احتمالات المستقبل: صدامٌ مؤجل أم تقاطع مرحلي؟:
في ظل هذه المعطيات، تبدو خيارات الطرفين محدودة:
• التحالف الاستراتيجي مستبعد، لأن أي اندماج بين مشروع علماني تعددي ومشروع ديني محافظ سيفكك هوية الطرفين معاً.
• الصدام العسكري مفتوح الاحتمالات، خصوصاً إذا شعرت حكومة الجولاني أنها بحاجة إلى "نصر قومي" يعزز صورتها، أو إذا حصلت على ضوء أخضر إقليمي لضرب مشروع الإدارة الذاتية.
• أما الخيار الثالث، وهو التعايش المؤقت أو إدارة خطوط التماس بتفاهمات ميدانية (كما حصل أحياناً في منبج والمناطق الكوردية في حلب)، فهو الأكثر واقعية في المدى القريب، لكنه هشّ وقابل للانهيار في أي لحظة.
رابعاً: اتفاق السلطة الجديدة مع قسد: تسوية أم هدنة؟
برزت تقارير عن مفاوضات سرية بين حكومة الجولاني و"قسد"، تتضمن:
1- اعتراف مشروط بالإدارة الذاتية كمكوّن إداري لا سياسي.
2- دمج قسد في "الجيش السوري الجديد" بترتيب خاص.
3- مشاركة رمزية للكورد في حكومة انتقالية مقابل تخليهم عن أي طموح فدرالي أو انفصالي.
لكن هذه البنود لم تُعلن رسمياً، ولم تُحسم قضايا أكثر تعقيداً مثل:
1- مصير التعليم باللغة الكوردية.
2- السيطرة على الموارد في الجزيرة.
3- تمثيل الكورد في دستور جديد محتمل.
إنها أشبه بـ"هدنة باردة" أكثر منها اتفاقاً حقيقياً.
خامساً: الحقوق الدستورية للكورد في سوريا: من التهميش إلى الإنكار
منذ ولادة الكيان السوري الحديث إثر سقوط الدولة العثمانية ورسم الحدود المصطنعة باتفاقيات استعمارية، لم تكن الدولة السورية سوى انعكاس لرؤية ضيقة للهوية الوطنية، قوامها العروبة بوصفها الهوية الوحيدة المعترف بها. في هذه السياقات، لم يكن تغييب الكورد مجرد "نسيان عرضي"، بل كان فعلاً مؤسَّساً ومقصوداً، يهدف إلى بناء دولة قومية عربية متجانسة، على حساب التعددية القومية والثقافية التي كانت – ولا تزال – تشكل البنية العميقة للمجتمع السوري.
1. الدساتير السورية وتغييب الكورد:
ابتداءً من دستور عام 1950، ومروراً بدساتير 1962 و1973، وحتى دستور 2012، حافظت النصوص الدستورية على صيغ موحدة تنظر إلى سوريا كوطن عربي، وإلى الشعب السوري كجزء من "الأمة العربية". هذه الصيغة – التي قد تبدو للبعض مجرد لغة خطابية – كانت في الواقع المظلة الأيديولوجية لكل أشكال الإقصاء السياسي والثقافي واللغوي التي مورست بحق الكورد وغيرهم من غير العرب في البلاد.
في دستور 1973، الذي كُتب في ظل حكم البعث، جرى ترسيخ "العروبة" كمحدد وحيد لهوية الدولة، وتم إدراج ذلك في المادة الأولى بشكل قاطع، دون أي إشارة حتى إلى التنوع أو التعدد الثقافي. أما المادة الثامنة، التي كرّست حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، فقد أعطت شرعية مطلقة لأجهزة القمع والسياسات التمييزية ضد أي صوت خارج عن النسق البعثي العروبي.
ولم يكن دستور 2012 الذي جاء بعد اندلاع الثورة السورية، سوى استمرار لنهج الإنكار وإن كان بلهجة أخف. إذ أُزيلت بعض البنود التي كانت تعتبر "البعث قائداً للدولة"، وتم إدراج مفردات عامة مثل "الوحدة الوطنية" و"الهوية السورية الجامعة"، لكن دون أي اعتراف صريح بالقوميات الأخرى. بل ظل الكورد، وهم يشكلون نحو 15–20٪ من السكان، غائبين كلياً عن النص الدستوري، لا يُذكر اسمهم، ولا يُعترف بلغتهم، ولا تُقرّ لهم أي حقوق ثقافية أو سياسية أو إدارية خاصة.
2. الإقصاء القانوني والإداري: تجليات الإنكار
لم يكن التهميش دستورياً فقط، بل ترجم إلى سياسات منهجية على الأرض، منها:
• الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، الذي جُرّد فيه أكثر من 120 ألف كوردي من الجنسية السورية، تحت ذريعة "التسلل من تركيا"، مما حرم أجيالاً من أبسط حقوق المواطنة كالتعليم والتوظيف والتملك.
• مشروع "الحزام العربي"، الذي نفّذ في سبعينيات القرن العشرين، وكان يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المناطق الكوردية عبر توطين عشائر عربية في الشمال الكوردي (الجزيرة)، ومنحهم أراضي كانت تعود تاريخياً للفلاحين الكورد.
• حرمان اللغة الكوردية من أي وجود رسمي أو حتى شبه رسمي، ومنع تداولها في المدارس أو وسائل الإعلام أو الوثائق، في سياسة تهدف إلى قطع الذاكرة الجمعية الكوردية عن جذورها.
3. من المقاومة الثقافية إلى الطموح الدستوري:
رغم هذا التهميش الطويل، لم يتخلّ الكورد عن حلم الاعتراف والتمثيل. فكانت الثقافة وسيلة مقاومة، وظلت اللغة الكوردية تُنقل شفهياً في البيوت، وتُدرّس سراً في الكتاتيب، وتُغنّى في الأعراس والمناسبات، كنوع من المقاومة الرمزية.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وتحرر بعض المناطق الكوردية من قبضة النظام الأسدي الإجرامي، وُلدت تجربة الإدارة الذاتية كإطار سياسي وإداري يطرح نموذجاً جديداً لمفهوم المواطنة والانتماء. وباتت اللغة الكوردية تُدرّس رسمياً، وظهرت الصحف والإذاعات والمدارس والمؤسسات الكوردية، في لحظة تاريخية غير مسبوقة من التعبير عن الهوية.
لكن هذا الحلم لا يزال يفتقر إلى الغطاء الدستوري على المستوى الوطني. فلا النظام يعترف بالإدارة الذاتية، ولا المعارضة السورية – في معظم أطيافها – قبلت بدمج المشروع الكوردي ضمن رؤيتها للدولة المستقبلية، باستثناء مبادرات خجولة لا ترقى إلى مستوى الاعتراف السياسي الصريح.
4. نحو دستور جديد: الكورد طرف لا "مشكلة":
إن صياغة دستور جديد لسوريا ما بعد الحرب، لا يمكن أن تكتسب أي شرعية ما لم تكن تعبيراً عن الواقع التعددي للشعب السوري. والكورد، في هذا السياق، ليسوا مجرد "قضية تحتاج إلى حل"، بل هم جزء أصيل من الحل نفسه. والمطلوب هو دستور يعترف بالتعدد القومي، ويقرّ باللغات المحلية، ويمنح المجتمعات المحلية حقها في الإدارة الذاتية ضمن دولة لا مركزية، قائمة على الحقوق والمواطنة لا على الإنكار والإقصاء.
فالخروج من نفق التهميش يتطلب أكثر من اعتراف شكلي؛ إنه يستدعي قطيعة معرفية وسياسية مع خطاب "الهوية الواحدة"، وبناء سردية وطنية جديدة يكون فيها الكوردي شريكاً في الوطن لا طارئاً على الجغرافيا.
سادساً: محاولات محو الكيان الكوردي... بجرة قلم
لا تغيب محاولات إقصاء الكورد عن مشهد المستقبل السوري عن طاولة المفاوضات. تُطرح دساتير وتفاهمات لا تتضمن أي ذكر صريح للهوية الكوردية، وكأن وجودهم تفصيل هامشي في سردية الوطن السوري. هذه الرؤية، التي تسعى لطمس التنوع السوري تحت عباءة الوحدة الزائفة، تعيد إنتاج منطق الدولة القومية المركزية الذي دفع سوريا إلى ما هي عليه اليوم.
محو بلادٍ بجرة قلم، هنا، ليس مجازاً أدبياً، بل ممارسة سياسية خطيرة. إنه تقويض متعمد لذاكرة شعبٍ كامل، ومحوٌ للغة وثقافة وهوية ساهمت في بناء فسيفساء سوريا.
لم يكن تهديد الكيان الكوردي في سوريا نابعاً فقط من القوة العسكرية أو ضغوط الميدان، بل من سلاحٍ أكثر خبثاً وعمقاً: سلاح النصوص القانونية، والخرائط السياسية، والبيانات الرسمية، والحوارات الوطنية التي تُبنى كلماتها بعناية فائقة كي تتجاهل، أو تمسح، أو "تُحيّد" مكوّناً بأكمله من الجغرافيا السياسية والإنسانية السورية. إن محو الكورد من المشهد الوطني لا يتم دائماً عبر القصف أو الحصار، بل – وهو الأخطر – من خلال الحذف المتعمد من السرديات الكبرى، ومن النصوص التأسيسية للدولة المقبلة.
1. تغييب مقصود في الوثائق والدساتير:
في كل مرة يُطرح فيها مشروع دستور جديد لسوريا، سواء من قبل المعارضة أو النظام البائد أو السلطة الجديدة أو حتى الجهات الدولية، يتكرر نفس النمط: تعريف سوريا بأنها "دولة عربية"، وشعبها بأنه "جزء من الأمة العربية"، دون أي ذكر للقومية الكوردية أو للغات والثقافات الأخرى التي تشكل بنية المجتمع السوري. وهذا الإقصاء لا ينم عن سهو، بل عن إيديولوجيا متجذرة في بنية العقل السياسي السوري الرسمي والمعارض على حد سواء، تعتبر الكورد إما "ضيوفاً" أو "أقليات" يجب أن تذوب في الأغلبية، لا أن تُعترف بخصوصيتهم.
2. جغرافيا محو الأسماء... وإعادة رسم التاريخ:
منذ بدايات الحكم البعثي، بدأت حملة تعريب ممنهجة طالت الأسماء الكوردية للمدن والقرى والجبال والأنهار، وحُلّت محلها أسماء عربية أو بعثية الهوى. فـ"كوباني" أصبحت "عين العرب"، و"قامشلو" أصبحت "القامشلي"، وتمّت محاولة استبدال التاريخ المحلي لتلك المناطق بسرديات قومية مركزية تربط كل شيء بـ"تاريخ الدولة السورية" الذي يبدأ وينتهي عند دمشق.
اليوم، تعود هذه المحاولات بأشكال أكثر حداثة، ولكنها لا تقل خطورة: خرائط تُرسم بدون تسمية المناطق الكوردية، أو تُقسّم بطريقة تُضعف ترابطها الجغرافي، و"مشاريع لا مركزية" تفصل بين الأقاليم الكوردية وتربط كل منها بمركز عربي، فتبدو روجآفا كأرخبيل معزول، لا كجسم سياسي له ترابط جغرافي وديمغرافي وتاريخي.
3. القلم أداة حرب: الإعلام واللغة:
في الخطاب الإعلامي الرسمي، قلّما يُستخدم مصطلح "الكورد"، وحتى حين يُستخدم، يُلحق غالباً بعبارات مثل "المدعومين من الخارج"، أو "الانفصاليين"، أو "قوات غير شرعية"، في عملية نزع للشرعية الرمزية والسياسية عن هذا المكوّن. ولا يُعترف باللغة الكوردية في وسائل الإعلام الوطنية، ولا في التعليم، ولا في الإدارة، رغم أنها اللغة الأم لملايين السوريين.
إن هذا الإنكار اللغوي هو شكل من أشكال العنف الرمزي، حيث يُمنع الشعب من النطق باسمه، ومن تسمية الأشياء بلغته، ومن التعبير عن واقعه بلسانه الخاص. واللغة هنا ليست أداة تواصل فقط، بل حاملة للذاكرة، والهوية، والتاريخ. إن حرمان الكورد من لغتهم هو محاولة لقطعهم عن جذورهم وزرعهم في تربة لا تُنتج إلا النسيان.
4. محو الذات عبر "وحدة زائفة":
لطالما استُخدمت مقولة "الوحدة الوطنية" كسلاح ضد التعددية. فبدلاً من أن تكون هذه الوحدة عقداً اختيارياً بين مكوّنات متساوية، جرى توظيفها كذريعة لتذويب الجميع في "هوية واحدة"، غالباً ما تكون هوية الأكثرية الثقافية والدينية. هذه الوحدة الزائفة تطمس الفوارق، وتُقصي الأصوات الهامشية، وتعيد إنتاج هيكل الدولة القومية الكلاسيكية التي فشلت في حفظ توازنات سوريا المعقدة.
5. الذاكرة الكوردية في مواجهة الإلغاء:
ورغم كل هذه المحاولات، فإن الذاكرة الجمعية الكوردية ترفض أن تُمحى. لا تزال الأغاني تُغنّى بالكوردية في الأعراس، ولا تزال الجدة تروي حكايات عن "ديرسم" و"سنجار" و"قامشلو"، ولا تزال الأمهات يسمّين أولادهن "آرين"، و"مزكين"، و"شرفان". فالهوية، حين تُحاصر، لا تختفي، بل تتحول إلى مقاومة صامتة، ثم إلى فعل سياسي علني.
لقد بات واضحاً أن محو بلاد بجرة قلم ليس مجازاً أدبياً فحسب، بل هو ممارسة سياسية مستمرة تهدف إلى إعادة صياغة الواقع السوري ليُلائم رؤية ضيقة، وإقصائية، ومتعالية. لكن ما يُنسى أن القلم نفسه، حين يُمسك به الكورد، يتحول إلى أداة تدوين للمقاومة، لا للمحو. فالكتب، والأرشيف، والشعر، والتاريخ الشفهي، كلّها أدوات مضادة للنسيان، وتُعيد رسم الجغرافيا لا بالحبر فقط، بل بالدم أحياناً.
سابعاً: مستقبل الكورد في سوريا بين المشاريع المتنافسة:
مع دخول سوريا مرحلة ما بعد الحرب، تتقاطع على الجغرافيا الكوردية ثلاثة مشاريع كبرى، تختلف في أيديولوجياتها، وتتناقض في رؤاها لمستقبل الدولة السورية، وتمارس ضغطاً مباشراً على الوجود الكوردي، سياسياً وثقافياً وجغرافياً. الكورد، الذين صمدوا في وجه محاولات الإنكار لعقود، يجدون أنفسهم اليوم أمام معضلة وجودية: كيف يحافظون على مكتسباتهم في ظل صراع مشاريع أكبر منهم، دون أن يكونوا مجرد أداة أو ورقة تفاوض؟
1. المشروع الإسلامي ـ القومي: حكومة الجولاني مثالاً:
تُقدّم حكومة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، التي تبلورت في دمشق بعد انهيار النظام البعثي تحت الضغط الداخلي والخارجي، نموذجاً لدولة "سُنّية محافظة" ذات طابع إسلامي ـ قومي. ورغم شعارها العريض "سوريا للسوريين"، إلا أن خطابها الثقافي والسياسي يميل إلى المركزية الدينية، ويخلو من الإشارات الصريحة إلى التعدد القومي، باستثناء وعود غامضة بـ"الإدماج والمصالحة".
هذا المشروع – وإن تظاهر بالمرونة – لا يزال يُنظر إليه بريبة من قبل الكورد، لأنه يعيد إنتاج هيمنة المركز، وإنْ بزيّ جديد. وهو لا يعترف صراحة بالإدارة الذاتية، ويشترط دمج "قسد" في جيش وطني موحّد تحت سلطة مركزية. بالنسبة للكورد، فإن مثل هذا النموذج يعني العودة إلى الدولة الأمنية، حتى وإن تغيرت أسماء الحكّام.
2. المشروع التركي: احتلال بغطاء أمني:
تعمل تركيا على فرض "منطقة آمنة" في الشمال السوري تمتد من عفرين إلى رأس العين، وهي في جوهرها مشروع لتغيير التركيبة السكانية عبر التهجير والتوطين المنظم. وترى أن الإدارة الذاتية تمثل "خطراً قوميّاً" مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني، وتسعى إلى تحطيمها سياسياً وعسكرياً.
المشروع التركي لا يعترف بالهوية الكوردية في سوريا، بل يعتبرها امتداداً لمشكلته الداخلية. وهو يستخدم الفصائل السورية الموالية له كأدوات ضغط، ويمنع أي توافق وطني حقيقي يضم الكورد، مما يجعل موقفه العقائدي من "الفيدرالية" أو "اللا مركزية" رافضاً بشكل مطلق.
3. المشروع الأمريكي ـ الأوروبي: التثبيت المؤقت:
في المقابل، يتبنى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موقفاً أكثر براغماتية، إذ يرى في "قسد" حليفاً موثوقاً في الحرب ضد الإرهاب، ويدعم تجربة الإدارة الذاتية ضمن حدود جغرافية محددة. إلا أن هذا الدعم يظل هشّاً وغير مؤسَّس على التزام استراتيجي طويل الأمد.
الكورد يدركون أن الحماية الغربية مشروطة بمصالح تتغير بتغير الإدارات في واشنطن أو باريس. لذلك فهم يعيشون في مساحة رمادية: لا هم مقبولون بالكامل في المعادلة السورية، ولا مضمون لهم دعم دائم من الخارج.
4. بين الواقعية والطموح: سيناريوهات المستقبل:
أمام هذا التزاحم في المشاريع، يمكن رسم عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الكورد في سوريا:
• الدمج القسري: يتم فيه حل "قسد" وتفكيك الإدارة الذاتية ضمن دولة مركزية جديدة تحت سلطة حكومة الجولاني أو أي بديل قادم، مع وعود فضفاضة بالتمثيل، دون ضمانات دستورية. هذا السيناريو يُضعف المكاسب الكوردية وقد يعيد الأزمة إلى المربع الأول.
• الفيدرالية الفعلية: تُقر فيها سوريا بنظام لا مركزي حقيقي، يمنح للكورد إدارة ذاتية معترف بها دستورياً، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. هذا هو السيناريو الذي تطالب به غالبية القوى الكوردية.
• الكونفيدرالية المؤجلة: نموذج مرن تُحافظ فيه "روجآفا" على استقلالية إدارية واسعة، دون اعتراف رسمي في البداية، إلى أن تنضج ظروف التفاوض الدستوري. ويشبه هذا النموذج تجربة إقليم كوردستان العراق في تسعينيات القرن العشرين.
• التفكك والانكماش: وهو السيناريو الأسوأ، حيث تنهار الإدارة الذاتية تحت ضغط داخلي وخارجي، وتتوزع مناطقها بين قوى متنازعة (تركيا، حكومة دمشق، الفصائل الموالية)، ويعود الكورد إلى وضع أكثر هشاشة من ذي قبل.
5. شروط النجاة السياسية:
لكي لا يكون المستقبل الكوردي مرهوناً بأهواء اللاعبين الدوليين، يجب على القوى الكوردية أن:
• توحّد خطابها السياسي وتبني مرجعية جامعة تتحدث باسم جميع كورد سوريا.
• تنفتح على باقي المكونات السورية وتتجاوز خطاب "الهوية الدفاعية" لصالح مشروع وطني جامع.
• تستثمر في التمثيل الدبلوماسي، وأن تعزز وجودها في مفاوضات الحل النهائي كمكوّن لا يمكن تجاوزه.
ثامناً: المقارنة مع التجربة الكوردية في العراق: الدروس والمخاطر
قد يرى البعض أن التجربة الكوردية في العراق تمثل النموذج المرجو، حيث يحظى إقليم كوردستان بحكم ذاتي معترف به، وبرلمان خاص، ولغة رسمية، وعلاقات دولية محدودة. ولكن هذا النموذج لم يأتِ بسهولة، بل عبر:
1- سنوات طويلة من المقاومة المسلحة.
2- دعم دولي مباشر، خاصة بعد عام 1991.
3- فراغ سياسي حقيقي في المركز (بغداد).
حين نبحث في سيناريوهات المستقبل الكوردي في سوريا، تبرز التجربة الكوردية في العراق بوصفها النموذج الأقرب من حيث السياق الجغرافي، والمكون الثقافي، والتاريخ السياسي للمقاومة. لكنها أيضاً تجربة مركّبة، توازن بين الإنجاز والانكسار، وبين الحكم الذاتي والاعتماد على الخارج، وبين الوحدة الداخلية والانقسام الحزبي.
1. النموذج العراقي: مكاسب الحكم الذاتي وقيوده:
تأسس إقليم كوردستان العراق فعلياً بعد انتفاضة عام 1991، حين أدّت منطقة الحظر الجوي التي فرضها التحالف الدولي إلى خلق مساحة من الاستقلال الجغرافي والسياسي عن سلطة بغداد. هذا الاستقلال الجزئي تحوّل، تدريجياً، إلى واقع دستوري معترف به بعد عام 2005، حين تم تثبيت وضع الإقليم في الدستور العراقي، بما يشمل:
• برلمان محلي منتخب.
• حكومة تنفيذية تتمتع بسلطات واسعة.
• قوى أمنية محلية (البيشمركة).
• لغة رسمية كوردية إلى جانب العربية.
• سياسات تعليمية وثقافية واقتصادية مستقلة نسبياً.
كل هذه المكاسب لم تكن ثمرة تفاوض سلمي فحسب، بل جاءت نتيجة عقود من المقاومة المسلحة بقيادة أحزاب كوردية، ودعم دولي مباشر، خصوصاً من الولايات المتحدة، وفراغ سياسي كبير في المركز العراقي نتيجة انهيار الدولة بعد الغزو الأمريكي عام 2003.
2. دروس مهمة للتجربة السورية: ما الذي يمكن تعلمه؟
رغم اختلاف السياقين، فإن هناك نقاطاً يمكن أن تستفيد منها القوى الكوردية السورية في مقاربتها لمستقبل الحكم الذاتي، أبرزها:
أ- أهمية التفاوض لا الصدام: رغم أن كورد العراق خاضوا مواجهات دموية مع بغداد، إلا أن تثبيت الحكم الذاتي أتى عبر المسار الدستوري لاحقاً. وهذا يعني أن التفاوض، ولو كان طويل الأمد، قد يُفضي إلى نتائج أكثر رسوخاً من المواجهة المسلحة الدائمة.
ب- بناء مؤسسات قوية قبل المطالبة بالاستقلال: أنشأ الكورد في العراق مؤسسات حقيقية (برلمان، قضاء، إعلام، تعليم...) جعلت الحكم الذاتي قابلاً للحياة، لا مجرد شعار سياسي. وهذا درس محوري لتجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا: لا معنى للحكم الذاتي ما لم تكن هناك مؤسسات تستحق الثقة وتحاكي الدولة الحديثة.
ج- العلاقة مع المجتمع الدولي: استفاد كورد العراق من الدعم الغربي في لحظات حاسمة، وهو ما افتقدته جزئياً قسد في اللحظات المفصلية بعد هزيمة داعش، حين بدا أن القوى الدولية الكبرى لا تريد الاعتراف بمشروعها السياسي كاملاً. التحالفات الدولية، رغم هشاشتها، لا تزال عنصراً جوهرياً في صعود أي كيان جديد.
3. تحديات التجربة العراقية: الإنذارات المبكرة:
لكن التجربة الكوردية في العراق ليست مثالية، وهي تواجه اليوم تحديات تهدد بنيتها من الداخل أكثر مما تفعل الضغوط من بغداد:
أ- الفساد السياسي والإداري: رغم وجود مؤسسات، فإن ضعف الشفافية، وتغول بعض العائلات السياسية، وسيطرة الأحزاب على الموارد، أدى إلى تآكل الثقة الشعبية داخل الإقليم، خصوصاً في المناطق الفقيرة والمهملة.
ب- الانقسام الحزبي: الصراع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني (PDK) والاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK) أدى إلى ازدواجية في السلطة وتكرار النزاعات المسلحة الداخلية، خصوصاً في مناطق مثل السليمانية وكركوك، ما يهدد استقرار الإقليم في أي لحظة.
ج- النزاع مع بغداد: رغم الاعتراف الدستوري، فإن بغداد تسعى باستمرار إلى تقليص صلاحيات الإقليم، خاصة في ملفي النفط والميزانية. وهذا يظهر أن الاعتراف القانوني لا يكفي، إذا لم يُدعَم بتوازن حقيقي في القوة والنفوذ.
4. المخاطر عند النسخ الآلي للتجربة:
إذا حاولت القوى الكوردية في سوريا "استنساخ" النموذج العراقي دون الانتباه للاختلافات، فإن ذلك قد يؤدي إلى كوارث استراتيجية. سوريا، بعكس العراق:
• لم تمر بعد بمسار دستوري واضح لما بعد الحرب.
• لا يوجد دعم دولي صريح لفيدرالية كوردية، كما حصل مع كورد العراق.
• الانقسام المجتمعي والسياسي أكثر حدة، خاصة مع وجود تيارات إسلامية معادية للفكرة الكوردية تماماً.
• الخريطة الديمغرافية الكوردية أقل تجانساً جغرافياً من نظيرتها العراقية، ما يجعل مشروع الحكم الذاتي أكثر تعقيداً.
5. خلاصة المقارنة: وعي بالاختلاف لا تكرار أعمى:
يمكن القول إن النموذج العراقي هو مرآة تُظهر ما يمكن أن يحدث إذا تم الاعتراف بالحقوق، ولكن أيضاً ما قد يحدث إذا فشل الداخل الكوردي في إدارة هذا الاعتراف. وعلى القوى الكوردية السورية أن:
• تستفيد من تجربة بناء المؤسسات.
• تتفادى الانقسامات الحزبية التي أضعفت تجربة الإقليم.
• تُبقي سقف الطموحات واقعياً ومرناً.
• تُبني مشروعاً يراعي الواقع السوري المعقد، ويُبنى بالشراكة مع باقي المكونات.
تاسعاً: ما مستقبل الكورد في سوريا؟ سؤال الهوية، والمكان، والحق في البقاء
السؤال الذي يطفو فوق رماد الحرب السورية، ويتردد في أروقة السياسة الإقليمية والدولية، ليس مجرد استفسار جغرافي أو قانوني، بل سؤال وجودي: هل للكورد مكانٌ في سوريا الجديدة؟
وما نوع هذا المكان؟ هل هو حيز ثقافي هشّ تُداس فيه اللغة والذاكرة؟ أم هو كيان سياسي مرن، ينجو من العاصفة بصيغة وسطى؟ أم أنه، كما يحلم به البعض، جزء أصيل من دولة متعددة القوميات والهويات؟
1. الكورد بين التجربة والتاريخ: من الإنكار إلى التمثيل:
على مدار قرنٍ من التكوين القسري للدولة السورية، لم يُعترف بالكورد لا في اللغة، ولا في المناهج، ولا في التكوين السياسي للدولة. كانوا دوماً موجودين جسدياً، وغائبين رمزياً، يتكلمون الكوردية في بيوتهم ويُدرّسون أبناءهم بالعربية، يُحيون النوروز في الخفاء ويُطالبون بالاعتراف علناً، ويُعدّون في إحصاء 1962 مجرد "أجانب مقيمين" في وطنهم.
ولكن بعد الثورة السورية عام 2011، ولأول مرة، خرج الكورد من هامش الخطاب إلى مركز الحدث، من مجرد ضحايا تهميش إلى فاعلين سياسيين وعسكريين يملكون مشروعاً خاصاً، هو الإدارة الذاتية الديمقراطية. هذا الانتقال الجذري ليس مجرد إنجاز سياسي، بل هو منعطف تاريخي يطرح تحدياً جوهرياً: كيف يضمن الكورد استمرار وجودهم الفاعل في دولة لا تزال تتهرب من الاعتراف بتعددها؟
2. ثلاث سيناريوهات: بين الذوبان، والهشاشة، والاعتراف:
أ- سيناريو "الذوبان القسري": إذا فرضت حكومة الجولاني سلطتها الكاملة:
في حال تمكنت حكومة أحمد الشرع (الجولاني)، بوصفها نسخة جديدة من الدولة المركزية ذات المرجعية الدينية القومية، من فرض سيطرتها الشاملة على الجغرافيا السورية، فستُجبر الإدارة الذاتية على الانخراط ضمن بنية سلطوية تُعيد إنتاج القمع بلغة دينية هذه المرة.
في هذا السيناريو، لا يُلغى الكورد، بل يُعاد تشكيلهم وفق "وحدة إسلامية" تُخفي التنوع باسم "الأمة الواحدة". ستواجه اللغة الكوردية خطر التهميش من جديد، وسيفقد الكورد أدواتهم في الحكم المحلي، ليُصبحوا جزءاً من "دولة متدينة" لا تعترف بالمدنية، ولا بالتعدد، ولا بالحق في الاختلاف.
ب- سيناريو "الهشاشة التوافقية": استمرار اللامركزية الجغرافية:
أما إذا استمرت حالة التوزع الجغرافي القائم اليوم، بحيث تبقى "الإدارة الذاتية" تحكم مناطقها دون اعتراف رسمي، فسنكون أمام نموذج كيان سياسي غير مكتمل، يعيش على التوازنات الدولية أكثر من الشرعية الوطنية.
في هذا السيناريو، تبقى مناطق الإدارة الذاتية عرضة للتجاذبات بين:
• القوى الدولية (الولايات المتحدة كداعم، وروسيا كوسيط، وتركيا كتهديد دائم)،
• والقوى الداخلية (العشائر، المجالس المدنية، قوى المعارضة).
سيظل الكيان الكوردي موجوداً، لكنه هش، يشبه "جمهورية الظل" التي تملك مؤسسات وخططاً وتطلعات، لكنها بلا غطاء دستوري أو اعتراف سيادي. الكورد هنا مثل من يسكنون بيتاً فوق فوهة بركان سياسي، لا يعلمون متى ينفجر.
ج- سيناريو "الدولة التعددية": إذا تحقق حلم الدستور الديمقراطي:
هذا هو السيناريو الأكثر نُبلاً، لكنه الأقل احتمالاً في اللحظة الراهنة. دولة جديدة، لا مركزية، تعترف بالكورد كمكون أساسي، وتقر بلغتهم، وتضمن لهم الحكم الذاتي ضمن إطار وطني، وتتجاوز ثنائية "الوحدة أو الانفصال".
في هذا النموذج، يصبح الكورد شركاء لا أطرافاً هامشية، ويتم تضمينهم في البرلمان والدستور والاقتصاد، لا كديكور ديمقراطي بل كحق تاريخي. وهو سيناريو يتطلب توافقاً وطنياً عميقاً، وإعادة تعريف لمفهوم "سوريا"، لا بوصفها دولة عربية فقط، بل بوصفها فضاء مشتركاً لقوميات متعددة، لكل منها حق البقاء والتمثيل.
3. العوامل المحدِّدة للمستقبل: بين الداخل والخارج:
مصير الكورد في سوريا لن يتحدد فقط بيد الكورد أنفسهم، بل بتشابك أربعة عوامل رئيسية:
• التحولات الإقليمية: مدى توافق تركيا وإيران والعراق على التعامل مع الملف الكوردي السوري.
• الدور الأمريكي والروسي: هل ستبقى واشنطن حاميةً "للفدرالية الواقعية"، أم ستنسحب تحت ضغط التفاهمات؟
• وضع المعارضة والسلطة الجديدة: هل سيتجه الطرفان نحو مركزية الدولة أم نحو نظام تشاركي تعددي؟
• الوعي الكوردي الذاتي: مدى قدرة الكورد على تجاوز الانقسامات الحزبية، وتشكيل خطاب موحد يجمع بين المدني والعسكري، بين المحلي والعالمي.
4. الكورد وسوريا المستقبل: من الهامش إلى المركز:
لن يكون للكورد مستقبلٌ مضمون في سوريا ما لم يتغير تصور الدولة نفسها، من "دولة قومية مغلقة" إلى "دولة متعددة القوميات والثقافات". لن يكفي أن يُقال إن "سوريا لكل السوريين"، ما لم يُقرّ في الدستور أن للكورد خصوصيتهم اللغوية والثقافية والسياسية، وأن هذه الخصوصية ليست تهديداً لوحدة الدولة، بل ضماناً لبقائها.
الكورد لا يطالبون بدولة قومية جديدة، بل بحقهم في أن يكونوا أنفسهم ضمن دولة تتسع للجميع. وهذا الحق ليس منّة من أحد، بل ضرورة إنسانية وسياسية وأخلاقية.
عاشراً: الدور الدولي في رسم مصير الكورد: بين الورقة التفاوضية والرهان المعلق
لا يمكن الحديث عن مستقبل الكورد في سوريا دون التطرق إلى الأيادي الثقيلة التي ترسم خريطة المصير السوري من الخارج. فالقضية الكوردية لم تعد شأناً داخلياً فحسب، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط وتفاوض بيد القوى الدولية الكبرى. لكن هذه الورقة تُستخدم غالباً لا لتمكين الكورد، بل كوسيلة لابتزاز الأطراف الأخرى وتحقيق مكاسب استراتيجية.
1. الولايات المتحدة: دعم مشروط بلا ضمانات:
منذ تدخلها في سوريا ضمن إطار "التحالف الدولي ضد داعش"، وجدت الولايات المتحدة في "قوات سوريا الديمقراطية" شريكاً ميدانياً فعّالاً. ووفرت واشنطن دعماً عسكرياً ولوجستياً كبيراً، لكنها امتنعت عن تقديم أي اعتراف سياسي بالإدارة الذاتية.
تحافظ واشنطن على علاقتها مع قسد كورقة تفاوض ضد النظام السابق والسلطة الجديدة وروسيا وإيران، لكنها في الوقت نفسه تحاول طمأنة تركيا بأنها لا تدعم "الانفصال الكوردي". هذه الازدواجية تترك الكورد في موقع هش: شركاء مؤقتون في معركة، لا حلفاء دائمون في السياسة.
2. روسيا: المقايضة الدائمة:
لعبت روسيا دور "العرّاب" في المفاوضات بين دمشق سابقاً والإدارة الذاتية. وهي دفعت الكورد نحو تسليم مناطقهم للنظام البعثي مقابل وعود ضبابية بالحكم الذاتي أو اللامركزية، دون أي التزام مكتوب أو جدول زمني واضح.
لكن الآن بعد الانسحاب من المشهد السوري ظاهرياً وهي تعمل سراً مع وأمريكا لمقايضة الكورد في سوريا بأوكرانيا ..
ترى موسكو في الكورد ورقة ضغط على تركيا، لكنها مستعدة للتخلي عنهم متى ما اقتضت صفقة أكبر مع أنقرة أو دمشق. ولذلك، فإن روسيا ليست حليفاً موثوقاً بقدر ما هي سمسار سياسي يُوازن بين الجميع.
3. تركيا: العدو الدائم للمشروع الكوردي:
تركيا تنظر إلى أي كيان كوردي في سوريا بوصفه تهديداً وجودياً، وتربطه مباشرة بحزب العمال الكردستاني. لهذا، شنت أنقرة عدة عمليات عسكرية لقطع الطريق أمام التواصل الجغرافي الكوردي، واحتلت مدناً كعفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض.
الموقف التركي واضح وصريح: لا كيان كوردي في سوريا، لا حكم ذاتي، ولا لغة كوردية في المدارس الرسمية. ومهما تعددت الحكومات في دمشق، فإن تركيا ستظل تصارع أي مشروع كوردي كما لو أنه جبهة داخل حدودها.
4. أوروبا: التعاطف بلا أدوات ضغط:
تعاطفت بعض الدول الأوروبية مع مظلومية الكورد، خاصة بعد المعركة ضد داعش، لكن هذا التعاطف ظل معنوياً وإعلامياً. لم تسعَ أي دولة أوروبية إلى تقديم مبادرة سياسية فعلية لحل الملف الكوردي في سوريا، بل اكتفت بالمراقبة والتصريحات.
في نهاية المطاف، لا تمتلك أوروبا أدوات ضغط فعلية في الملف السوري، مما يجعل حضورها رمزياً أكثر من كونه فاعلاً.
في الختام، الملف الكوردي في سوريا ليس مجرد تفصيل قومي في خريطة الحرب، بل هو عقدة مركزية في فهم مستقبل الدولة السورية. ما بين سلطة أمر واقع في دمشق، وتجربة سياسية في الشمال الشرقي، وضغوط دولية متشابكة، يظل مصير الكورد مرهوناً بتوازنات دقيقة.
لكن السؤال المصيري الذي لا مفر منه:
هل تُكتب دساتير الدول لأجل إعادة إنتاج السلطة... أم من أجل الاعتراف بالإنسان؟
الخاتمة:
الكورد في سوريا ليسوا أقلية تبحث عن شفقة، بل شعب يسعى إلى الاعتراف والمساواة في وطن شارك في بنائه ودفع ثمناً باهظاً لأجل حريته. أما الاتفاقات المؤقتة والمناورات السياسية، فلن تكون بديلاً عن رؤية وطنية حقيقية تُعيد تعريف سوريا بوصفها وطناً لكل مكوناتها، لا مشروعاً لفئة على حساب أخرى.
الكورد في سوريا لم يكونوا يوماً مجرد رقم في إحصاءات غير عادلة، ولا "أقلية" بالمعنى الفقهي الذي يُلحقهم بفئات تحتاج إلى حماية خاصة، ولا "ملفاً" على طاولة مفاوضات تُغلق وتُفتح حسب المصالح العابرة. إنهم شعبٌ متجذّر في التاريخ، وممتدٌ في الجغرافيا، وفاعلٌ في صناعة الحاضر، وطامحٌ بكرامة إلى أن يكون جزءاً أصيلاً من المستقبل.
لسنا هنا أمام قضية حقوق إنسان فقط، ولا حتى قضية تمثيل سياسي. نحن إزاء معركة رمزية كبرى حول هوية الوطن السوري نفسه: هل هو وطن لفئة واحدة، لغة واحدة، ومركز واحد؟ أم هو كيان مفتوح على فسيفساء الشعوب، يُكتب بلغات أبنائه وتتنفس مؤسساته من تنوعه لا من وحدته القسرية؟
إن نضال الكورد السوريين، منذ بداية تأسيس الدولة السورية إلى انتفاضة 2004 في قامشلو، إلى ساحات الثورة في قامشلو وكوباني وعفرين إلى قلب زور آفا في العاصمة دمشق ، إلى تجربة الإدارة الذاتية، ليس نضالاً انفصالياً كما تروّج له بعض الجهات، بل نضال من أجل البقاء داخل الوطن... ولكن بكرامة.
كل الاتفاقات الجزئية، كل المناورات السياسية، كل "الحلول الوسط" التي لا تعترف صراحة باللغة الكوردية، بالهوية الكوردية، وبالحق في التمثيل، ليست سوى تأجيل للصراع لا حله. فمحو بلاد بجرة قلم، كما قيل، ليس استعارةً شاعرية، بل خطر وجودي على شعبٍ ما زال يقاوم كي لا يُختزل في الهامش.
وإذا كانت النخب السياسية الجديدة في دمشق — أياً كان شكلها أو مرجعيتها — تنوي إعادة بناء الدولة السورية، فعليها أن تبدأ من إعادة تعريف "الوطن" ذاته: لا بوصفه مساحة يفرض فيها المنتصر ثقافته على الجميع، بل بوصفه عقداً اجتماعياً جديداً يعترف بالآخر لا كخصم بل كشريك.
إن تجربة الكورد في سوريا هي أيضاً اختبار للمجتمع السوري كله: هل يستطيع أن يتحول من كيان ما بعد استعماري انهار على نفسه، إلى وطن تعددي ديمقراطي يعترف بأن الهويات لا تُلغى باسم الوحدة، بل تُصان وتُصقل بالتعايش؟
وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن نكتب دستوراً لسوريا جديدة دون أن نتعلم أولاً أن الوطن لا يُبنى إلا بلغاته كلها، بأحلامه كلها، وبشعوبه التي لم تطلب يوماً أكثر من أن تكون مرئية، وأن تُحكى قصتها في العلن، لا في الظل.
فالسؤال الأهم الذي يجب أن يُطرح على طاولة كل مفاوض، وعلى ضمير كل مَن يتحدث باسم سوريا الغد، ليس سؤال التقسيم أو المركزية أو شكل الحكم، بل سؤال الوجود:
هل تريدون وطناً حقيقياً، أم مجرد خريطة بلا ناس، بلا ذاكرة، بلا كورد؟
13 نيسان 2025